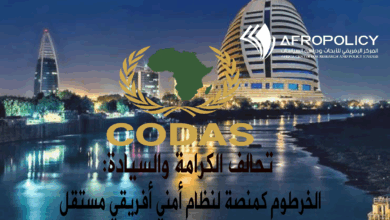المستخلص:
تستكشف هذه المقالة “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT)، وهي إطار تحليلي متكامل ومبتكر، تم تطويره لتوفير فهم أعمق للنزاعات المسلحة التي تتسم بها مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ترتكز هذه النظرية على فحص نقدي للنظريات السائدة في العلاقات الدولية، وتقدم آليات سببية مترابطة تشرح بدء الصراعات المعاصرة، واستمرارها، وانتشارها. تؤكد الدراسة على ضرورة هذه النظرية لتحليل التعقيدات المتزايدة للحروب اليوم، مثل ضعف الدولة، وعولمة النزاعات، وتدهور السيادة، ودور الفاعلين غير الحكوميين المركزي، والاستراتيجيات الهجينة، واقتصادات الحرب العابرة للحدود. توضح المقالة أن NIWT تقدم منظورًا تحليليًا قويًا، مدعومًا باختبارات تجريبية صارمة من خلال دراسات حالة مفصلة (سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، أوكرانيا)، مما يؤكد صحتها وقدرتها على التنبؤ. تهدف هذه الورقة إلى إبراز هذه المساهمة المعرفية الفريدة، التي نشأت من السياق الافريقي والعربي، وتحديداً من السودان، بهدف تحفيز المزيد من البحث والحوار حول التحديات الأمنية الراهنة وتطوير استراتيجيات سلام أكثر فعالية.
الكلمات المفتاحية: الحروب الدولية الجديدة ، نظرية الصراع ، ضعف الدولة ، العولمة ، الفاعلون من غير الدول ، الحرب الهجينة ، اقتصاديات الحرب ، السيادة ، الحروب بالوكالة ، السودان.
1.مقدمة
تحولات الصراع العالمي وضرورة ظهور نظرية جديدة
نُعلن اليوم عن ظهور رؤية تحولية هي “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT). هذه النظرية هي ثمرة تأمل عميق وتفكير نقدي جذري انطلق من واقع الصراعات المشتعلة. ليست هذه مجرد إضافة أكاديمية هامشية، بل هي صرخة معرفية تنبع من الألم والتحدي. إنها تقدم إطارًا نظريًا واسعًا يُعيد تشكيل فهمنا لطبيعة الحروب المعاصرة ويزودنا بأدوات تحليلية ذات فاعلية وإلحاح استراتيجي غير مسبوق.
لطالما هيمنت الأطر التفسيرية الغربية على تحليل صراعاتنا العربية والأفريقية. وعلى الرغم من قيمتها الجوهرية، إلا أنها غالبًا ما قصرت عن فهم التشابكات العضوية والتداخلات السائلة والخصوصيات البنيوية التي تميز حروبنا الراهنة. من هنا، من قلب السودان الذي يُعاني اليوم من أعتى تجليات هذه الحروب وأكثرها فتكًا ، تنبع القوة الأصيلة لهذه النظرية. إنها رؤية اختُبرت على أرض الواقع الأليم، وصُممت لتفكيك الظواهر التي عجزت النظريات السائدة، بصرامتها القديمة، عن تفسيرها بشكل كامل أو مقنع.
لماذا تُعد “نظرية الحروب الدولية الجديدة” ضرورة حتمية ومستقبلية؟ لقد تجاوز عالمنا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وخاصة حقبة الألفية الثالثة، النماذج الكلاسيكية للصراع التي ترسخت في الأذهان لعقود. لم تعد الجيوش النظامية هي الفاعل الوحيد، بل أصبحت جزءًا من نسيج معقد. كما أن ساحات المعارك لم تعد محددة بخطوط جغرافية ثابتة، بل امتدت لتشمل الفضاء السيبراني والاقتصادات الخفية والعقول نفسها. نحن أمام تحول نوعي وجذري، بل ثورة في طبيعة الحرب، تتطلب تحولًا نظريًا وجوديًا في فهمها.
إن الأطر التفسيرية التقليدية، مثل الواقعية التي أفرطت في حصر الصراع في صراع القوى بين الدول العظمى (مورغنثاو، 1964؛ والتز، 1979) ، والليبرالية التي بالغت في تفاؤلها بقدرة العولمة والمؤسسات على إحلال السلام (كيوهين وناي، 1977) ، وحتى البنائية في تركيزها على الأفكار دون إعطاء وزن كافٍ للعوامل المادية القاسية (كون، 1992؛ فينمور، 1996) ، أصبحت قاصرة بشكل صارخ ومُحبط عن استيعاب هذا الواقع المتشابك. حتى المحاولات الحديثة، مثل نظرية “الحروب الجديدة” لماري كالدور، ورغم ريادتها في الإشارة إلى بعض الخصائص المتغيرة (كالدور، 2003) ، لم تتمكن من تقديم إطار متكامل يشرح التفاعلات العميقة بين ضعف الدولة البنيوي، والتدخلات الدولية اللامحدودة، واقتصاديات الحرب العابرة للحدود التي لا تعترف بقانون، ودور الفاعلين المتعددين ذوي الأجندات المتضاربة في سياق مترابط وسببي لا ينفصم (مامفورد، 2013).
من هنا، تبرز الحاجة المُلحة، بل الوجودية، لـ NIWT. إنها نظرية لا تكتفي بالتحليل، بل تطمح إلى صياغة رؤية مستقبلية. هذه النظرية تُطوّر في سلسلة شاملة وموسوعية من أربعة كتب تحمل عنوانًا جامعًا: “فهم عالم الحروب المعاصرة: سلسلة الحروب الدولية الجديدة”. هذا الجهد البحثي ليس مجرد سرد، بل هو بناء معماري تحليلي متكامل يربط بين هذه الأبعاد المتشابكة، موفرًا تفسيرًا سببيًا عميقًا وديناميكيًا لنشأة هذه الحروب، واستدامتها التي لا تنتهي، وتمددها الذي يُهدد استقرار العالم. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة مكثفة عن جوهر NIWT ومساهمتها العلمية، تمهيدًا للنشر القريب للسلسلة.
2. الإطار النظري: “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) – بناء متكامل لتفسير الصراع
تُقدم “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) إطارًا نظريًا شاملًا ومتعدد المستويات يُفسر الصراعات المسلحة المعاصرة التي نشأت وتطورت في عصر ما بعد الحرب الباردة. إنها ليست مجرد تعديل أو إضافة لنظرية قائمة، بل بناء نظري متماسك، قائم على مجموعة من الافتراضات والمفاهيم والآليات السببية التي تختلف جوهريًا عن نظريات الحرب التقليدية، وتُقدم تفسيرًا يتجاوز ما هو معروف.
2.1. الافتراضات الأساسية لـ NIWT: دعائم البناء النظري
تعتمد NIWT على أربعة افتراضات محورية تُعيد صياغة فهمنا لطبيعة الدولة والنظام الدولي، وتُشكل أساسًا لتمييزها عن الأطر السابقة:
- ضعف الدولة هو نقطة البدء، لا مجرد ظرف عابر: خلافًا للواقعية التي تفترض وجود دول قوية وعقلانية كوحدات فاعلة تتصارع على السلطة في نظام فوضوي (والتز، 1979) ، تفترض NIWT أن العديد من الصراعات المعاصرة تنشأ وتزدهر في سياق “ضعف الدولة” أو “فشل الدولة” (state fragility/failure). هذا الضعف ليس مجرد نقص في القدرة العسكرية، بل يشمل تآكل الشرعية السياسية، وانهيار احتكار الدولة للعنف المشروع (مفهوم ويبر الكلاسيكي) (فيبر، 1919) ، وسوء الحوكمة، وتدهور الخدمات الأساسية، والعجز الاقتصادي (البنك الدولي، 2008؛ روتبرغ، 2003). هذا الضعف البنيوي يُخلق فراغًا أمنيًا وسياسيًا واسعًا، يسمح لفاعلين محليين ودوليين بملء هذا الفراغ ولعب أدوار فوق سيادية. إن الدولة الضعيفة تُصبح “سفينة تتسرب منها المياه من كل حدب وصوب”، عرضة للغرق بفعل عوامل داخلية وخارجية.
- النظام الدولي فوضوي ولكن معولم ومترابط بشكل معقد وديناميكي: بينما تتفق NIWT مع الواقعية في افتراض الفوضى (غياب سلطة مركزية عليا قادرة على فرض النظام) ، فإنها تُضيف أن هذه الفوضى تعمل في سياق نظام دولي معولم ومترابط بشكل غير مسبوق (Barnett, 2002). العولمة هنا لا تعني فقط التعاون الاقتصادي وتبادل السلع كما يراها الليبراليون (كيوهين وناي، 1977) ، بل تشمل تدفق الأفكار، والأيديولوجيات المتطرفة، والمقاتلين الأجانب، والتمويل غير المشروع، والسلاح، والمعلومات المضللة، والتكنولوجيا عبر الحدود بسهولة مذهلة. هذه الترابطية السلبية تُعد عاملًا تمكينيًا وتغذية مستمرة للصراعات، محوّلةً العولمة إلى محفز قوي للعنف.
- تآكل السيادة الوطنية كشرط لتوسع الصراع: تفترض NIWT أن مفهوم السيادة الوطنية، خاصة للدول الضعيفة، قد تعرض لتآكل كبير وخطير (Krasner, 1999). هذا التآكل لا يقتصر على التدخلات العسكرية المباشرة، بل يشمل القدرة المحدودة للدول على التحكم في حدودها (التي تُصبح مجرد خطوط على الخرائط) ، أو اقتصادها (بفعل سيطرة اقتصاديات الحرب) ، أو حتى السرديات الداخلية (بفعل الإعلام الدولي والشبكات الرقمية). هذا التآكل يُسهل التدخلات الخارجية (سواء من دول أو فاعلين من غير الدول) ويُصعب الفصل بين الصراع الداخلي والخارجي، مما يجعل السيادة، في هذا السياق، مفهومًا شكليًا أكثر منه حقيقة مادية.
- تعدد الفاعلين ومركزيتهم كديناميكية محورية: لا تقتصر الحرب على الدول كوحدات أساسية للتحليل، كما في النظريات التقليدية. تُفترض NIWT أن الفاعلين من غير الدول (Non-State Actors – NSAs) أصبحوا محوريين بشكل متزايد في إطلاق الصراعات، وتمويلها، واستدامتها، والقتال فيها (Byman & Pollack, 2001). هؤلاء الفاعلون يتراوحون بين الميليشيات المسلحة، والجماعات الإرهابية العابرة للحدود، والشركات العسكرية والأمنية الخاصة (PMSCs) التي تُعد محور الكتاب الثالث من السلسلة: “مرتزقة العصر الحديث: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعلين في الحروب الدولية الجديدة” ، إضافة إلى شبكات الجريمة المنظمة، وحتى بعض المنظمات الإنسانية التي تتأثر ديناميكيات الصراع.
2.2. المفاهيم المركزية والآليات السببية (الفرضيات الموسعة): تفسير شامل لديناميكيات NIWT
تستخدم NIWT مجموعة من المفاهيم المترابطة التي تشكل أدواتها التحليلية، وتُفسر آلياتها السببية عبر ست فرضيات موسعة، تُشكل جوهر الكتاب الثاني: “فوق الركام: بناء ‘نظرية الحروب الدولية الجديدة’ لفهم عالم الحروب المعاصرة”:
- ضعف الدولة كنقطة انطلاق للصراع (الفرضية 1): كلما زاد ضعف الدولة (من حيث الشرعية، احتكار العنف، توفير الخدمات، الحوكمة، اقتصاديًا، أمنيًا)، زادت احتمالية نشأة وتمدد الحروب الدولية الجديدة. ضعف الدولة يُخلق فراغًا أمنيًا وسياسيًا حرجًا، يفسح المجال لظهور وتمدد الفاعلين من غير الدول الذين يملأون هذا الفراغ (مثل الميليشيات العرقية أو القبلية)، أو يجذب فاعلين خارجيين (دول أو جماعات إرهابية) للتدخل. غياب احتكار العنف يدفع المواطنين للبحث عن حماية من جهات بديلة، مما يُشرعن الميليشيات. وسوء الحوكمة يؤدي إلى سخط شعبي يمكن استغلاله من قبل الفاعلين المتطرفين.
- العولمة كعامل تمكين وتغذية مستمرة للصراع (الفرضية 2): تُمكّن العولمة (بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والتكنولوجية) نشأة واستدامة وتمدد الحروب الدولية الجديدة من خلال تسهيل حركة الفاعلين، الأفكار، السلاح، والتمويل. هذا يتم عبر: عولمة الأفكار والأيديولوجيات (انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت)، عولمة التمويل (سهولة حركة الأموال غير المشروعة)، عولمة السلاح (تدفق الأسلحة عبر الأسواق السوداء)، وحركة المقاتلين الأجانب. كما أن الترابط الاقتصادي السلبي يُخلق فرصًا للفاعلين لجني الأرباح من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بشبكات عالمية، مما يُمول حربهم.
- تآكل السيادة الوطنية كشرط وجودي لتوسع الصراع (الفرضية 3): كلما زاد تآكل السيادة الوطنية للدول (خاصة الضعيفة)، زادت سهولة التدخلات الخارجية (دولية وغير دولية)، وتقلصت قدرة الدولة على احتواء الصراع، مما يؤدي إلى تدويله. ضعف الدولة يؤدي إلى غياب السيطرة الفعلية على الحدود والمجال الجوي، مما يسهل التهريب والتسلل والتدخل. كما أن ضعف شرعية الدولة يفتح الباب أمام مطالبات بالتدخل لأسباب إنسانية أو أمنية من قبل دول أخرى، مما يجعل الصراع الداخلي شأنًا دوليًا متشابكًا.
- مركزية الفاعلين من غير الدول وتفاعلهم المعقد مع الدول (الفرضية 4): يُعد صعود الفاعلين من غير الدول، وارتباطهم الشبكي المعقد بالدول والفاعلين الآخرين (دولًا وغير دول)، محركًا أساسيًا لتعقيد الحروب الدولية الجديدة واستدامتها. هؤلاء الفاعلون ليسوا مجرد وكلاء سلبيين، بل لديهم أجندات مستقلة (دينية، عرقية، اقتصادية) تُمكنهم من الاستمرار في القتال حتى لو تغيرت مصالح الدول الداعمة. قدرتهم على بناء شبكات عابرة للحدود تزيد من مرونتهم وتمويلهم. هذا المحور يُفصل بشكل شامل في الكتاب الثالث من السلسلة: “مرتزقة العصر الحديث: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعلين في الحروب الدولية الجديدة”، حيث تُحلل PMSCs كنماذج بارزة لهذا النوع من الفاعلين، وكيف يتحدون احتكار الدولة للعنف ويُغذّون الحروب بالوكالة.
- الاستراتيجيات الهجينة كنمط قتال سائد ومربك (الفرضية 5): تُعد الاستراتيجيات الهجينة هي النمط السائد للقتال في الحروب الدولية الجديدة، مما يزيد من صعوبة تحديد أطراف الصراع بشكل دقيق، وقواعد الاشتباك، وتوقعات نهاية الصراع. تسمح هذه الاستراتيجيات، التي تجمع بين الأساليب العسكرية التقليدية وغير التقليدية (حرب العصابات، الإرهاب) بالإضافة إلى أساليب غير عسكرية (الحرب السيبرانية، حرب المعلومات، الضغط الاقتصادي، الدعاية والتضليل، التدخل في الشؤون الداخلية)، للفاعلين (خاصة الأضعف) بتحقيق أهدافهم ضد خصوم أقوى دون الحاجة إلى مواجهة شاملة ومكلفة (Hoffman, 2007). هذا المحور يُقدم تحليلًا عميقًا في الكتاب الرابع من السلسلة: “الحرب على العقول: التضليل الإعلامي والسرديات الزائفة في الحروب الدولية الجديدة”، الذي يفكك حرب المعلومات كسلاح حيوي وكيف تُصبح العقول ساحة قتال حاسمة.
- اقتصاديات الحرب العابرة للحدود كعامل استدامة لا ينتهي (الفرضية 6): تُعد اقتصاديات الحرب العابرة للحدود عاملًا رئيسيًا وحاسمًا في استدامة الحروب الدولية الجديدة، وتُخلق مصالح راسخة لدى الفاعلين في استمرارية الصراع (Collier, 2000). هذه الاقتصاديات (التهريب، الابتزاز، تجارة الموارد غير المشروعة) توفر التمويل اللازم للفاعلين من غير الدول للاستمرار في القتال، وشراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين. كما أنها تخلق طبقة من المستفيدين من الصراع، الذين يطورون مصالح راسخة في استمرارية الفوضى، مما يعيق حل الصراع ويُصعب من جهود بناء السلام (Richards, 2005).
3.المنهجية البحثية واختبار النظرية التجريبي
لا تكتفي NIWT بالبناء النظري، بل تُقدم منهجية بحثية صارمة وقوية لاختبار فرضياتها، مما يُعزز من مصداقيتها العلمية وقابليتها للدحض. وقد اعتمد الباحث منهجية بحثية متعددة الأساليب (Mixed Methods Approach) تُجمع بين العمق الذي توفره الدراسات النوعية والتحليل المقارن، والاتساع الذي يمكن استخلاصه من البيانات الكمية.
3.1. التصميم البحثي: المنهجية المختلطة
شكل اختيار المنهجية المختلطة حجر الزاوية في التصميم البحثي. تتناول NIWT ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب فهمًا عميقًا من خلال الآليات السببية المتشابكة، في حين تتطلب القدرة على تحديد الأنماط العامة والتعميم إلى حد ما. هذا المنهج يسمح بالاستفادة من نقاط قوة التحليل النوعي (فهم السياقات والآليات السببية من خلال تتبع العملية) والتحليل الكمي (اختبار الفرضيات على نطاق أوسع باستخدام التحليل المقارن النوعي – QCA)، مع تعزيز الصلاحية الداخلية والخارجية والوثوقية. يُعد تتبع العملية أداة حاسمة للكشف عن “الأدلة الدفترية” و”اختبارات العروة” و”اختبارات القشة في مهب الريح” التي تربط بين المتغيرات وتؤكد الآليات السببية المقترحة (George & Bennett, 2005). أما التحليل المقارن النوعي (QCA)، فيُقدم إطارًا لتحليل عدد متوسط من الحالات لتحديد التركيبات السببية للظواهر المعقدة (Ragin, 2008).
3.2. معايير اختيار الحالات الدراسية:
لضمان اختبار شامل لـ NIWT، تم اختيار حالات دراسية تمثل بوضوح خصائص “الحروب الدولية الجديدة” وتنوعها الجغرافي والسياسي والاقتصادي، مع توفير تباين في المتغيرات لدعم التحليل المقارن.
الحالات الدراسية المختارة:
- الحرب في سوريا: تُعد نموذجًا كلاسيكيًا لانهيار الدولة المركزي، وتعدد التدخلات الدولية (حروب بالوكالة)، والصعود المتسارع لفاعلين غير دوليين متنوعين (من جماعات مسلحة كداعش إلى فصائل مسلحة متعددة)، والاستخدام المكثف للاستراتيجيات الهجينة (بما في ذلك حرب المعلومات والحصار)، وتأثير اقتصاديات حرب ضخمة (تهريب نفط وآثار).
- الحرب في ليبيا: مثال لضعف الدولة اللاحق للتدخل الخارجي الذي أدى إلى فراغ سلطوي، وصعود الميليشيات المسلحة كقوى أساسية، وتدخل قوى إقليمية ودولية متعددة لدعم أطراف مختلفة، وتأثير اقتصاديات التهريب (النفط، البشر، الأسلحة) على استدامة الصراع.
- الحرب في اليمن: تُظهر بوضوح حربًا بالوكالة معقدة جدًا، وتدهورًا هائلًا للدولة، وصعود فاعلين غير دوليين (كالحوثيين والقاعدة والمليشيات الأخرى ضد الحوثيين وإيران) يتنافسون على الشرعية والسيطرة، وتأثير الحصار والتدخلات الخارجية على الديناميكيات الداخلية واقتصاديات الصراع.
- الحرب في السودان: حالة حديثة تبرز صراعًا تفاقم بشكل مريع بسبب ضعف مؤسسات الدولة الانتقالية وانقسام الجيش وطموح مليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيًا. تُجسد هذه الحالة بوضوح كيف يُساهم ضعف الدولة في إشعال حرب داخلية سريعة التحول إلى حرب دولية جديدة بفعل التدخلات الخارجية واقتصاديات الحرب (خاصة الذهب).
- الصراع في أوكرانيا (ما بعد 2014، قبل الغزو الشامل 2022): يمثل نموذجًا مثاليًا للحرب الهجينة والحروب بالوكالة في سياق دولة قائمة ولكنها تعاني من انقسامات داخلية وضعف مؤسسي سمح باستغلالها. اتسمت هذه الفترة بالاستخدام المكثف للوكلاء (الميليشيات الانفصالية)، والحرب السيبرانية، والدعاية والتضليل، والتدخلات غير المعلنة.
3.3. مصادر جمع البيانات وأدواتها:
لتحقيق عمق وشمولية التحليل، تم الاعتماد على مجموعة متنوعة وثرية من مصادر البيانات الأولية والثانوية. شملت هذه المصادر: تقارير الأمم المتحدة (مجلس الأمن، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، وتقارير المنظمات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي)، وتقارير الحكومات الوطنية ذات الصلة (وزارات الخارجية والدفاع)، ووثائق مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية المرموقة (مثل مجموعة الأزمات الدولية، هيومن رايتس ووتش، راند كوربوريشن، تشاتام هاوس)، والدراسات الأكاديمية والكتب والمقالات العلمية المحكمة، والبيانات الصحفية والتحليلات الإعلامية الموثوقة من وكالات الأنباء العالمية (رويترز، أسوشيتد برس، بي بي سي، الجزيرة). يضمن هذا التنوع في المصادر التثليث (Triangulation) ويُعزز من موثوقية النتائج.
3.4. قضايا الصلاحية والموثوقية والأخلاقيات البحثية:
تم التعامل مع قضايا الصلاحية (الداخلية، الخارجية، البنائية)، والموثوقية، والأخلاقيات البحثية بجدية تامة لضمان جودة الدراسة وتعزيز مصداقية النتائج. وقد تم تعزيز الصلاحية الداخلية من خلال تتبع العملية الدقيق. كما تم تعزيز الصلاحية الخارجية من خلال اختيار حالات دراسية متنوعة وتطبيق QCA. وتم تعزيز صلاحية البناء من خلال تطوير مؤشرات قابلة للقياس للمفاهيم النوعية. تم ضمان الموثوقية من خلال توثيق جميع خطوات البحث ومصادر البيانات بوضوح. كما تم الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع البيانات، والشفافية التامة في عرض النتائج.
4. النتائج التجريبية وتقييم NIWT: البرهان العملي لقوة النظرية
لقد أظهرت دراسات الحالة الخمس توافقًا قويًا وانسجامًا ملحوظًا بين خصائصها وديناميكياتها والفرضيات الموسعة لنظرية الحروب الدولية الجديدة. من خلال تطبيق منهجي لـ “تتبع العملية” و”التحليل المقارن النوعي”، تم استخلاص نتائج حاسمة تؤكد بشكل جازم صحة الفرضيات الرئيسية لـ NIWT، مما يُقدم برهانًا عمليًا على قوة النظرية.
4.1. عرض النتائج التجريبية: تأكيد حاسم للفرضيات الموسعة لـ NIWT:
- ضعف الدولة كنقطة انطلاق محورية للصراع (الفرضية 1):
- الأدلة: في سوريا، أدت أزمة الشرعية وقمع الاحتجاجات في عام 2011 إلى انهيار سريع لاحتكار النظام للعنف، مما أدى إلى فراغ أمني هائل استُغل من قبل جماعات مسلحة محلية وإقليمية. في ليبيا، بعد سقوط نظام القذافي، تفككت المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل شبه كامل، مخلفة فراغًا سلطويًا ملأته الميليشيات المتنافسة. في السودان، الصراع الحالي بين الجيش ومليشيا الدعم السريع يُمثل نتيجة مباشرة لضعف مؤسسات الدولة عمومًا ومؤسسات الدولة الانتقالية خصوصًا وعجزها عن دمج القوى العسكرية المتنافسة ضمن هيكل موحد.
- الآلية السببية المؤكدة: الفراغ الأمني والسياسي، ونزع الشرعية عن مؤسسات الدولة، الناتج عن ضعف الدولة، هو الذي يُفسح المجال لظهور وتمدد الفاعلين من غير الدول، ويجعل الدولة عرضة للتدخلات الخارجية، مما يمهد بشكل حتمي لاندلاع وتمدد الحروب الدولية الجديدة (روتبرغ، 2003؛ البنك الدولي، 2008).
- العولمة كعامل تمكين رئيسي وتغذية مستمرة للصراع (الفرضية 2):
- الأدلة: في سوريا وليبيا واليمن، كان انتشار الأيديولوجيات المتطرفة (كالجهادية السلفية) عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي حاسمًا في تجنيد الآلاف من المقاتلين الأجانب وتعبئة الدعم (فيلدمان، 2014). سهولة تحويل الأموال عبر شبكات عالمية غير رسمية، وتدفق السلاح عبر الحدود، عزز بشكل كبير القدرة المالية للجماعات المسلحة في هذه الدول (أريزا وراينر، 2017). في أوكرانيا، أثرت حملات المعلومات والتضليل الروسية من جهة والغربية من جهة أخرى على الرأي العام الدولي والمحلي بشكل مباشر عبر الشبكات الإعلامية العالمية (المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية، 2025).
- الآلية السببية المؤكدة: الترابط العالمي يُستخدم من قبل الفاعلين لدعم العنف، وتوسيع نطاق الصراعات، وتوفير الموارد اللازمة لاستدامتها، محوّلاً العولمة إلى محفز كبير للعنف (Barnett, 2002).
- تآكل السيادة الوطنية كشرط حتمي لتوسع الصراع (الفرضية 3):
- الأدلة: في سوريا وليبيا واليمن والسودان، لم تكن الحكومات المركزية قادرة على فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها أو حدودها أو مجالها الجوي، مما سهل التدخلات العسكرية الأجنبية (مباشرة وغير مباشرة)، وعمليات تهريب السلاح، وحركة المقاتلين. في أوكرانيا (ما قبل 2022)، أدى ضعف سيادتها على حدودها الشرقية إلى تسلل الأسلحة والمقاتلين من روسيا، مما قوض بشكل فعال سيادة الدولة وجعلها عرضة للتقسيم.
- الآلية السببية المؤكدة: ضعف قدرة الدولة على التحكم بحدودها ومجالها الحيوي، وضعف شرعيتها في أعين الفاعلين الخارجيين، يُخلق بيئة تُصبح فيها السيادة مجرد مفهوم شكلي، مما يُسهل على الدول والفاعلين من غير الدول التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُحوّل الصراع الداخلي إلى ساحة واسعة للحروب بالوكالة.
- مركزية الفاعلين من غير الدول وتفاعلهم المعقد مع الدول (الفرضية 4):
- الأدلة: في سوريا، برزت جماعات كداعش وجبهة النصرة، بالإضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة خارجيًا، كقوى ذات أجندات خاصة ومصادر تمويل ذاتية. في ليبيا، أصبحت الميليشيات المحلية والمرتزقة مثل مجموعة فاغنر لاعبين رئيسيين يتنافسون على السلطة ويتحكمون في الموارد (مامفورد، 2013). الكتاب الثالث: “مرتزقة العصر الحديث: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعلين في الحروب الدولية الجديدة”، يبرهن كيف تُجسد PMSCs هذه الظاهرة في تحديها لاحتكار الدولة للعنف.
- الآلية السببية المؤكدة: الفاعلون من غير الدول ليسوا مجرد أدوات سلبية بيد الدول، بل يمتلكون قدرة على التعبئة والتجنيد والتمويل، ولديهم أجندات مستقلة تدفعهم لاستدامة الصراع. تفاعلهم مع الدول الراعية غالبًا ما يكون معقدًا، مما يجعل إنهاء الصراع أكثر صعوبة، ويُعمق من ظاهرة الحروب بالوكالة المعقدة.
- الاستراتيجيات الهجينة كنمط قتال سائد ومُحير (الفرضية 5):
- الأدلة: في سوريا، شهدنا مزيجًا من القتال التقليدي وحرب العصابات والإرهاب، واستخدامًا مكثفًا لحرب المعلومات والتضليل. في أوكرانيا (ما قبل 2022)، تُعد نموذجًا رائدًا للحرب الهجينة، التي شملت هجمات سيبرانية، وحملات تضليل إعلامي، ودعمًا عسكريًا للوكلاء، وضغطًا اقتصاديًا (المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية، 2025). الكتاب الرابع: “الحرب على العقول: التضليل الإعلامي والسرديات الزائفة في الحروب الدولية الجديدة”، يحلل هذا البعد بعمق.
- الآلية السببية المؤكدة: هذا النمط من القتال يزيد من صعوبة تحديد أطراف الصراع، ويزعزع الاستقرار، ويُطيل أمد الصراع من خلال استنزاف قدرات الخصوم دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة حاسمة.
- اقتصاديات الحرب العابرة للحدود كعامل حاسم في الاستدامة (الفرضية 6):
- الأدلة: في سوريا، اعتمد تنظيم داعش على تهريب النفط والآثار والابتزاز. في ليبيا، تُعد تهريب النفط والبشر وتجارة السلاح الركائز المالية الرئيسية للميليشيات. في السودان، تُشكل مناجم الذهب التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع مصدر تمويل ضخمًا ومستقلًا (The Africa Report, 2023).
- الآلية السببية المؤكدة: هذه الاقتصاديات توفر شريان حياة مستقلًا للفاعلين، مما يقلل من اعتمادهم على الدول الداعمة ويجعلهم أكثر قدرة على الاستمرار في القتال لفترات طويلة. كما أنها تخلق مصالح اقتصادية راسخة لدى العديد من الأطراف في استمرارية الفوضى، مما يعيق حل الصراع ويُصعب من جهود بناء السلام (ريتشاردز، 2005).
5. القدرة التنبؤية لـ NIWT والآثار المترتبة على السياسات
إن NIWT لا تصف فقط الظاهرة، بل تُقدم قدرة تنبؤية استراتيجية، من خلال مؤشرات واضحة، تُمكّن صناع القرار من رصد مناطق الخطر واتخاذ إجراءات وقائية.
5.1. المؤشرات التنبؤية لـ NIWT: إطار للرصد والاستجابة الاستراتيجية:
على الرغم من أن التنبؤ في العلوم الاجتماعية يركز على تحديد الظروف التي تزيد من احتمالية وقوع حدث ما، لا التنبؤ اليقيني ، فإن NIWT تُقدم مجموعة من المؤشرات القابلة للمراقبة، تتفرع من فرضياتها الست، والتي تُمكّن صناع القرار من تحديد الظروف التي تزيد بشكل كبير من احتمالية نشأة أو تصاعد أو استمرار “الحروب الدولية الجديدة” (ResearchGate, 2024).
- مؤشرات ضعف الدولة: ارتفاع مستويات الفساد (مؤشر مدركات الفساد)، ضعف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (البطالة، الفقر)، غياب سيادة القانون (مؤشر سيادة القانون)، انقسام الأجهزة الأمنية، وجود مناطق خارجة عن السيطرة.
- مؤشرات تمكين العولمة: سهولة تدفق التمويل والسلاح غير المشروعين، نشاط شبكات التجنيد العابرة للحدود، انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت، زيادة الترابط الاقتصادي السلبي (الاستفادة من الفوضى).
- مؤشرات تآكل السيادة: تكرار التدخلات الخارجية (عسكرية، سياسية، اقتصادية)، عدم القدرة على التحكم بالحدود والمجال الجوي، وجود فاعلين غير دوليين مدعومين خارجيًا.
- مؤشرات نشاط الفاعلين من غير الدول: ازدياد عدد وقوة الميليشيات والجماعات المسلحة، قدرتها على السيطرة الجغرافية، التمويل الذاتي، وتنافسها مع الدولة، بناء شبكات عابرة للحدود.
- مؤشرات الاستراتيجيات الهجينة: استخدام متزامن لأساليب عسكرية (تقليدية وغير تقليدية)، سيبرانية، معلوماتية (تضليل)، اقتصادية، ونفسية، مع استهداف المدنيين.
- مؤشرات اقتصاديات الحرب: تهريب الموارد (نفط، ذهب، آثار)، تجارة السلاح غير المشروعة، الجريمة المنظمة (خطف، ابتزاز)، غسيل الأموال، وجود مستفيدين ماليين من استمرار الصراع.
5.2. الآثار المترتبة على السياسات:
يُعَدُّ الفهم النظري المتعمق لظاهرة “الحروب الدولية الجديدة” أمرًا حيويًا لتطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فاعلية لمنع الصراع، وإدارته، وبناء السلام المستدام. تُقدم NIWT رؤى عملية لصناع السياسات والمجتمع الدولي:
- إعادة تعريف تحدي ضعف الدولة: يجب على جهود الدول عمومًا أن تُركز على بناء مؤسسات دولة قوية، شرعية، وقادرة على احتكار العنف المشروع، بدلًا من مجرد الدعوة إلى التدخلات العسكرية التي غالبًا ما تزيد الفوضى. يجب أن يشمل ذلك دعم الحكم الديمقراطي، مكافحة الفساد، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
- مواجهة آثار العولمة: من خلال تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي لمكافحة شبكات التمويل غير المشروع وتدفق الأسلحة والمقاتلين، ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة عبر الشبكات الرقمية مع احترام الحريات.
- إدارة تآكل السيادة بحذر وعمق: بإيجاد توازن دقيق بين احترام السيادة الوطنية للدول والدعم الشرعي للحكومات في حالات الكوارث الإنسانية أو التهديدات العابرة للحدود، مع التركيز على بناء القدرة الوطنية للدول الضعيفة على السيطرة الفعلية على حدودها ومؤسساتها.
- التعامل المرن مع الفاعلين من غير الدول: من خلال فهم أجنداتهم المتنوعة ودوافعهم، والبحث عن إمكانيات دمج بعضهم في الحلول السياسية (بشروط واضحة)، وتطوير دبلوماسية معقدة للتعامل مع ظاهرة الحروب بالوكالة التي تتضمن فاعلين متعددين.
- الاستعداد للحرب الهجينة: بتطوير قدرات دفاعية وهجومية لا تقتصر على الجانب العسكري التقليدي، بل تشمل القدرات السيبرانية، والاستخباراتية، وحرب المعلومات، والدفاع المدني، ورفع الوعي العام بطبيعة هذه الاستراتيجيات.
- تفكيك اقتصاديات الحرب: من خلال استراتيجيات شاملة تستهدف تتبع الأموال، وتضييق الخناق على الأنشطة غير المشروعة (تهريب الموارد، الجريمة المنظمة)، وحرمان الفاعلين من مصادر تمويلهم التي تُغذي استمرار الصراع.
6. الخلاصة:
نحو فهم أعمق لمستقبل الصراع
في الختام، تُعد “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) إسهامًا معرفيًا حيويًا يملأ فجوة تفسيرية قائمة في أدبيات العلاقات الدولية ودراسات الصراع. إنها نظرية تتجاوز مجرد الوصف لتقدم تفسيرًا سببيًا شاملًا ومتكاملًا، وتُعزز من قدرتنا على فهم الحروب المعاصرة، ليس فقط كما هي، بل لماذا تنشأ، وكيف تُستدام، وما هي مساراتها المحتملة.
إن ولادة نظرية علمية أصيلة بهذا العمق والشمولية، تنبع من قلب السودان الذي يعيش اليوم واقعًا مريرًا يُجسد بوضوح تحديات الحروب الدولية الجديدة في أبشع صورها، تُعد إشارة قوية على أن البحث العلمي في العالم الأفريقي والعربي ليس مجرد متلقٍ سلبي للمعرفة، بل هو قادر على إنتاجها والمساهمة الفاعلة في صياغة فهمنا للعالم المعاصر. لقد حان الوقت لأن تُساهم خبراتنا المكتسبة من عمق التحديات في بناء المعرفة العالمية وتطوير الأدوات التحليلية التي تُلامس الواقع.
ومع قرب صدور سلسلة كتب “فهم عالم الحروب المعاصرة: سلسلة الحروب الدولية الجديدة”، فإنني أؤمن بأن هذه النظرية سُتساهم في رسم خرائط أوضح لمستقبل أكثر أمانًا وعدلًا في عالم يزداد تعقيدًا وضبابية. إن فهم هذه الحروب ليس ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة استراتيجية قصوى تفرضها تحديات الأمن في أيامنا. هذا المقال هو محاولة متواضعة لتقديم جزء حيوي من هذه المعرفة، أملًا في المساهمة في بناء عالم يتجاوز ركام الصراعات.
المصادر والمراجع:
- أريزا، ل.، وراينر، م. (محررون). (2017). Dismantling States: State Failure, Conflict and Violence in the Middle East. روتليدج.
- البنك الدولي. (2008). 124789-WP-Zoellick-9-12-2008-ARABIC-Fragile-States-PUBLIC.docx. أنظر: https://documents1.worldbank.org/-Fragile-States-PUBLIC.docx.
- بريجنسكي، ز. (1998). رقعة الشطرنج الكبرى: الهيمنة الأمريكية ومقتضياتها الجيواستراتيجية (ع. و. علوب، ترجمة). الدار العالمية. (العمل الأصلي نُشر عام 1997).
- روتبرغ، ر. (2003). State Failure and State Weakness in a Time of Terror. مطبعة مؤسسة بروكينغز.
- ريتشاردز، ب. (2005). No Peace, No War: An Anthropology of Contemporary Armed Violence. مطبعة جامعة أوهايو.
- سينغر، ب. (2007). محاربو الشركات: صعود صناعة الجيش الخاص (و. عادل، ترجمة). هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. (العمل الأصلي نُشر عام 2007).
- كالدور، م. (2003). الحروب الجديدة والقديمة: العنف المنظم في العصر العالمي (ل. العياشي، ترجمة). مركز دراسات الوحدة العربية. (العمل الأصلي نُشر عام 1999).
- كون، ت. (1992). بنية الثورات العلمية (ح. ح. إسماعيل، ترجمة). المنظمة العربية للترجمة. (العمل الأصلي نُشر عام 1962).
- كيوهين، ر. أ.، وناي، ج. س. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. ليتل، براون.
- مامفورد، أ. (2013). Proxy Warfare. بوليتي بريس.
- مورغنثاو، ه. ج. (1964). السياسة بين الأمم: الصراع من أجل القوة والسلام (م. الزعبي، ترجمة). دار العودة. (العمل الأصلي نُشر عام 1948).
- المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية. (2025). الصراع السيبراني بين الواقعية والليبرالية: مقاربة نظرية. أنظر:
https://mediterraneancss.uk/2025/04/23/the-cyber_-conflict_-between-_realism-and-liberalism/.
- المستقبل لدراسات الشرق الأوسط. (بلا تاريخ). إعادة تشكُّل الجيوش في دول الصراعات بالشرق الأوسط. أنظر: https://futureuae.com/ar-AE/Release/ReleaseArticle/1455/during-A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.
- والتز، ك. ن. (1992). نظرية السياسة الدولية (أ. م. عبد اللطيف، ترجمة). مكتبة مدبولي. (العمل الأصلي نُشر عام 1979).
- فيبر، م. (2000). السياسة كمهنة (م. عناني، ترجمة). الهيئة المصرية العامة للكتاب. (العمل الأصلي نُشر عام 1919).
- Barnett, M. (2002). The Politics of Global Governance. Cambridge University Press.
- Byman, D. L., & Pollack, K. M. (2001). Bin Laden’s “Fatwa” and terrorist strategy. Foreign Affairs, 80(4), 1-13.
- Clapp, J., & Rosenbaum, D. (1994). The problem of ungoverned spaces: A new challenge to U.S. national security. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Collier, P. (2000). Economic causes of civil conflict and their implications for policy. World Bank, Washington DC.
- Feldman, M. B. (2014). Transforming conflict in the Middle East: New strategies for a changing world.
- Finnemore, M. (1996). National Interests in International Society. Cornell University Press.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press.
- Hoffman, F. G. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy Studies.
- Krasner, S. D. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press.
- Maximize Market Research. (بلا تاريخ). Global Commercial Security Market. أنظر:
https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-commercial-security-market/55236/.
- Ragin, C. C. (2008). Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. University of Chicago Press.
- ResearchGate. (2024). القدرة التنبؤية للدعم الاجتماعي المُدرك بالقدرة على التكيف المهني لدى طلبة الجامعة. أنظر:
https://www.researchgate.net/publication/382725664_alqdrt_altnbwyt_lldm_alajtm.
- The Africa Report. (2023, June 14). Sudan: How Russia’s Wagner Group is fuelling the war. أنظر:
https://www.theafricareport.com/281350/sudan-how-russias-wagner-group-is-fuelling-the-war/.
- جامعة النجاح. (بلا تاريخ). القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة في مهارات التعلم. أنظر: https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_14.pdf.