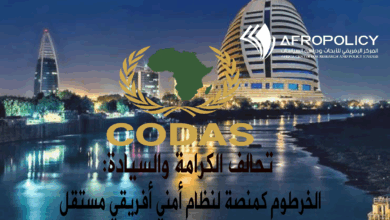ملخص الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة العلاقة بين منطق الإدارة العامة ومنطق العملية السياسية، في سياق التداخل البنيوي الذي يميز أداء المؤسسات الحكومية في الدول النامية، وبخاصة في الحالة الليبية.
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها
” أن ضعف تفعيل الإدارة العامة لا يعود فقط إلى العوامل التنظيمية أو القانونية، بل إلى غياب التوازن بين البيروقراطية كآلية ضبط، والسياسة كآلية توجيه، بما يؤدي إلى تشويش في عملية صنع القرار وتراجع في كفاءة الأداء العام”.
ترتكز الدراسة على توضيح الإطار النظري للإدارة العامة بوصفها نظامًا قائمًا على الموضوعية، والمساءلة، والفعالية، مقابل العملية السياسية التي تُدار بمنطق النفوذ، والمصالح، والولاءات. وهو ما يجعل من الحالة الليبية نموذجًا مناسبًا لاختبار مدى قدرة البيروقراطية على الصمود أمام ضغوط الفعل السياسي. ومن خلال هذا التقابل المفهومي، يتم تحليل مدى قدرة المؤسسات الإدارية على التكيف مع متطلبات النظام السياسي دون أن تفقد استقلالها أو كفاءتها الوظيفية.
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، لتحديد نوع وقوة العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة، على النحو الآتي:
- المتغير التابع: تفعيل الإدارة العامة
- المتغير المستقل: الاستقرار السياسي
- المتغيرات الضابطة: الهيكل التنظيمي ومستوى التنسيق المؤسسي
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية دقيقة تستند إلى وضوح المفاهيم وضبطها تجريبيًا، باعتبار أن أي غموض في تحديد طبيعة المتغيرات — سواء كانت مستقلة أو تابعة أو ضابطة — قد يؤدي إلى تضليل النتائج ويُضعف من صلاحية الاستنتاجات. ومن ثم، تركز الدراسة على أهمية الوضوح المفاهيمي والدقة الإجرائية كأساس لضمان الموثوقية العلمية في بحوث الإدارة العامة، خصوصًا في البيئات السياسية المعقدة.
تكشف هذه الدراسة عن وجود علاقة بين الاستقرار السياسي ومستوى تفعيل الإدارة العامة. فكلما ارتفع مستوى الاستقرار السياسي — بوصفه متغيرًا مستقلاً — تحسنت قدرة الجهاز الإداري على أداء وظائفه التخطيطية والتنفيذية والرقابية، بما يعكس علاقة طردية موجبة بين المتغيرين.
وفي المقابل، يظهر أثر سلبي عند ضعف التنسيق المؤسسي أو ارتفاع درجة التسييس في القرارات الإدارية، ما يعكس دور المتغيرات الضابطة في إضعاف أو تعزيز العلاقة بين المجالين الإداري والسياسي.
كما تشير النتائج إلى أن غياب الفصل الوظيفي بين القرارات السياسية والإدارية يؤدي إلى حالة من “الاختلال البنيوي” تجعل الإدارة العامة رهينة للتوازنات السياسية، بدل أن تكون أداة لتنفيذ السياسات العامة بكفاءة وحياد.
وتُظهر الدراسة فروقًا في درجة تفعيل الإدارة العامة تبعًا لطبيعة الهيكل الإداري، ومدى وضوح الصلاحيات، ومستوى الاستقلالية التنظيمية، ما يفتح المجال أمام مقاربات إصلاحية جديدة تتجاوز الإطار النظري التقليدي.
مع ضرورة تحديد المتغيرات بدقة في دراسات الإدارة العامة لضمان صدقية التحليل وتجنب التضليل في النتائج، مع استخدام أدوات قياس تتناسب مع طبيعة الظواهر الإدارية والسياسية.
تبنّي مقاربة تكاملية بين التحليل الكمي والتحليل النوعي، بحيث يُستفاد من الأرقام في تفسير الاتجاهات، ومن المعطيات الميدانية في فهم السياقات الواقعية. تشجيع البحوث المقارنة التي تتناول تجارب دولية نجحت في التوفيق بين الفعالية الإدارية والشرعية السياسية، لاستخلاص دروس إصلاحية يمكن تكييفها مع الخصوصية الليبية والعربية عامة.
مقدمة:
يُعدّ التداخل بين الإدارة العامة والعمل السياسي من أبرز القضايا التي تشغل حقل الدراسات الإدارية في الوقت الراهن، لما يطرحه من إشكاليات تتعلق بحدود الفعل الإداري في بيئة سياسية متقلبة. ومن خلال تحليل الدراسات السابقة، تؤكد هذه الدراسة أن فعالية الإدارة العامة ليست نتاج البنية التنظيمية وحدها، بل انعكاس مباشر لمستوى الاستقرار السياسي وطبيعة العلاقة بين مراكز القرار.
فمن جهة، أظهرت نتائج التحليل أن الإدارة العامة لا يمكن أن تحقق كفاءتها الوظيفية دون بيئة سياسية مستقرة تُحافظ على وضوح الصلاحيات وتوازن السلطات. ومن جهة أخرى، فإن الإفراط في هيمنة المنطق السياسي على العملية الإدارية يؤدي إلى تآكل قيم الحياد والموضوعية، وهو ما يفسر محدودية الإصلاح الإداري في العديد من التجارب الوطنية.
تؤكد الدراسة أن الدقة في تحديد المتغيرات وضبطها مفاهيميًا تمثل شرطًا أساسًا في تحقيق الموثوقية العلمية لبحوث الإدارة العامة، إذ إن أي غموض في تعريف المتغير المستقل أو التابع أو الضابط ينعكس مباشرة على صلاحية النتائج وقدرتها على تفسير الظواهر الواقعية. لذلك، تبرز أهمية التكامل بين التحليل الكمي (كمعامل ارتباط بيرسون) والتحليل الكيفي لفهم الأبعاد العميقة للعلاقة بين النظرية والتطبيق.
وفي ضوء ما سبق، تسعى الدراسة إلى المساهمة في بناء تصور منهجي جديد يجعل من الإدارة العامة فاعلاً بنيويًا مستقلًا نسبيًا عن التوجهات السياسية، دون أن تنفصل عن أهداف الدولة العامة. وبهذا المعنى، تُعد هذه المقاربة محاولة لإعادة التوازن بين متطلبات الفعالية الإدارية وضرورات الشرعية السياسية، في إطار من الحوكمة الرشيدة التي تقوم على الكفاءة، الشفافية، والمساءلة.
ومن ثم، تمهد هذه الدراسة الطريق أمام بحوث تطبيقية لاحقة تتناول آليات إصلاح الإدارة العامة في البيئات السياسية الانتقالية، بما يتيح تجاوز الأطر التقليدية نحو نموذج حوكمي أكثر تكاملًا وفاعلية.
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة
1-1 مفهوم الإدارة العامة وتطورها النظري
1-1-2 مفهوم الإدارة العامة
تُعدّ الإدارة العامة من المفاهيم المحورية في العلوم السياسية والإدارية، كونها تمثل الأداة التنفيذية التي تُترجم السياسات العامة إلى برامج وأفعال ملموسة. وقد عُرفت الإدارة العامة بأنها: «النشاط المنظم الذي تمارسه الدولة لتحقيق أهدافها العامة من خلال أجهزة وهيئات تتولى تنفيذ السياسات وفق مبادئ الكفاءة والمساءلة والعدالة» ([1]).
بهذا المعنى تتجاوز الإدارة العامة في مضمونها البعد الإداري الضيق المرتبط بالإجراءات البيروقراطية، لتشمل إدارة الموارد العامة، وتنسيق العمل المؤسسي، وضمان استمرارية الدولة في أداء وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتُعرّفها موسوعة العلوم الاجتماعية الأمريكية الإدارة العامة : “العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ أمرٍ ما والإشراف عليه”، أي أنّها لا تقتصر على النشاط التنفيذي لإنتاج السلع والخدمات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتُعبّر عن جهاز إداري يضطلع بتنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدمات للمجتمع“([2]). ومن هذا المنظور، تُعدّ الإدارة العامة أداة الدولة في تحويل القرارات السياسية إلى واقعٍ عملي عبر آليات التنظيم، والرقابة، والتنفيذ.
من التعريف السابق يلاحظ أن الحكومـة كمؤسسة تعني الوظيفـة التنفيذية في الدولـــة ورسم السياسات العامة، بالرغم من أن الإدارة العامة تـرتبط بالحكومة إلا أنهـا أشمل مـن ذلـك حيث تعني الإدارة العامة مجموعـة الأشخاص والأجهزة القائمة تحت سلطة الحكومة لأداء المهام التالية ([3]):
- تنفيــذ مختلــف القوانين واللوائح التي تختص بهــا أجهــزة الدولــة التنفيذية.
- إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين.
- أداء الخدمات العامة بالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة.
أي أن الإدارة العامة باختصار تمثل مجموع النشــاط والعمل الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة والإنتاج الحكومي وذلك في ضوء المصلحة العامة للدولة ووفقاً لاحتياجات طالبي الخدمـة مـن أفـراد الشعب وعلـى هـذا فخلاصـة هـي تقـديم خدمـة عامـة (Public) أي لجميع الناس. أي إنها تختص الإدارة العامة، كمفهوم أو تنظيم في التنفيذ المنظم والمفصل للقانون العام في الدولة، بتنظيم الموارد المتاحة وتوجيهها لتحقيق السياسة العامة، بما يتفق مع رغبات الناس، وحاجاتهم، فعن طريقها توفر الحكومات حاجات المجتمع من الأمن إلى الرفاه لتكون دولة إدارة ([4]).
هذا التعريف للإدارة العامة ضاعف من مهامها وأرتقى بأهدافها ليؤكد على أن الإدارة العامة تهتم بأساليب وضع السياسات العامة للدولة موضع التنفيذ، أي أنها تطال كل ما يتعلق بالقطاع العام، لجهة تنظيمه، والنشاطات التي يقوم بها بداية من مرحلة الانتخابات وتشكيل الحكومة بأجهزتها (التشريعية والتنفيذية والقضائية)؛ وانتهاء بالوصول إلى قيام كل فرع من فروع الحكومة بمسؤوليته المنوط به، لا سيما قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسة العامة.
وبهذا المعني فإن الإدارة العام ينحصر نشاطها في مرحلة رسم السياسات العامة وتنفيذ القوانين الذي تقوم به الحكومة وإدارتها التنفيذية، وبالتالي المهام التي تتولاها الإدارة العامة، سيادية تتمثل في الدفاع والامن الداخلي والقضاء ومهام اقتصادية، تتولاها وزارات المال والاقتصاد والصناعة والزراعة…إلخ ومهام وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، وسواها([5]).
وبذلك فالمحدد لشكل بناء الإدارة العامة هي الأدوات التشريعية (الدستورية والقانونية) المخولة بالأشراف على عملية صنع سياسات العامة للدولة من خلال مستويين اثنين للعمل، وينتج عن ذلك أن هناك، فئتين اثنين للهيئات. جهة عمل الهيئات السياسية ينظمها الدستور. وهناك، من جهة أخرى، النشاط أو العمل الإداري الذي ينظمه القانون، بالمعني الواسع للعبارة، ويسعى إلى تطبيق أحكامة، مسترشدا بما ترسمه الهيئات السياسية. فهو من هذه الناحية، جهاز تنفيذي.
ومن هنا طغت طبيعة عمله التنفيذي. فالهيئات الحكومية هي، بالأساس، هيئات سياسية بأنظمتها، ونشأتها، وصلاحياتها. وهي تتربع، في الوقت ذاته. على رأس الإدارة تدير دفتها، وترسم وجهة سيرها وتعتبر الإدارة العامة ظاهرة تسود كافة المجتمعات المدنية على اختلاف أيدولوجياتها كونها تؤدي وظائف محددة لا يمكن إلا الوفاء بها.
وعلى الرغم من تشابه الإدارات العامة في هذه الخاصية، أي امتلاكها جميعا لشكل وبناء تنظيمي، إلا أن هناك الشكل والبناء التنظيمي يمكن أن يختلف من بلد إلى آخر تبعاً لطبيعة النظام السياسي، الذي ينعكس على الأسس الدستورية والقانونية المنشئة للإدارة العامة، وكذلك على طبيعة العلاقة القائمة بين الإدارة العامة كأداة تنفيذ ([6]).
ووفقاً لتعريف الشائع في البلدان الأوروبية، على وجهه العموم، فأن الإدارات العامة هي (مجموع الوحدات القانونية التي تقوم، بصورة أساسية، بتأدية الخدمات التجارية، تتولى من وجه آخر، إعادة توزيع المداخيل، والثروة الوطنية، في جنب منها، وتؤمن القسم الاكبر من مواردها المالية من خلال الضرائب والرسوم ذات الطابع الاجباري) ([7]).
وبالتالي الإدارة العامة هي وحدات وهيئات قانونية حكومية، تتولى تسيير شؤون المجتمع بما يؤمن المصلحة العامة. بإدارتها العامة المركزية، أو اللا مركزية. ويرى الباحث أن لمفهوم الإدارة العامة تعريف مفصل يشمل العديد من الخصائص ومنها:([8])
- عمل جماعي تعاوني في إطار عام بقصد تنفيذ سياسات عامة موضوعه.
- نشاطات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- الإدارة العامة جزءاُ أساسياً من العملية السياسية في الدولة.
- للإدارة العامة تلعب دوراً مؤثراً في مجال السياسات العامة، ولها خصائص مميزة عن إدارة الاعمال بالرغم من اشتراكهم في أساسيات وأصول الإدارة بشكل عام.
- تتفاعل الإدارة العامة-كنظام مفتوح- مع فعاليات مجتمعية عديدة في إطار الصالح العام للدولة والمجتمع.
1-1-3 التطور النظري لمفهوم الإدارة العامة
لم تصل الإدارة إلى ما هي عليها الان من أهمية كعلم قائم بحد ذاته، له نظريات ومفاهيم وأسس ومبادئ، إلا بعد بذل جهود فكرية لإرساء مبادئها فقد مرّ مفهوم الإدارة العامة بعدة مراحل فكرية يمكن تلخيصها في ثلاث مدارس أساسية:
- المدرسة الكلاسيكية: ركزت على الكفاءة والانضباط والهيكل التنظيمي، كما لدى “فردريك تايلور” وماكس فيبر”، حيث اعتُبرت الإدارة العامة نشاطًا عقلانيًا يخضع لمبدأ التسلسل الهرمي والاختصاص الوظيفي.[9]
- المدرسة السلوكية: ظهرت كرد فعل على الجمود البيروقراطي، واهتمت بدراسة السلوك التنظيمي، والتحفيز، والعلاقات الإنسانية داخل الجهاز الإداري.
- المدرسة الحديثة (حوكمة وإدارة عامة جديدة): سعت إلى دمج القيم الديمقراطية والشفافية والمساءلة في العمل الإداري، وربط الأداء الإداري بمؤشرات الفعالية وجودة الخدمات العامة.
تُعدّ الإدارة العامة أحد الأعمدة الرئيسة في بناء الدولة الحديثة، إذ تمثل الجهاز التنفيذي الذي تتجسد من خلاله سياسات الحكومة وتتحول القرارات السياسية إلى واقع مؤسسي ملموس. وقد مرّ مفهوم الإدارة العامة بتحولات فكرية ومنهجية عميقة، تزامنت مع تطور الدولة القومية وتغير وظائفها.
في البداية، ارتبط مفهوم الإدارة العامة بالبيروقراطية التقليدية كما صاغها ماكس فيبر، التي ترتكز على تسلسل هرمي واضح، وتحديد دقيق للاختصاصات، ومبدأ الحياد والموضوعية. وقد اعتُبرت هذه البنية النموذج الأمثل لضمان الكفاءة والعدالة في تنفيذ القوانين.
غير أن التوسع في وظائف الدولة وازدياد تدخلها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، أدى إلى نشوء تيارات نقدية للبيروقراطية، من أبرزها نظرية السلوك التنظيمي ومدرسة الإدارة الجديدة (New Public Management)، التي ركزت على مفاهيم الفعالية، الجودة، والمساءلة، باعتبار أن الإدارة ليست مجرد هياكل بل منظومات تفاعلية تتأثر بالسياسة والاقتصاد والمجتمع.
أما في السياق العربي، فقد تميزت الإدارة العامة بارتباطها الوثيق بالسلطة السياسية، ما جعلها أداة تنفيذ أكثر منها جهاز خدمة عامة. وفي الحالة الليبية تحديدًا، تراوحت الإدارة بين فترات مركزية صارمة وأخرى يغلب عليها الطابع الشخصي في اتخاذ القرار، مما عمّق الفجوة بين المنظور الإداري العقلاني والمنظور السياسي المصلحي.
فقد شكّل هذا التطور انتقالًا من رؤية الإدارة العامة كـ «جهاز تنفيذي» إلى اعتبارها فاعلًا استراتيجيًا في بناء الدولة الحديثة وصنع السياسات العامة. حيث تطور فكر الإدارة العامة لجهة أنظمة حكمها، ووسائل إدارتها وأخذت الإدارة، تتكون تدريجياً كعلم له حيزه الخاص المستقل نسبيا عن العلم السياسي. واستمر كذلك، على مدى زمني طويل، إلى أنه انفصل عنها، فباتت له مواضيعه الخاصة المحددة، وأساليب معالجتها وبحثها. ثم تكامل واستقل علم الإدارة عن العلم السياسي ليشكل علماً خاصاً، له مواضيعه، ومفكروه ومدارسة.
وينسب الفضل في تأصيل الإدارة العامة كحقل مستقل لــــ وودرو ولسون (Woodrow Wilson) فصل بين السياسة والإدارة، مستندا إلى معيار للتفرقة بينهما، على أن الإدارة إنما تعني بكيفية أداء الاعمال، على عكس السياسية التي تعني بتحديد الأهداف، وتحديد ما ينبغي القيام به من أعمال بمعني إن الإدارة العامة ينصب نشاطها على دراسة النشاط الإداري بمستوياته المختلفة، تنفيذا لأهداف تحددها الدولة، في حين أن علم السياسية يركز على دراسة النظريات، والمذاهب السياسية، والسلطات في الدولة ([10]). ومع ذلك، فإن الربط بين الإدارة العامة وعلم السياسة يبقى له ما يبرره، وذلك استناداً إلى اعتبارين أساسيين:
الاعتبار الأول: أن أجهزة الإدارة العامة الحكومية تمثل كيان السلطة التنفيذية للدولة، ولا يمكن تحليل أدائهاـ وفهم العوامل التي تحكمها، إلا بتحليل القوى السياسية والاجتماعية التي تحيط بها، وفهم طبيعة العملية السياسية التي تعمل فيها الاجهزة التشريعية والتنفيذية، وهذا يعني أن علم السياسية هو المورد الرئيسي الذي يستقي منه الإدارة العامة، بقصد تحقيق اهداف.
والاعتبار الثاني: إن أجهزة الإدارة العامة الحكومية تتولى تنفيذ السياسة العامة؛ بل أنها تشارك في رسم هذه السياسية. فقد تصدر السياسة العامة للدولة عن السلطة التشريعية أو بمبادرة من السلطة التنفيذية؛ وفي كلتا الحالتين تبقى تلك السياسة في الإطار العام وضعها موضع التنفيذ. وتمثل السياسات العامة احدى مظاهر نجاح الدولة أو فشلها بحسب المفاهيم التي ارتكزت عليها الكثير من الأفكار والمعتقدات، التي أسست لسياسة الدولة، وفقا لطبيعة النظام السياسي والقيم التي يتبنها، أي بحسب الإيديولوجيا.
ففي الدول الاشتراكية، كانت السياسات العامة للدولة مركزية، بينما في الأنظمة الرسمالية كانت القوى تتداخل وتتشارك مع أجهزة الحكم في رسم السياسات العامة وعكس هذا المفهوم منهج عمل السلطة الرسمية والغير رسمية في ممارسة الحكم في إدارة الموارد الاقتصادية من أجل التنمية في إطار التشريعي أو القانوني.
فالتطور الطبيعي للإدارة العامة لا تنشأ ولا تعمل في فراغ بل تتكون وتعمل في ظل كيان سياسي، واجتماعي هو الدولة- وإذا كانت الدولة تتكون من الشعب، والاقليم، والسلطة السياسية، والنظام الاجتماعي السائد- فالإدارة العامة هي مناطة في المحافظة على كيان الدولة تتفاعل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية بين عدد من الفاعلين؛ مثل (المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص) على المستويين المحلي والمركزي. وذلك بربط بين جودة وفعالية وأسلوب إدارة شئون الدولة ودرجة رخاء المجتمع. حيث تلعب الفواعل الرسمية ممثلة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية والجهاز الإداري دورا مباشر وهاما في صنع السياسات.
1-3 العملية السياسية ومنطقها البنيوي
شكل العلاقة بين الإدارة والسياسة إحدى القضايا المحورية في علم الإدارة العامة. ففي حين تنادي المدرسة التقليدية بضرورة الفصل بين المجالين لضمان الحياد الإداري، ترى الاتجاهات الحديثة أن هذا الفصل غير ممكن في الواقع، إذ إن عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة هي نتاج تفاعل مستمر بين الفاعلين الإداريين والسياسيين.
ويبرز هنا ما يُعرف بـ التداخل البنيوي، أي التفاعل العضوي بين مؤسسات الدولة الإدارية والسياسية ضمن بيئة واحدة. فالمؤسسات الإدارية لا تعمل في فراغ، بل تتأثر بالمناخ السياسي، وبالمقابل فإن الأداء الإداري الجيد يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي.
هذا التداخل، وإن كان طبيعيًا في الأنظمة الديمقراطية، يصبح إشكاليًا في الدول ذات المؤسسات الضعيفة، حيث يؤدي اختلال التوازن بين المنطقين إلى تعطيل الأداء العام.
وفي الحالة الليبية، يتجلى هذا التداخل في هيمنة البعد السياسي على الجهاز الإداري، سواء عبر آليات التعيين على أساس الولاء، أو عبر تضارب الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية. وقد أدى ذلك إلى تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية، وإلى ضعف في تفعيل السياسات العامة على نحو متسق ومستدام.
1-3-1 مفهوم العملية السياسية
تُعرَّف العملية السياسية بأنها سلسلة من التفاعلات التي تجري بين الفاعلين السياسيين (أفرادًا وجماعات ومؤسسات)، بهدف اتخاذ قرارات عامة تعبّر عن الإرادة الجماعية للمجتمع. وتشمل هذه العملية مراحل متعددة تبدأ من تحديد المشكلة العامة، مرورًا بـ وضع السياسات وصنع القرار، وصولًا إلى التنفيذ والتقويم.
وبهذا المعنى، فإن العملية السياسية ليست مجرد نشاط حزبي أو انتخابي، بل هي بنية تفاعلية تحدد اتجاهات الدولة وتوزيع السلطة داخلها.
1-3-2 منطق السياسة مقابل منطق الإدارة
يقوم منطق السياسة على المرونة، والمساومة، والمصالح المتغيرة، في حين يقوم منطق الإدارة على الثبات، والموضوعية، والانضباط.
وعندما يلتقي المنطقان في بيئة واحدة دون تنظيم واضح للفصل بينهما، تنشأ إشكالية التداخل البنيوي التي تشوّش على وضوح الأدوار الوظيفية داخل الدولة.
في الأنظمة المستقرة، يوجد توازن مؤسسي بين السلطتين السياسية والإدارية، بحيث تُحدّد السياسة الاتجاهات العامة، بينما تتولى الإدارة التنفيذ الفعّال. أما في البيئات الانتقالية، مثل الحالة الليبية، فإن هذا التوازن غالبًا ما يختل، فتصبح الإدارة أداة بيد القوى السياسية، ما يُفقدها استقلالها وكفاءتها.
مفهوم يشير إلى تشابك الأدوار بين المجالين الإداري والسياسي، بحيث تتداخل الصلاحيات والوظائف، مما يؤدي أحيانًا إلى تضارب في الأهداف أو تقييد للفعالية المؤسسية.
1-4 العلاقة البنيوية بين الإدارة العامة والعملية السياسية
العلاقة في هذا النموذج هي علاقة تحويلية إي أن النظام هو كل مكون من ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداة. أي أنه نسق علائقي، حيث لا معنى لــــ تفعيل الإدارة العامة خارج علاقتها بكل من الاستقرار السياسي، هذا الأخير ليس مجرد غياب الصرعات، بل هو الوظيفة التي تتيح للإدارة العامة العمل بفعالية، والتي بدورها تكون وظيفتها هي تحقيق كفاءة الاداء بمعنى التقدم في أي مستوى يعتمد على شروط وعلاقات المستوى الذي يسبقه.
1-4-1 الإدارة كأداة للعملية السياسية
تُعدّ الإدارة العامة الأداة التنفيذية التي يعتمد عليها العملية السياسي لترجمة رؤيته في الواقع. فهي تمثل «ذراع الدولة» في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات، وبالتالي لا يمكن فصلها عن الإطار السياسي الذي تعمل في ظله.
إلا أن مستوى التسييس في الجهاز الإداري يحدد إلى أي مدى تظل الإدارة أداة مهنية أم تتحول إلى أداة نفوذ سياسي.
1-4-2 أثر الاستقرار السياسي على فعالية الإدارة العامة
يؤثر الاستقرار السياسي تأثيرًا مباشرًا في درجة فاعلية الإدارة العامة. فكلما ازداد الاستقرار، ارتفعت كفاءة الأجهزة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة. بينما يؤدي الاضطراب السياسي إلى ضعف الانضباط الإداري وتعدد مراكز القرار وتضارب التعليمات، ما ينعكس سلبًا على الأداء العام.
وقد أظهرت دراسات مقارنة في الدول النامية أن العلاقة بين الاستقرار السياسي وكفاءة الجهاز الإداري علاقة طردية، إلا أنها مشروطة بوجود مؤسسات رقابية وتنظيمية مستقلة.
1-4-3 التداخل البنيوي وأثره في الأداء المؤسسي
يقصد بالتداخل البنيوي الحالة التي تتقاطع فيها الأدوار بين المؤسسات السياسية والإدارية، بحيث يصعب الفصل بين القرار الإداري والقرار السياسي. ويؤدي هذا التداخل إلى:
- ضعف استقلال القرار الإداري.
- تغليب الولاءات السياسية على الكفاءة المهنية.
- تراجع الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة.
- تشوه البنية الوظيفية للمؤسسات الحكومية.
في الحالة الليبية، يظهر هذا التداخل بشكل واضح في عملية التعيين، وتوزيع المناصب، وتحديد الأولويات التنموية، حيث تُدار بعض القرارات الإدارية وفق اعتبارات سياسية أو مناطقية، مما يعكس الحاجة إلى إصلاح بنيوي يضمن استقلالية الإدارة دون فصلها عن المساءلة السياسية.
1-4 الأطر النظرية المفسرة للعلاقة بين الإدارة والسياسة
يمكن تفسير التفاعل بين الإدارة والسياسة وفق ثلاث مقاربات نظرية أساسية:
1-4-1 النموذج التقليدي (الفصل الوظيفي):
يفترض أن السياسة تضع الأهداف، والإدارة تنفذها دون تدخل متبادل. وهو نموذج مثالي يهدف إلى حماية الحياد الإداري، لكنه يصعب تطبيقه في البيئات الانتقالية.
1-4-2 النموذج التكاملي (التداخل البنيوي المنظم):
يرى أن التفاعل بين الإدارة والسياسة أمر ضروري لتحقيق الفعالية، شريطة أن يكون منظمًا ومؤسسيًا، بحيث تُحافظ الإدارة على استقلالها المهني ضمن توجيهات سياسية عامة.
1-4-3 نموذج الحوكمة الحديثة:
يقوم على إشراك فاعلين متعدّدين (القطاع الخاص، المجتمع المدني، الهيئات المحلية) في تنفيذ السياسات العامة، مما يخلق شبكة من العلاقات الأفقية تعيد تعريف دور الإدارة العامة كمنسق أكثر من كونها منفّذًا مباشرًا.
1-4-4 الأسس النظرية المفسرة لتفعيل الإدارة العامة
تستند الدراسة إلى مجموعة من الأسس النظريات التي تسهم في تفسير طبيعة العلاقة بين الإدارة والسياسة، ومن أبرزها:
1-4-5 نظرية النظم (Systems Theory):
تنظر إلى الإدارة العامة كنظام مفتوح يتفاعل مع البيئة السياسية والاجتماعية، حيث تتدفق المدخلات (مطالب، موارد، قرارات) لتتحول عبر عمليات إدارية إلى مخرجات (خدمات، سياسات).
ويؤدي الخلل في هذا التفاعل إلى ضعف التفعيل الإداري.
1-4-6 النظرية المؤسسية الجديدة (New Institutionalism):
تركّز على أن الهياكل الرسمية ليست وحدها المحدد الرئيس للأداء، بل إن القواعد غير الرسمية والثقافة التنظيمية تشكل إطارًا مؤثرًا في تفعيل الإدارة العامة.
ومن ثم، فإن إصلاح الإدارة لا يتحقق فقط بتعديل القوانين، بل أيضًا بإعادة بناء الثقافة المؤسسية.
1-4-7 نظرية الاعتماد المتبادل بين السياسة والإدارة:
تفترض هذه النظرية أن العلاقة بين المجالين ليست علاقة تبعية بل تكاملية، فكل منهما يحتاج إلى الآخر لتحقيق أهداف الدولة. فالإدارة من دون شرعية سياسية تصبح تقنية باردة، والسياسة من دون إدارة فعالة تتحول إلى شعارات غير قابلة للتنفيذ.
توُعدّ العلاقة بين العملية السياسية والإدارة العامة من أكثر الإشكاليات تعقيدًا في بنية الدولة الحديثة، إذ تتقاطع عندها حدود الفكر والممارسة، والمبدأ والإجراء، والتصوّر والتنفيذ. فالعملية السياسية تمثل المجال الذي تُصاغ فيه الرؤى والقرارات العامة، بينما تشكل الإدارة العامة الأداة التي تُترجم من خلالها هذه الرؤى إلى سياسات واقعية. غير أنّ المسافة القائمة بين هذين المستويين – مستوى التنظير ومستوى الفعل – تطرح إشكالية التفعيل التي تتجلى في قدرة المؤسسات على تحويل الإرادة السياسية إلى مخرجات ملموسة دون أن تفقد معناها أو قيمتها الأصلية.
فمن المنظور الفلسفي، تُفهم هذه الإشكالية بوصفها جدلًا بين الفكر والواقع، إذ لا يمكن للسياسة أن تُمارس دون أن تكون مؤطرة بفهم فلسفي لطبيعة السلطة، ولا يمكن للإدارة أن تُفهم بمعزل عن تصور فلسفي للإنسان والواجب والمسؤولية. فالتفعيل هنا لا يعني مجرّد التطبيق الميكانيكي للنظرية، بل هو اختبار لمدى انسجام العقل المجرّد مع الواقع المتحوّل. ومن ثمّ يصبح السؤال الفلسفي الجوهري: كيف يمكن للنظرية أن تظلّ فاعلة وهي تواجه تعدّد المصالح، وضغوط الواقع، ونسبيّة القيم داخل النسق السياسي والإداري؟ إنّه سؤال عن العلاقة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن، وعن الشروط التي تجعل من الفعل العملي تجسيدًا للمعنى لا انحرافًا عنه.
أما المنظور الأكاديمي فيتناول المسألة بمنهج وصفي-تحليلي يستند إلى أدوات البحث العلمي في تفسير العلاقة بين النظام السياسي والبنية الإدارية. فالعملية السياسية تُدرس هنا بوصفها سلسلة من القرارات والتفاعلات المؤسسية التي تُنتج السياسة العامة، بينما تُعدّ الإدارة العامة النظام التنفيذي الذي يحوّل تلك القرارات إلى نتائج عملية. ويظهر “التفعيل” كمتغير تابع يتأثر بمتغيرات أخرى مثل: نوع النظام السياسي، درجة مركزية القرار، كفاءة الأجهزة الإدارية، ومدى تكامل الأطر التشريعية والتنظيمية. ومن ثمّ يصبح جوهر الإشكالية هو الفجوة بين الإرادة السياسية والقدرة الإدارية، أو ما يمكن تسميته “العجز البنيوي عن الترجمة المؤسسية للنظرية السياسية”.
إنّ الجمع بين المنظورين الفلسفي والأكاديمي يتيح رؤية أكثر شمولًا وعمقًا. فالفكر الفلسفي يمنح التحليل بُعده التأويلي والمعنوي، بينما يمدّه المنهج الأكاديمي بآلياته التجريبية والقياسية. وبذلك، تتحول إشكالية التفعيل إلى مجالٍ خصبٍ للبحث في كيفية إعادة بناء التفاعل بين النظرية والممارسة داخل الدولة الحديثة، بحيث لا تكون النظرية مجرد شعارٍ مثالي، ولا الممارسة مجرّد إجراءٍ منفصلٍ عن الفكر.
وهنا تتبلور فرضية أساسية مفادها أن إصلاح العلاقة بين العملية السياسية والإدارة العامة لا يتحقق إلا بتكامل البنية الفكرية مع البنية المؤسسية، أي حين يصبح الفعل الإداري تجسيدًا للوعي السياسي، ويغدو القرار السياسي إدراكًا لمحدّدات الفعل الإداري.
خلاصة الإطار النظري:
يتضح من خلال هذا الفصل أن فعالية الإدارة العامة في البيئة السياسية لا تتوقف على كفاءتها التنظيمية فقط، بل على طبيعة التفاعل البنيوي مع النظام السياسي. فكلما اتسمت العلاقة بالتكامل المنظم، تحققت الفاعلية والاستقرار، بينما يؤدي التداخل غير المنضبط إلى فوضى وظيفية تُضعف الأداء العام وتُشوّه صورة الدولة.
وعليه، فإن معالجة اختلالات الإدارة العامة في ليبيا تتطلب إعادة هندسة العلاقة بين المستويين الإداري والسياسي ضمن إطار من الحوكمة الرشيدة التي توازن بين الكفاءة والشرعية.
تؤكد الدراسة على أن إشكالية التفعيل بين النظرية والممارسة ليست مجرد مشكلة إجرائية، بل بنيوية وفكرية في آنٍ واحد.
فحين تختل العلاقة بين السياسة والإدارة، تتولد مظاهر العجز الإداري والتنافر المؤسسي وفقدان الفاعلية. ومن ثمّ، فإن تجاوز هذه الإشكالية يقتضي بناء وعي فلسفي بالوظيفة العمومية وإصلاحًا مؤسسيًا يعيد ضبط العلاقة بين القرار والتنفيذ وفق منطق تكاملي لا صراعي.
الفصل الثاني: التحليل البنيوي للعلاقة بين السياسة والإدارة في السياق الليبي بعد 2011م
(دراسة تفسيرية في أثر الاستقرار السياسي على تفعيل الإدارة العامة)
تُعدّ ليبيا بعد عام 2011م نموذجًا مركّبًا لفهم العلاقة بين السياسة والإدارة العامة، حيث شهدت الدولة انتقالًا حادًا من نمط الحكم المركزي الصارم يفضل المحسوبية، إلى فضاءٍ تعدّدي هشّ تداخلت فيه مراكز القرار وتفكّكت فيه البنى المؤسسية. هذا التحول لم يكن مجرد انتقال سياسي، بل مثّل انزياحًا عميقًا في بنية السلطة وطبيعة الإدارة العامة، بما أفرز أزمة في الفعالية التنظيمية وأعاق مسار الإصلاح الإداري.
من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل التداخل البنيوي بين المجالين السياسي والإداري في الحالة الليبية، انطلاقًا من فرضية أن درجة الاستقرار السياسي تمثّل متغيرًا مستقلاً، بينما تفعيل الإدارة العامة يمثّل المتغير التابع، في حين تتوسط العلاقة بينهما مجموعة من المتغيرات الوسيطة مثل الشرعية، والثقة المؤسسية، والكفاءة التنظيمية.
2-5 السياق البنيوي للتحول السياسي والإداري بعد 2011م
أدى سقوط النظام السابق إلى فراغٍ مؤسسي واسع، فانتقلت الدولة من وحدة السلطة إلى تشتت مراكزها، ومن البيروقراطية الممركزة إلى شبكات سلطة متداخلة تجمع بين الطابعين السياسي والعرفي.
تغيّر المنطق الإداري من الالتزام العمودي بالتوجيهات العليا إلى منطق الترضية والتوازن بين القوى المحلية. وأصبحت المؤسسات العامة رهينة لشرعية مؤقتة، تتأرجح بين القرار السياسي وموازين القوى الاجتماعية.
وقد أفرز هذا الواقع ظاهرة “تسييس الإدارة” بحيث غابت الحدود بين منطق الكفاءة ومنطق الولاء، وبين المصلحة العامة والمصلحة الفئوية. فالإدارة لم تعد أداة تنفيذية للسياسات العامة، بل تحوّلت إلى ساحة لتجاذبات القوى وتوزيع النفوذ.
يمكن توصيف علاقة التداخل البنيوي بين المجالين السياسة والإدارة العامة في ليبيا ضمن ثلاثة أنماط متداخلة:
2-5-1 النمط التوجيهي السياسي (Dominance Model):
حيث تفرض القوى السياسية رؤيتها على الجهاز الإداري، بما يجعل القرارات الإدارية انعكاسًا للخيارات السياسية الآنية، لا للخطط المؤسسية. ويظهر هذا النمط بوضوح في فترات تشكيل الحكومات المتكررة، إذ تتبدّل الإدارات تبعًا للتحالفات السياسية، مما يفقد الجهاز الإداري استقراره واستقلاليته.
2-5-2 النمط التفاعلي (Interactive Model):
وهو شكل من أشكال التفاوض بين البيروقراطية والقوى السياسية، يظهر في مؤسسات التمويل أو البلديات، حيث تتقاطع المصالح ويتم إنتاج قرارات توافقية أكثر منها مهنية.
في هذا السياق، تلعب الكفاءة الإدارية دورًا محدودًا مقابل تأثير الولاءات والانتماءات الجهوية.
2-5-3 النمط التوازني أو الإصلاحي (Balanced Model):
وهو النموذج المنشود الذي تسعى إليه السياسات الإصلاحية، حيث تُعاد هيكلة العلاقة على أساس الفصل الوظيفي والتكامل البنيوي بين السياسة كإطار توجيهي، والإدارة كأداة تنفيذية مهنية.
إلا أن هذا النمط لم يتحقق بعد في ليبيا بسبب ضعف الاستقرار السياسي، وغياب منظومة المساءلة الإدارية الموحدة.
2-5-4 تفسير العلاقة بين الاستقرار السياسي وتفعيل الإدارة العامة
يعتمد تحليل العلاقة التفسيرية بين المتغيرين على منطق الارتباط السببي الافتراضي. فكلما زاد الاستقرار السياسي (بوصفه متغيرًا مستقلاً)، تزداد قدرة الإدارة العامة على التفعيل والإنجاز (المتغير التابع). ويُفترض أن العلاقة بينهما علاقة إيجابية مباشرة، تتأثر بقوة المتغير الوسيط المتمثل في الشرعية المؤسسية والثقة العامة. ويمكن توضيح العلاقة عبر المعادلة المفاهيمية التالية:
الاستقرار السياسي (X) → الشرعية والثقة (Z) → تفعيل الإدارة العامة (Y)
وفقًا لهذا التصور، تُعدّ الشرعية الإدارية بمثابة قناة انتقال الأثر من السياسة إلى الإدارة، بحيث لا يتحقق الأداء الإداري الفعّال إلا بوجود بيئة سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
2-5-5 المعوّقات البنيوية لتفعيل الإدارة العامة في ليبيا
تعدد مراكز السلطة: أدى الانقسام السياسي إلى ازدواجية في القرار الإداري، ما نتج عنه تداخل في الصلاحيات وضعف في الرقابة المركزية. ضعف المنظومة القانونية والتنظيمية:
فالقوانين الإدارية ما بعد 2011م لم تُحدّث بما يتناسب مع التحولات الجديدة، مما خلق فجوة بين النصوص والواقع.
وذلك لغياب الكادر الإداري المهني ونتيجة التعيينات السياسية أو الجهوية، أصبح الجهاز الإداري يعاني من نقص في الكفاءة والاستمرارية مع تراجع الثقة في المؤسسات حيث فقد المواطن الثقة في قدرة الإدارة العامة على تحقيق العدالة وتقديم الخدمات، مما قلّل من شرعيتها الفعلية.
2-6 النتائج التفسيرية للتحليل البنيوي
من خلال القراءة البنيوية يمكن استخلاص النتائج الآتية:
- أن العلاقة بين السياسة والإدارة في ليبيا علاقة تداخل لا تكامل، تتأرجح بين السيطرة والتبعية.
- أن الاستقرار السياسي هو المحدّد الرئيس لفاعلية الإدارة العامة، إذ يرتبط بمدى وضوح السلطة وشرعية القرار.
- أن تحقيق التفعيل الإداري يتطلب إعادة بناء الثقة المؤسسية كمتغير وسـيط جوهري بين المجالين.
- أن غياب التنسيق البنيوي بين الأجهزة المركزية والمحلية يُبقي الإدارة رهينة المزاج السياسي المتغير.
2-7 تشخيص إشكالية التفعيل في السياق الليبي (ربط نظري ـ تطبيقي)
أ. تشرذم الشرعية والمؤسسات
وجود هيئات ومراكز قوة متنافسة (المجلس النيابي الشرقي، هياكل في الغرب، ولجان محلية متعددة) وهو ما ينص عليه عدد من مواد الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015م، المجلس الرئاسي، برئاسة حكومة الوفاق الوطني بالإضافة إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة وهو ما يوضحه الجدول رقم (1) يعني أن المدخلات السياسية لا تأتي من إطار واحد موحّد، وبالتالي يضعف التوجيه الواضح للهيكل الإداري المركزي. هذا يخلق غموضًا في المسؤولية ويفتح مجالًا لتدخلات غير رسمية (ميليشيات، شبكات إقليمية).
أن أبرز مظاهر عدم الاستقرار تتمثل في تعدد السلطات التنفيذية وتضارب الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية. ضعف الهيكل التنظيمي وقلل من الاستقرار السياسي وأثر على الأداء الإداري فكلما ارتفع مستوى الاستقرار السياسي، زادت كفاءة الجهاز الإداري في تنفيذ السياسات العامة، وارتفعت معه درجة التنسيق المؤسسي ما يعزز العلاقة الموجبة بين السياسة والإدارة. في حين التسييس المفرط للوظائف الإدارية يؤدي إلى تراجع مستوى تفعيل الإدارة العامة.
ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مصحوبة بتقلبات في مراكز القرار. وذلك مرده ضعف التنسيق المؤسسي وتداخل الاختصاصات وذلك لغياب الفصل الوظيفي بين القرار السياسي والقرار الإداري وتسييس الوظيفة العامة وتحويل الجهاز الإداري إلى أداة لخدمة التحالفات السياسية بدلاً من أن يكون جهازًا محايدًا لتنفيذ السياسات العامة.
حيث غالبًا ما تُمارس الصلاحيات نفسها من أكثر من جهة، ما يخلق ازدواجية في القرار، ويضعف مبدأ المساءلة والمسؤولية الوظيفية. فرغم التغيير في عام 2021م، الذي اتفقت فيه قادة ليبيا (برلمان الشرق، المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) على تشكيل حكومة موحّدة تُشرف على إجراء الانتخابات وتوحيد المواقف السيادية. تم إنشاء لجنة فنية للتعامل مع القضايا العالقة، والتوافق على ضرورة توحيد الحكومة لتسهيل الانتقال السياسي أثبتت كما يوضحه الجدول رقم (2) بين ربط الواقع والمأمول.
الجدول رقم (1) (النظرية والممارسة)
عنصر | ما تقتضيه النظرية | ما تحقق عمليًا في ليبيا | الفجوات |
| الشرعية السياسية | نظرية التفعيل تُشير إلى أن وجود سلطة سياسية موحّدة وذات اعتراف داخلي وخارجي يُسهّل توجيه الأطر الإدارية. | حكومة موحدة شكلت بالاتفاق السياسي، وهي خطوة مهمة نحو توحيد المرجعيات. | لا تزال المنافسات على النفوذ موجودة بين شرق وغرب، وهناك مقاومة من بعض الأطراف لاستسلام السلط المتنازع عليها بالكامل. |
| الإدارة المؤسسية | من المطلوب أن تتبنّى هذه الحكومة هياكل تنفيذية واضحة تُرجِع مؤسسات الدولة للعمل الموّحِد (مصرف مركزي واحد، ميزانية موحّدة، سلطات تنفيذية لا تتداخل). | بعض الاتفاقات حصلت، لكن التنفيذ ما زال معوقًا بسبب الانقسامات الأمنية، التداخلات الميليشياوية، وضعف الآليات التنفيذية المشتركة. | غياب السيطرة الحقيقية على الميليشيات، وتأخّر سنّ القوانين التنظيمية أو تنفيذها. |
| الحيز الواقعي والتحديات | يجب أن تُدرك النظرية التفعيل يتطلب موارد مالية مستقرة، دعم شعبي، ومناخ أمني يسمح بالتطبيق. | وجود مقاومة مالية (توزيع الموارد)، تهديدات أمنية، عدم توافق كامل على مراكز القوى. | ضعف الثقة بين الأطراف، العوائق اللوجستية، غياب مؤسسات مؤيدة على الأرض في بعض المناطق. |
المصدر : إعداد الباحث
ب. التركيبة المركزية للجهاز الإداري
إذ أدت المركزية المفرطة إلى إضعاف المبادرة المحلية، وتقييد قدرة الإدارات الفرعية على التكيف مع احتياجات المواطنين أو المستجدات الميدانية. إذ تتغلغل البنية القيمية والثقافة التنظيمية القبلية والولاءات الشخصية داخل البنية الإدارية، مما جعل الكفاءة تتراجع أمام معايير الولاء والانتماء. فالبيئة السياسية المتقلبة إدة إلى غياب الاستقرار السياسي المستدام وبالتالي إلى تغيّر مستمر في الأولويات والسياسات العامة، وهو ما يُفقد الإدارة الاتساق والتراكمية في الأداء.
ومن ثمّ، فإن أي إصلاح إداري حقيقي يجب أن يتعامل مع هذه العوامل باعتبارها بنية متشابكة وليست مشكلات جزئية يمكن حلها بمعزل عن بعضها. وهو ما يشير إلى مستوى متوسط من الفاعلية. وتمثلت أبرز مظاهر الضعف في غياب نظم تقييم الأداء، وتأخر تنفيذ القرارات، وتداخل المسؤوليات الوظيفية. وهذا ما يوضحه الجدول رقم (2):
جدول رقم (2) مقارنة بنيوية معيارية بين ليبيا ونموذج دولة مركزية فعّالة
معيار | نموذج دولة مركزية متجانس | الحالة الليبية (ملاحظات) |
| شرعية مؤسسية | توحّد مؤسسات تشريعية وتنفيذية واحدة | تعدد مؤسسات متنافسة وشرعيات متقاطعة. |
| إدارة الموارد المالية | ميزانية موحّدة ونظام مالي شفاف | صراع على المصرف المركزي وعائدات النفط؛ أثر سلبي على التنفيذ. |
| قدرة إدارية | جهاز إداري قائم على قواعد ومسارات زمنية واضحة | تآكل الكفاءات وهشاشة الأجهزة نتيجة النزاع وعدم الاستقرار. |
| شبكات الحوكمة | تكامل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني تحت إطار تنظيمي | تعدّد شبكات موازية يعرقل التنسيق والرقابة |
المصدر : إعداد الباحث
ج. صراع على الموارد والآليات المالية
النزاع على إدارة الإيرادات النفطية والتحكّم في المصرف المركزي أثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تمويل البرامج والالتزام بالميزانية الموحدة، فالتنفيذ يتوقّف لأن الموارد إما مُجزّأة أو مُحتكَرَة. الجدول (3) واضح على فجوة بين الإرادة السياسية (سياسات) والقدرة الإدارية (تمويل وتنفيذ). وذلك بوصف الحالة الصراع على إدارة المصرف المركزي بين الجهات المتنازعة في الشرق والغرب: أزمة نقدية ونقص في السيولة، تأثّرت الرواتب والدفع للمؤسسات الحكومية، وصعوبة الحصول على النقد. جهود لطباعة نقود جديدة وتحسين البنى التحتية المصرفية، وتجربة منصة للطلبات الاتفاقية للعملة الأجنبية.
تحليل تفاعلي الجدول رقم (3)
عنصر | ما تقتضيه النظرية | الواقع الليبي
| الفجوة
| |||||||
| الموارد المالية والإدارية |
| يتم طباعة نقود جديدة، تُدار المنصات للعملات الأجنبية، ومع ذلك التوزيع لا يتم بالتساوي، والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الموحدة تعاني.
| ضعف الرقابة، تأخّر صرف الرواتب، تخوف من التضخم، سوء توزيع السيولة.
| |||||||
| الإرادة السياسية واستقلالية الإدارة |
| في ليبيا، البنك المركزي يتعرض لضغوط من جهات سياسية/عسكرية، والحوارات حول من يتولّى منصب الحاكم أو الإدارة تحوّلت إلى ساحة نزاع.
| التدخّل السياسي في تعيين القيادات يعوق الاستقرار، يقلل من الثقة.
| |||||||
| البنية المؤسسية والقدرات |
|
|
|
المصدر : إعداد الباحث
د. ضعف البنية الإدارية والكفاءات
الجهاز الإداري الليبي يعاني من إرث تاريخي لنظام مركزي سابقًا وسنوات نزاع حدّت من قدرته على الإصلاح المؤسسي وبناء كفاءات تنفيذية مستقرة. النماذج واللوائح موجودة أحيانًا، لكن القدرة المؤسسية على التطبيق والمساءلة ضعيفة.
هـ. دور الفاعلين غير الحكوميين والحوكمة الشبكية
في غياب دولة مركزية قوية، ظهرت شبكات حوكمة بديلة (فصائل، مجتمع مدني، جهات مانحة دولية)، ما يفرض تعدد قنوات التنفيذ ويعقّد ضبط الجودة والحوكمة.
2-8 سياسات وتدخلات مستخلصة من التحليل (توصيات عملية ومُحكَمة)
أ. توحيد إطار الشرعية والسياسات (الخطوة السياسية)
ضرورة التوافق على إطار مؤسّسي مؤقّت (آلية توحيد الإدارة المالية وقرار دستوري/توافقي لإدارة الموارد الوطنية) يقلّل التنافس على المدخلات ويُعطي توجيهاً واضحًا للمنظومة الإدارية. (تدخل سياسي أولي لإعادة بناء قناة التوجيه).
ب. استعادة السيطرة على الموارد المالية وشفافيتها (الخطوة الاقتصادية ـ الإجرائية)
توحيد آليات إدارة عائدات النفط وإطلاق خطة مرحلية للشفافية المالية (حسابات موحّدة، تقارير دورية، آليات رقابة دولية/محلية متناغمة) لتمكين التنفيذ من موارد مستقرة.
ج. بناء القدرات المؤسسية تدريجيًا (الخطوة الإدارية)
برامج إعادة هيكلة الجهاز الإداري: تدريب، قوانين جهازية واضحة، حماية الوظيفة العامة من الاعتداءات السياسية والتهديدات الأمنية، ووضع آليات تقييم أداء ومساءلة. هذه الخطوة تقلّص فجوة التنفيذ وتزيد القدرة على التفعيل.
د. تكامل الحوكمة الشبكية (الخطوة التشارُكية)
تصميم آليات شراكة رسمية بين الدولة والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني والمانحين بحيث تُحدَّد الأدوار والآليات؛ لا إقصاء للشركاء غير الحكوميين لكن ضمن إطار شفاف يخضع للمساءلة.
هـ. آليات متابعة وقياس التفعيل (الخطوة المنهجية)
تبنّي مؤشرات أداء وطنية وبرامج مراقبة تطبيقية مشتركة (لجان متابعة مستقلة وطنية/محلية)، إضافة إلى استخدام تقييمات دورية مستقلة لقياس تقلّص فجوة التنفيذ. هذا يربط الطابع الأكاديمي (القياس والتحليل) بالطابع الفلسفي (مساءلة المعنى والهدف).
خلاصات فلسفية تطبيقية (إعادة ربط الفكر والفعل)
من منظور فلسفي، أي إصلاح يُبنى دون معالجة شرعية السلطة ومعنى العمل العام سيكون هشًا؛ ومن منظور علمي، أي تكنولوجيا إصلاح (قوانين، برامج تدريب، مؤشرات) دون قاعدة سياسية موحّدة ستفشل في التفعيل. الحلّ إذًا تكاملي: وعي سياسي يعيد إنتاج معنى الوظيفة العامة + أدوات تنفيذية تقوّي القدرة المؤسسية.
الحالة الليبية تُجسّد صيغةً صعبة من إشكالية التفعيل: تراكمٍ بنيوي (إرث النظام السابق)، انقسامٌ سياسي، وصراعٌ على الموارد أدّيا إلى ضعفٍ مؤسسي واضح. لذا، أي استراتيجية لردم الفجوة بين النظرية والممارسة يجب أن تكون متعددة المسارات: سياسية (توحيد)، مالية (شفافية)، مؤسسية (قدرات وحماية)، ومجتمعية (حوكمة شاملة). ربط هذه المسارات عبر مؤشرات قابلة للقياس وآليات متابعة يجعل التفعيل ممكنًا تدريجيًا ومستدامًا.
الفصل الثالث: التحليل التفسيري والنموذج المقترح للإصلاح الإداري في السياق الليبي نحو إعادة بناء العلاقة بين السياسة والإدارة العامة
يُعدّ الإصلاح الإداري في ليبيا بعد عام 2011م أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مسار التحول السياسي، إذ لم يكن الإصلاح مجرد عملية تنظيمية داخل الجهاز الحكومي، بل عملية إعادة هندسة للعلاقة بين السياسة والإدارة في ظل بيئة غير مستقرة.
فالإدارة العامة التي تُفترض فيها الحيادية والفعالية، تحوّلت إلى مجالٍ لصراع الشرعيات وتوازنات القوى. ومن ثم، فإن أي إصلاح إداري لا يمكن فصله عن تحقيق حدّ أدنى من الاستقرار السياسي والمؤسسي.
ينطلق هذا الفصل من فرضية أن الإصلاح الإداري في ليبيا يتطلب نموذجًا تفسيريًا تفاعليًا يدمج بين المتغيرات السياسية والإدارية في إطارٍ بنيوي متوازن، بحيث تصبح السياسة محددًا للتوجه العام، بينما تعمل الإدارة كجهازٍ منفذ يتمتع بالاستقلال النسبي والكفاءة المؤسسية.
أولًا: الإطار التفسيري للعلاقة بين المتغيرات
يستند التحليل التفسيري إلى العلاقة السببية بين ثلاثة مستويات من المتغيرات:
المتغير المستقل: الاستقرار السياسي — ويقصد به وضوح مراكز القرار، وحدة الشرعية، واستمرارية السياسات العامة دون انقطاع أو تنازع.
المتغير الوسيط: الكفاءة المؤسسية والشرعية الإدارية — أي مدى قدرة الجهاز الإداري على اكتساب ثقة الفاعلين السياسيين والمجتمع من خلال الأداء المهني والانضباط القانوني.
المتغير التابع: تفعيل الإدارة العامة — ويقصد به قدرة المؤسسات الإدارية على تنفيذ السياسات العامة بفعالية وعدالة واستمرارية.
وتُفترض العلاقة بينهم على النحو التالي:
كلما تحقق الاستقرار السياسي (X)، زادت الشرعية والكفاءة المؤسسية (Z)، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى تفعيل الإدارة العامة (Y).
بعبارة أخرى، فإن الكفاءة المؤسسية تمثّل القناة التي تنتقل من خلالها آثار الاستقرار السياسي إلى الأداء الإداري، وهي العامل الحاسم في نجاح أي عملية إصلاح إداري.
ثانيًا: التحليل التفسيري لواقع الإصلاح الإداري في ليبيا
- الإصلاح في بيئة انقسام سياسي
إنّ وجود حكومتين متوازيتين في فترات معينة، وازدواجية القرار بين الشرق والغرب، خلق حالة من التشتت الإداري وغياب مرجعية موحدة للسياسات العامة. فالإدارة العامة في هذه البيئة لم تستطع أن تؤدي دورها كأداة تنفيذ، بل أصبحت جزءًا من المشهد السياسي ذاته، تتأثر بالتجاذبات وتعيد إنتاجها داخل مؤسسات الدولة.
- غياب الرؤية الاستراتيجية للإصلاح
تعدّ أغلب برامج الإصلاح الإدارية منذ 2012 حتى اليوم جزئية ومؤقتة، تركز على التوظيف وإعادة الهيكلة الشكلية، دون معالجة البنية العميقة التي تربط بين القرار السياسي والإدارة.
فالإصلاح ظل محصورًا في نطاق اللوائح والتنظيمات، دون استثمار حقيقي في الموارد البشرية أو التحول الرقمي أو نظم المتابعة والتقييم.
- ضعف الثقافة المؤسسية
أدى غياب التدريب الإداري المنهجي إلى تراكم سلوكيات غير مهنية، تقوم على ردّ الفعل والولاء لا على الكفاءة.
إن الإصلاح هنا يحتاج إلى تغيير ثقافة السلطة داخل الجهاز الإداري، من ثقافة السيطرة والتبعية إلى ثقافة الخدمة والمساءلة.
ثالثًا: متطلبات بناء نموذج إصلاح إداري فعال
من خلال التحليل البنيوي والتفسيري، يمكن تحديد جملة من المتطلبات الجوهرية لتحقيق إصلاح إداري فعّال في ليبيا:
تحقيق الاستقرار السياسي كشرط سابق للإصلاح:
- إذ لا يمكن بناء جهاز إداري مستقر في بيئة انقسام شرعي أو أمني.
- يتطلب ذلك توحيد الهياكل الحكومية وإعادة ضبط منظومة اتخاذ القرار.
- تعزيز الشرعية الإدارية:
عبر تفعيل آليات الشفافية والمساءلة وتحييد التوظيف السياسي، بحيث يشعر المواطن أن الإدارة العامة تخدمه لا تتحكم به.
- بناء الكفاءة المؤسسية:
من خلال تطوير الكادر البشري، وتفعيل نظم الإدارة الحديثة القائمة على الأداء والنتائج، وتبني التحول الرقمي كركيزة للإصلاح.
- الفصل الوظيفي والتكامل البنيوي بين السياسة والإدارة:
بحيث تُمارس السلطة السياسية دورها في التخطيط والتوجيه العام، بينما تظل الإدارة مسؤولة عن التنفيذ وفق معايير مهنية واضحة.
- إرساء اللامركزية المتدرجة:
بما يحقق التوازن بين السلطة المركزية والمحلية، ويمنح البلديات والإدارات الفرعية استقلالًا إداريًا ضمن الإطار الوطني.
رابعًا: النموذج التفسيري المقترح للإصلاح الإداري في ليبيا
يمكن تلخيص النموذج المقترح في ثلاثة مستويات مترابطة تمثل دورة الإصلاح الإداري:
- المستوى السياسي (المدخل):
يُعنى بتعزيز الاستقرار والشرعية السياسية من خلال توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الازدواج في مراكز القرار، وتحديد العلاقة بين السلطات.
- المستوى المؤسسي (الوسيط):
يتمثل في بناء الكفاءة الإدارية عبر تطوير الموارد البشرية، وتحديث البنية القانونية، وتحسين أنظمة العمل، بحيث يصبح الجهاز الإداري أكثر مهنية واستقلالًا.
- المستوى التنفيذي (المخرج):
ويظهر في تفعيل الأداء الإداري وتحقيق جودة الخدمات، مما ينعكس على ثقة المواطنين ويغذي بدوره الاستقرار السياسي في حلقة إيجابية من التفاعل المتبادل.
ويمكن تمثيل العلاقة المفاهيمية على النحو التالي:
الاستقرار السياسي (X) → الكفاءة المؤسسية والشرعية الإدارية (Z) → تفعيل الإدارة العامة وتحسين الأداء (Y)
إنّ هذا النموذج يُبرز الطابع الديناميكي التبادلي بين السياسة والإدارة، حيث لا يمكن لأيٍّ منهما أن يحقق فاعلية دون الآخر، وهو ما يجعل الإصلاح الإداري مشروعًا سياسيًا بامتياز، لكنه يعتمد على أدوات مهنية وإدارية دقيقة.
الاستنتاجات
تكشف أزمة الإدارة في ليبيا عن خللٍ بنيوي يتجاوز ضعف الهياكل أو غياب الكفاءات؛ إذ تتجلى الأزمة الأساسية في اختلال توازن السلطة وتداخل المجالين السياسي والإداري، مما حوّل مؤسسات الدولة من أدوات للتنمية إلى رهائن للتجاذبات السياسية.
أحد أبرز أبعاد الأزمة يتمثل في فقدان الجهاز الإداري لحياده الوظيفي؛ حيث لم تعد الإدارة أداة خدمة عامة، بل أصبحت ميدانًا للصراع السياسي والاقتصادي، يسعى من خلاله كل طرف إلى ترسيخ نفوذه عبر تعيين الموالين في المفاصل الإدارية الحساسة لضمان السيطرة على القرار التنفيذي. وقد أدى هذا التسييس إلى إضعاف الثقة بالإدارة العامة، وإلى عجزها عن تحقيق الفاعلية المؤسسية، بل وأصبحت منتجة للأزمة ذاتها في كل دورة سياسية جديدة.
وفي ظل هذا السياق، يصبح الحديث عن استقلال القضاء تحديًا مضاعفًا، إذ تُدار المؤسسات في بيئة لا تزال تفتقر إلى مفهوم الإدارة المستقلة والمساءلة الموضوعية. ولا يمكن معالجة أزمة المحكمة الدستورية –على سبيل المثال– بمعزل عن إصلاح الإدارة العامة، لأن إصلاح القضاء يتطلب جهازًا إداريًا مهنيًا محايدًا قادرًا على دعم استقلالية القرار القضائي.
ويبرز هنا ضرورة فك الارتباط بين الإدارة والولاء السياسي، وتأسيس نظام وظيفي يقوم على الكفاءة والشفافية والعدالة، بما يضمن استقلال القرار الإداري مع وجود رقابة موضوعية. كما يُعد اعتماد تحليل الأثر المؤسسي قبل أي تعديل تشريعي خطوة أساسية لتقييم نتائج إنشاء أو إصلاح المؤسسات (مثل المحكمة الدستورية أو هيئة مكافحة الفساد)، وذلك لتفادي تحوّل الإصلاح ذاته إلى مصدر جديد للأزمة.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والمساءلة، وليس من خلال تغيير القوانين فقط. فالمطلوب اليوم بيئة سياسية مستقرة تفصل القرار الإداري عن المزاج السياسي، وتمنح الإدارة العامة استقلالها لتعمل وفق معايير الكفاءة والعدالة.
وعند تحقق ذلك، يمكن الحديث عن إدارة وطنية قادرة على البناء بدلًا من التبرير، وعلى تحويل السلطة من وسيلة نفوذ إلى أداة خدمة عامة، بما يعيد للدولة هيبتها وللمواطن ثقته في مؤسساته.
التوصيات
استنادًا إلى نتائج التحليل والاستنتاجات المتوصّل إليها، يمكن صياغة مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز فعالية الإدارة العامة في ليبيا وتحقيق التكامل بين البنية السياسية والمؤسسية، وذلك على النحو الآتي:
- تعزيز الفصل الوظيفي بين السياسة والإدارة من خلال تحديد واضح لاختصاصات كلٍّ من السلطات التنفيذية والإدارية، بما يضمن استقلال الجهاز الإداري عن التقلبات السياسية ويعزّز مبدأ الحياد المهني.
- إعادة بناء المنظومة التشريعية والإجرائية المنظمة للعمل الإداري، لضمان وضوح المسؤوليات والمساءلة، والحدّ من التداخل بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية.
- ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في عمل المؤسسات العامة، عبر تبنّي معايير الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، وسيادة القانون كإطار مرجعي للإصلاح المؤسسي.
- بناء القدرات الإدارية والبشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تستهدف تطوير الكفاءات القيادية، وتعزيز ثقافة الأداء القائم على النتائج لا الولاءات.
- إصلاح نظام الخدمة المدنية بما يضمن العدالة في التوظيف والترقية، ويربط بين الأداء والمكافأة، بما يعيد الثقة في الوظيفة العامة كمجال خدمة لا نفوذ.
- إرساء بيئة سياسية مستقرة تُتيح للإدارة العمل ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى، بعيدة عن الصراعات الحزبية والتجاذبات الجهوية.
- تعزيز التنسيق بين المؤسسات المركزية والمحلية لتحقيق توازن في توزيع السلطة والموارد، وضمان مشاركة فعّالة للبلديات في التخطيط والتنفيذ.
- إطلاق مشروع وطني للإصلاح الإداري يُبنى على أسس تشاركية، ويجمع بين الإرادة السياسية والخبرة الفنية والمجتمعية، لضمان استدامة التحول الإداري والمؤسسي.
قائمة المراجع
- أيمن أمين السيد الباجوري، البعد القانوني في الإدارة العامة: دراسة في حالة العلم، مجلة دراسات، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، أبريل 2021م، ص ص 179-182.
- أيمن عوده المعاني، الإدارة العامة الحديثة، دار وائل للنشر، عمّان: الأردن، 2010م، ص11.
- حسن توفيق، الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م، ص26.
- خالد الشويرخ، مفهوم الإدارة، مكتبة العلوم الإنسانية، المسيلة–الجزائر، 2010م، ص3.
- عبداللطيف قطيش، الإدارة العامة من النظرية إلى التطبيق، بيروت–لبنان، 2013م، ص32.
- عادل حسن، مقدمة في علم الإدارة، جامعة الإسكندرية، مؤسسة الشباب الجامعي، ص10-11.
- المير مسعودة، التجربة البيروقراطية في الجزائر: الواقع والتقييم، وزارة التربية والتعليم الجزائر، المكتبة المركزية، 2023م، ص33-38.
- محمد سعيد عبدالفتاح ود، محمد فريد الصحن، الإدارة العامة والمبادئ والتطبيق، الدار الجامعية، 1991م، ص51.
- مصطفى عبدالله خشيم، علم السياسة المعاصر، دار الرواد، طرابلس، 2022م، ص318.
- مصطفى عبدالله خشيم، علم السياسة المعاصر، دار الرواد، طرابلس، 2022م، ص88.
[1] عادل حسن، مقدمة في علم الإدارة، جامعة الإسكندرية، مؤسسة الشباب الجامعي، ص10-11.
[2] خالد الشويرخ، مفهوم الإدارة، مكتبة العلوم الإنسانية، المسيلة الجزائر،2010م، ص3.
[3] أيمن أمين السيد الباجوري، البعد القانوني في الإدارة العامة: دراسة في حالة العلم، مجلة دراسات، المجلد الثاني والعشرون العدد الثاني، أبريل 2021م،
ص ص 179-182.
[4]– أيمن عوده المعاني، الإدارة العم الحديثة، (دار وائل للنشر، عمان: الاردن) ص11 سنة النشر 2010م.
[5]– مصطفي عبدالله خشيم، علم السياسة المعاصر، (دار الرواد- طرابلس)، ص318 – سنة النشر 2022م.
[6] حسن توفيق، الإدارة العامة، (القاهرة)، دار النهضة العربية ص 26. سنة النشر 1972م.
[7]– عبداللطيف قطيش، الإدارة العامة من النظرية إلى التطبيق، (بيروت- لبنان) ص32- سنة النشر2013م.
[8]– مصطفي عبدالله خشيم، علم السياسية المعاصر،( دار الرواد: طرابلس)، ص 88، سنة النشر 2022م.
[9] المير مسعودة، التجربة البيروقراطية في الجزائر الواقع والتقييم، وزارة التربية والتعليم الجزائر، المكتبة المركزية ، 2023م، ص 33-38.
[10]– محمد سعيد عبدالفتاح ود، محمد فريد الصحن، الإدارة العامة والمبادئ والتطبيق،(الدار الجامعية) ص51، سنة النشر 1991م.