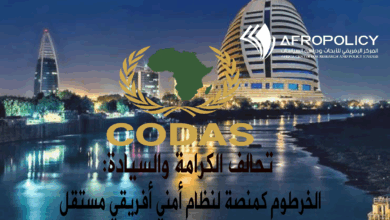مقدمة:
علي الرغم من الجهود المستمرة للإصلاح المؤسسي بهدف معالجة الاختناقات المزمنة في إدارة الموارد الطبيعية، لا تزال التعددية القانونية مشكلة تُعقّد هذه المساعي وتحدّ من فعاليتها في أفريقيا. يظهر هذا التحدي بوضوح في دول ما بعد الاستقلال مثل غانا، حيث اكتسبت المؤسسات العرفية خصائص الدولة وأصبحت شريكًا رئيسيًا في إدارة موارد الأراضي. ومع التوجه نحو أنظمة رقمية لحوكمة الأراضي، تبرز عقبات معقدة في السياقات التي تمتلك فيها المؤسسات العرفية للاراضي نفوذًا قويًا .تشمل هذه العقبات حدود الأراضي الغامضة، والتناقضات حول حقوق الملكية، وسجلات التوطين العائلية، إلى جانب اعتماد الهوية المحلية على الاعتراف من قِبَل المؤسسات العرفية. يركز هذه المقال على دراسة النزاعات المتعلقة بالأراضي، والتنافس بين الروايات والمطالبات المرتبطة بها والتي يبديها أفراد المجتمع حمايةً لمصالحهم في مواجهة نزع الملكية أو نقلها لصالح شركة تعدين في منطقتي أهافو-نورث وبريستيا في غانا. تُعرف هذه المناطق بكثافة تعدين الذهب وسجلّهما الطويل في الأنشطة الاستخراجية، وتواجه تنافسًا عميق الجذور بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق إدارة مستدامة لموارد الأراضي. تشير الدراسة بوضوح إلى أن الرقمنة ليست الحل النهائي للتحديات المستمرة في حوكمة الأراضي، ما لم يتم التعامل بشكل فعّال مع التوترات القائمة بين المؤسسات الرسمية والعرفية المتعايشة في هذا السياق.
المحور الأول: رقمنة الأراضي: مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل عملية إدارة الأراضي إلى نموذج رقمي شامل
تُعد رقمنة الأراضي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحويل عمليات إدارة وتسجيل الأراضي من النظم الورقية التقليدية إلى أنظمة رقمية متكاملة، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها. هذا التحول يسهم في تعزيز الشفافية والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تسريع عملية توثيق الملكيات وتحديث الخرائط العقارية بشكل يواكب التطورات التكنولوجية. كما توفر الرقمنة قاعدة بيانات موحدة تساعد الحكومات وصناع القرار على التخطيط العمراني المستدام وجذب الاستثمارات.
من جانب آخر، تُسهم هذه المبادرة في تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الأراضي بشكل أسرع وأكثر كفاءة عبر المنصات الإلكترونية، مما يقلل من البيروقراطية ويحد من مخاطر الفساد. كما تدعم الرقمنة التكامل بين مختلف المؤسسات المعنية بإدارة الأراضي مثل السجلات العقارية، البلديات، وهيئات التخطيط العمراني، لتكوين نظام معلوماتي شامل يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تعود مبادرات إصلاح أنظمة الأراضي لتصبح محورًا أساسيًا في سياسات حوكمة الأراضي، لكن هذه المرّة عبر إطار حديث يتمثّل في رقمنة الأراضي. هذا التحول يحظى باهتمام متزايد من المنظّمات الدولية والباحثين، الذين يروْن في الرقمنة حلاً واعدًا لتجاوز التحديات التقليدية لإدارة الأراضي في أفريقيا. تدعم سياسات البنك الدولي هذا التوجّه، من خلال اعتبار رقمنة سجلات الأراضي من العوامل المحورية لتحسين تسجيل الملكية، تعزيز الشفافية، وتسهيل التفاعل بين الأطراف ذات الصلة عبر الاعتماد على الأنظمة الرقمية المتقدمة التي تدعم التحديد الدقيق للحدود وحل النزاعات وتوثيق الحقوق العقارية بالشكل الأمثل .
من خلال دمج سجلات الأراضي مع سجلات مؤسساتية أخرى عبر واجهات رقمية، يصبح من الممكن توثيق الملكية والمصالح الشرعية (بما في ذلك حقوق النساء والأطراف الثالثة) أوتوماتيكيًا، والتحكّم بدقة في عمليات نقل الحقوق أو التحصل على القروض أو تعاملات السوق العقارية .
أما التقنيات المتقدمة مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، فتُشكل قيمة مضافة في هذا السياق، لما تقدّمه من سجلات غير قابلة للتحرّيف، شفافية عالية، ووسائل تجاوز للفساد وسوء الإدارة. إنّ تسجيل الملكيات على البلوك تشين يُسهل التحقق من الهوية والملكية ويقلّص النزاعات العقارية ([1]).
من جهته، أكد ماكيورا أن المستثمرين اليابانيين أصبحوا ينظرون إلى النموذج الزراعي المتكامل في غانا كمعيار ذهبي في المنطقة، مما يعكس ثقتهم المتزايدة في قدرته على التوسع وتحقيق النجاح. وتتضمن خطة “Degas” للأعوام الأربعة المقبلة التركيز على توسيع خدماتها في مجالات مثل تمويل المزارعين، التدريب الزراعي، مراقبة المحاصيل عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تعزيز التعاون في جوانب النقل وتوفير المدخلات وربط المزارعين بالأسواق([2]).
يٌقدر البنك الدولي إلى أن حوالي 70% من سكان العالم يفتقرون إلى سندات ملكية رسمية للأراضي، وهو ما يمثل عقبة أمام التنمية الاقتصادية ويزيد من خطر التعرض لعدم الاستقرار والأمن الاقتصادي، خصوصًا حين تكون الأراضي عرضة لخطر فقدانها بسبب ضغوط السوق. على سبيل المثال، كشفت دراسة أجراها أوبينك وكوان في غانا أن نسبة 76.9% من مُلّاك الأراضي لم يسعوا للحصول على توثيق رسمي أو قانوني لملكيتهم من الدولة، بل اعتمدوا على اتفاقيات محلية مُشهود عليها لتأكيد حقوقهم في الملكية. مع ذلك، يرتبط نجاح التحول نحو الرقمنة بواقع الحوكمة المحلية، والذي يختلف بشكل كبير بين الدول والمناطق. ويرى ليمين وآخرون أن الإدارة الفعالة للأراضي يجب أن ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية: الأشخاص، والوحدات المكانية، والحقوق التي تربط بينهم، وهذه العناصر تتأثر بشكل مباشر بديناميكيات الحوكمة الأوسع نطاقًا([3]).
في غانا، تخضع إدارة الأراضي لنظام مزدوج يجمع بين النظم العرفية والنظم القانونية، حيث تسيطر الأولى على نحو 80٪ من الأراضي مقابل 20٪ تديرها القوانين الرسمية. وتُعد الحيازة العرفية الوسيلة الأكثر شيوعًا لامتلاك الأراضي من قبل الأفراد والشركات والكيانات الخاصة، رغم تداخلها أحيانًا مع مطالبات متعارضة تصدر عن النظام القانوني. وقد وفرت الأعراف العرفية، رغم ما يرافقها من نزاعات، أساسًا للانتماء والاستقرار الاجتماعي لعقود طويلة، مستمدة شرعيتها من تقاليد سبقت نشوء الدولة الحديثة. ورغم جهود الإصلاح في أفريقيا، مثل السياسة الوطنية للأراضي في غانا، ونظام معلومات إدارة الأراضي في رواندا وأوغندا، إلى جانب مبادرات الرقمنة التي ساهمت في تقليص النزاعات جزئيًا، ما زالت مسألة تعدد المطالبات على الملكية قائمة. ففي عام 2002، سُجلت في محاكم أكرا وحدها 15 ألف قضية مرتبطة بالأراضي، وهو ما يعكس استمرار قوة الأسواق غير الرسمية التي تعيق محاولات إضفاء الطابع الرسمي على بعض القطاعات مثل التعدين. كما تظل قضايا النوع الاجتماعي بارزة، حيث تكشف التجارب في رواندا، مثلًا، أن الرقمنة لم تمنع بروز نزاعات متصلة بحقوق الأراضي داخل الأسر متعددة الزوجات التي تفتقر إلى زواج موثق قانونيًا([4]).
المحور الثاني: تأريخ مبادرات حوكمة الأراضي في غانا والنزاعات المستمرة
في غانا، مرّت مبادرات حوكمة الأراضي بمراحل متعددة منذ الحقبة الاستعمارية وحتى الوقت الراهن. فقد بدأت الدولة بمحاولات تنظيم العلاقة بين النظم العرفية والقوانين الرسمية، حيث شكّلت الملكية العرفية للأراضي حجر الأساس لإدارة ما يقارب 80٪ من الأراضي، بينما خضعت النسبة المتبقية لنظم قانونية وضعتها الدولة. ومع مرور الوقت، برزت جهود إصلاحية عبر برامج وطنية مثل “برنامج إدارة الأراضي” (LAP) الذي أطلق في أوائل الألفية الجديدة بدعم من البنك الدولي، بهدف تحسين الشفافية وتبسيط إجراءات التسجيل. هذه الإصلاحات جاءت لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الأمن العقاري، إلا أن التنفيذ ظل يواجه تحديات مرتبطة بضعف التنسيق بين المؤسسات وغياب الثقة المجتمعية في بعض الآليات الرسمية.
ورغم هذه الجهود ما زالت النزاعات حول الأراضي قائمة وتشكل تحديًا رئيسيًا أمام التنمية. يعود ذلك إلى تداخل الصلاحيات بين الزعماء التقليديين والدولة، إلى جانب تضارب حقوق الملكية بين الأفراد والجماعات، مما يؤدي إلى نزاعات قضائية متكررة أو حتى صدامات محلية. كما ساهمت الضغوط الاقتصادية وتزايد الطلب على الأراضي للاستثمار الزراعي والتعدين في تفاقم النزاعات، خاصة في ظل غياب آليات فعّالة لتسوية المنازعات أو تعويض المتضررين. لذلك، تبقى حوكمة الأراضي في غانا مجالًا مفتوحًا للإصلاح المستمر، مع الحاجة لمواءمة النظم التقليدية والقانونية لضمان العدالة والاستقرار([5]).
بُذلت جهود كبيرة لمعالجة نزاعات الأراضي وتعزيز الحوكمة في غانا، ضمن بيئة قانونية مزدوجة تحكمها التشريعات الرسمية والأعراف التقليدية في آن واحد. يعود تاريخ إصلاحات الأراضي إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث شملت مبادرات تشريعية مبكرة مثل قانون تسجيل صكوك الملكية لعام 1883، ومرسوم أراضي التاج لعام 1894، وقوانين الأراضي لعام 1897. غير أنّ هذه الإصلاحات لم تحقق أهدافها بشكل فعّال، بسبب غياب الخرائط الدقيقة وتعدد عمليات التسجيل، ما أدى إلى ظواهر مثل الازدواجية في ملكية الأراضي واستمرار النزاعات.
وبعد استقلال البلاد عام 1957، ألغيت هذه القوانين الاستعمارية واستُبدلت بقانون أراضي الدولة لعام 1962، الذي هدف إلى نقل ملكية الأراضي الإقطاعية إلى الدولة، انسجامًا مع رؤية الرئيس كوامي نكروما الرامية إلى تقليص نفوذ الزعامات التقليدية. إلا أنّ الإطاحة بنكروما أفضت إلى صدور قانون الزعامة لعام 1971، الذي أكد استقلالية المؤسسات التقليدية في إدارة الأراضي، وهو مبدأ جرى تثبيته لاحقًا في دستور 1992. وفي سبعينيات القرن العشرين، جاء قانون الأراضي وحقوق السكان الأصليين لعام 1979 ليعالج قضايا نزع الملكية التاريخية، لكنه لم يأخذ بعين الاعتبار تطور أسواق الأراضي الحديثة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات وتعقيد مشهد الملكية العقارية حتى الوقت الحاضر([6]).
في ثمانينيات القرن الماضي، أصدرت الحكومة قانون تسجيل ملكية الأراضي في إطار برامج التكيف الهيكلي التي ركزت على تعزيز حقوق الملكية، حيث نصّ القانون على إلزامية تسجيل الأراضي لتسهيل توثيق سنداتها. غير أنّ هذه الجهود لم تمنع تراكم أكثر من 16 ألف قضية ملكية غير محلولة نتيجة تعدد المطالبات. وفي محاولة لمعالجة هذه المعضلات، أُقرت السياسة الوطنية للأراضي عام 1999 بهدف تحسين الحوكمة عبر معالجة ضعف الإدارة، وانعدام الأمن في الحيازة، وغياب التوثيق، وكثرة النزاعات التي أرهقت المحاكم.
لتنفيذ هذه السياسة، أُطلق مشروع إدارة الأراضي (LAP) بدعم من البنك الدولي، الذي استهدف تطوير نظام موثوق للمعلومات وإدارة السجلات وتوسيع الوصول إلى البيانات المحدثة، مع الحد من التفاعلات الشخصية للحد من النزاعات. وقد ركزت المرحلة الأولى (2003–2007) على دمج الإدارة العرفية للأراضي بإنشاء أمانات الأراضي العرفية (CLS)، لكن هذه الخطوة وُجهت بانتقادات لكونها مدفوعة بالعرض وواجهت رفضًا من الزعماء التقليديين الذين خشوا فقدان سلطتهم. وفي عام 2008 عُدّل النهج ليصبح مدفوعًا بالطلب، بحيث لا تُنشأ الأمانات إلا بناءً على رغبة الزعماء، مما عزز دورهم في الحوكمة رغم استمرار تفاقم النزاعات.
ومع تصاعد التحديات، قدّمت غانا في عام 2016 نظام معلومات أراضي المؤسسات (GELIS) لتبسيط إدارة الأراضي وأتمتة استرجاع البيانات بغرض تقليل النزاعات، قبل أن يُطور لاحقًا إلى منصة رقمية أكثر شمولًا لإدارة قضايا الملكية. ورغم ما حملته هذه المبادرات من فوائد، لا تزال مشكلات التوثيق المجزأ والاعتماد على الاتفاقات الشفوية – خاصة في النظم العرفية – تُعيق تحقيق الأهداف، إذ تظل نزاعات الأراضي وتعدد المطالبات وبيع الأرض ذاتها مشكلات متكررة. ويؤكد ذلك على الحاجة الملحة لإعادة تقييم الأسس القانونية والأطر المؤسسية التي تحكم الأراضي في غانا، بما يفتح المجال أمام إصلاحات مستقبلية أكثر فعالية واستدامة([7]).
استوعبت غانا مبكرًا أهمية اعتماد نظام هوية شامل كركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث ومتطور. لذا، أطلقت في عام 2008 مشروع الهوية الذكية الذي يعتمد على البيانات البيومترية، حيث تم تزويد كل مواطن برقم تعريف شخصي (PIN). هذا النظام لم يقتصر على كونه مجرد أداة تعريف، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تعزيز الشفافية وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. اليوم، تمكّن الهوية الرقمية المواطن من فتح حسابات مصرفية، تسجيل الشركات، الحصول على التراخيص، التصويت في الانتخابات عبر النظام البيومتري، وربط أنشطته التجارية وسفره ومعابر الحدود بسجله الرسمي. كما أن ربط الهوية الرقمية بالإجراءات المتعلقة بالموانئ وعمليات الاستيراد والتصدير لعب دورًا كبيرًا في تقليل التهريب والاحتيال التجاري، إلى جانب دمج التدفقات المالية والتجارية ضمن الاقتصاد الرسمي. هذه الخطوة ساهمت في تحسين عملية تحصيل الضرائب وتعزيز الرقابة المالية. علاوة على ذلك، مكّنت الدولة من التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما شكّل نقلة نوعية في قدرات الحوكمة مقارنةً بالنهج السابق الذي كان يعتمد على تقديرات غير مكتملة(.([8].
المحور الثالث: روايات متباينة حول ملكية الأراضي وحق استغلالها
عقب إعلان منطقة أهافو الشمالية منطقةً مخصصة للتعدين عام 2017، ثارت موجة من التساؤلات داخل المجتمع المحلي. فقد شكك السكان في شرعية مطالبة الشركة الأجنبية المالكة بحق التعدين، خاصة في ظل عدم خضوع المنطقة لقانون الاستحواذ الإلزامي على الأراضي في غانا، وهو القانون الذي يتيح للحكومة الاستحواذ على الأراضي ضمن الإطار الدستوري لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمع والوطن. وقد شكل غياب هذا الإجراء القانوني الرسمي أحد أبرز مرتكزات اعتراض المجتمع المحلي على مطالبة الشركة.
ورغم أن الامتياز المُمنح لشركة التعدين قوبل في البداية بمقاومة قوية من السكان، بما في ذلك الزعماء التقليديون، فإن خطاب هؤلاء الزعماء اتجه لاحقًا نحو موقف أكثر إيجابية وتنموية بعد جولات مكثفة من المشاورات مع مسؤولي الشركة. وقد أظهرت مقابلات مع أفراد من المجتمعات الخمس المشمولة بالامتياز توحدًا في سرد هذه التطورات، حيث أوضح أحدهم: “لسنا على دراية بكامل التفاصيل، لكن بعد اجتماعات عديدة بين زعمائنا ومسؤولي الشركة، وافق زعماؤنا في النهاية على السماح بعمليات التعدين في المنطقة.”
وفي مقابلة مع أحد الزعماء حول هذا الموقف، وصف المشروع بأنه فرصة ثمينة للمجتمعات المتأثرة في ظل غياب مشاريع تنموية كبرى في المنطقة. وأكد على أن نقص فرص العمل بين الشباب جعل من المشروع منفذًا لتوظيفهم وتحسين أوضاعهم، مشددًا على دور الزعماء التقليديين في دعم رفاه وتقدم مجتمعاتهم، ورؤيتهم للمشروع كمساهمة جوهرية في التنمية المحلية.
ومع ذلك، لم تتركز مخاوف أفراد المجتمع بالدرجة الأولى على الجوانب التنموية للمشروع، بل على ضمان حقوقهم في ملكية الأراضي واستحقاقها، وكيفية التأكد من عودتهم إلى أراضيهم أو حصولهم على تعويض عادل إذا استُخدمت لأغراض التعدين. وأقر كثير منهم بافتقارهم إلى الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم، الأمر الذي أدى إلى بروز روايات ومطالبات متباينة بين الأفراد، في محاولة لإثبات حقهم في الأرض. وقد لخّص أحد المخبرين المحليين هذا التعقيد بالإشارة إلى أن الوضع أفرز روايات متضاربة ومناورات متنافسة في السعي وراء إثبات الملكية([9]).
تؤكد شركة التعدين التزامها بالإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح استغلال الأراضي، غير أن أفراد المجتمع يشككون في مدى شرعية هذه العملية. فوفقًا للإطار الرسمي، تعني الإجراءات القانونية الواجبة الحصول على تراخيص من المؤسسات المختصة مثل هيئة الأراضي أو هيئة المعادن، إلى جانب استشارة السلطات العرفية ممثلة في الرؤساء وكبار السن بوصفهم أوصياء على الأراضي. وترى الشركة أن استكمال هذه الخطوات وإعلان المنطقة كمنطقة تعدين يبرر الدخول في مفاوضات مع المجتمع بشأن إعادة التوطين والتعويضات. ومع ذلك، يثير المجتمع تساؤلات حول ما إذا كان منح امتياز التعدين وحده يكفي لنزع ملكيتهم، وما إذا كانت الإجراءات قد تضمنت بالفعل مشاورات تراعي خصوصية أنظمة الحيازة العرفية.
هذا التباين في الفهم يعكس أثر التعددية القانونية، التي تسمح بتعايش أطر قانونية متوازية في إدارة الأراضي، فتخلق حالة دائمة من الشك وعدم اليقين. وتظهر دراسات سابقة أن مثل هذه الخلافات ليست جديدة، حيث عبرت مجتمعات محلية عن استيائها من قرارات زعمائها بتخصيص أراضٍ للشركات الزراعية أو التعدينية من دون مفاوضات أو اتفاقات واضحة مع المالكين الفعليين. ويبرز هنا تحدٍ أساسي يتمثل في تحديد الجهة المخولة بالاستشارة أو التفاوض، خصوصًا عندما تُدار الأراضي بشكل مشترك بين المؤسسات العرفية ومؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من وضوح الأطر التشريعية – مثل قانون الأراضي لعام 2020 (القانون 1036)، وقانون وكالة حماية البيئة لعام 1994 (القانون 490)، وقوانين التعدين كقانون لجنة المعادن لعام 1993 (القانون 450)، وقانون المعادن والتعدين لعام 2006 (القانون 703) وتعديلاته – والتي تنص على ضرورة تحديد المالكين الشرعيين في مراحل مبكرة من خلال مشاورات أصحاب المصلحة (المادة 244 من قانون الأراضي)، فإن التطبيق العملي يظل معقدًا. فالتعايش بين النظم القانونية والعرفية، إلى جانب ضعف وعي المجتمعات المحلية بهذه الإجراءات، يؤدي إلى تزايد النزاعات وسوء الفهم. كما قد يُستغل هذا التعقيد عمدًا من قبل أطراف فاعلة للتلاعب بالنظام بما يخدم مصالحها الخاصة، مما يضعف عدالة وفعالية حوكمة الأراضي([10]).
المحور الرابع: سلطة الأراضي وصلاحيات القرار وعلاقتها بالملكية وسبل العيش
تُعد سلطة الأراضي إحدى الركائز الأساسية في إدارة الموارد الطبيعية، إذ تحدد القوانين والأنظمة كيفية حيازة الأرض واستخدامها ونقل ملكيتها. وغالبًا ما تتوزع صلاحيات اتخاذ القرار بين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والزعامات التقليدية، بما يعكس تداخل النظم القانونية والرؤى العرفية. هذا التوزيع للصلاحيات قد يخلق فرصًا للتعاون والتكامل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح المجال أمام نزاعات على الشرعية والاختصاص، خاصةً في البيئات التي تشهد تعدد الأطر القانونية.
ترتبط الأرض ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الملكية وسبل العيش، حيث تشكل أساس النشاط الزراعي والرعوي والتعديني، فضلًا عن كونها الضامن للأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسر والمجتمعات. إن امتلاك الأرض أو الحصول على حق الانتفاع بها يوفّر للأفراد والشركات موارد مادية ومعنوية، بينما يؤدي غياب الضمانات الواضحة للملكية إلى هشاشة سبل العيش وتعميق الفوارق الاجتماعية. ومن ثمّ، فإن تنظيم سلطة الأراضي بشكل عادل وشفاف يعد شرطًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق المجتمعات المحلية.
بعد منح امتيازات التعدين، غالبًا ما تتعرض المجتمعات المحلية لاضطرابات تمس سبل عيشها التقليدية، وهو ما يهدد استقرارها الاقتصادي ويخلّف تداعيات اجتماعية وبيئية واسعة النطاق. ففي مناطق مثل شمال أهافو وبريستيا، يواجه السكان حالة من انعدام الأمن نتيجة تداخل أنشطتهم التقليدية مع عمليات الشركات الجديدة أو القائمة. ويُفاقم الارتباط الوثيق بين الأرض وسبل العيش من حدة الصراعات والنزاعات المتعلقة بحقوق الأراضي بين المجتمعات المحلية وهذه الشركات([11]).
في هذه الحالة، استندت شركات التعدين إلى الأطر القانونية الوطنية لتأكيد مطالبها بالملكية. وتُبرز مختلف الروايات حجم الصراع حول حقوق الأراضي في مجتمعات التعدين. غير أن ممثل إحدى الشركات قدّم وجهة نظر مغايرة، موضحًا أن بعض هذه المجتمعات، مثل بونداي، نشأت منذ زمن بعيد وتطورت تاريخيًا بفضل وجود المنجم. وأكد أن الشركة لا تنتزع أراضي السكان، بل تحاول التكيف معهم عبر السماح لهم بممارسة التعدين داخل امتيازها. ووفقًا له، يُسمح لعمال المناجم الصغار بالعمل حتى يحين موعد بدء الشركة عملياتها في منطقة معينة، وعندها يُطلب منهم الانتقال إلى موقع آخر. وبيّن قائلاً:
“ليس الأمر كما لو أننا نجبرهم على مغادرة أراضيهم، بل نطلب منهم فقط التوقف عن التعدين في موقع محدد عندما نكون مستعدين لبدء العمليات هناك. كما نمنحهم وقتًا كافيًا للانتقال إلى منطقة أخرى. وبالتالي، لا يمكن اعتباره طردًا كاملاً أو خسارة كلية للأرض.”
وفي المقابل، عبّر المشاركون في شمال أهافو عن مخاوف عميقة بشأن العواقب المحتملة لفقدان أراضيهم لصالح شركة التعدين، واعتبروا ذلك بمثابة كارثة وجودية. فقد رأوا أن الأمر يتجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادي ليشمل الروابط العاطفية والرمزية التي تربطهم بالأرض، حيث تُعد مصدرًا للرزق وركيزة للانتماء والتماسك الاجتماعي. وقد لخّص أحد أرباب الأسر هذه المخاوف بقوله:
“إن فقدان أرضنا لصالح شركة تعدين سيكون بمثابة فشل شخصي، فهي حجر الزاوية الذي يربط عائلتي معًا ويوفر لنا سبل العيش. إن فكرة التخلي عن إرثنا الموروث لشخص غريب [أي الشركة] والتفريط في تقاليدنا العزيزة أمر لا يُصدق بالنسبة لي كرب أسرة([12]).
إيجابيات وسلبيات رقمنة حوكمة الأراضي
تشير النتائج التجريبية لهذه الدراسة إلى أن التحول نحو الأنظمة الرقمية لحوكمة الأراضي في غانا قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة ما لم تتم إدارته بعناية. فإدارة الأراضي تشمل تسجيل العلاقة بين الأفراد والأرض، وتوثيق حقوق الملكية، وضمان سهولة الوصول إلى السجلات وتحديثها. وفقًا لما طرحه ليمين وآخرون، تقوم إدارة الأراضي على ثلاثة عناصر رئيسية: الأشخاص، والوحدات المكانية، والحقوق التي تربط بينهما. غير أن هذه العناصر غالبًا ما تتسم بالتعددية، سواء من حيث تعدد الأفراد، أو تداخل الحقوق، أو تقسيم المساحات، وهو ما يُعقّد عملية التنسيق والإدارة على نطاق واسع.
يرى أنصار الرقمنة أنها تتيح بناء أنظمة شفافة وموثوقة لحفظ السجلات، تساعد الحكومات على التحقق من هوية المالكين، وتوضيح ملكية العقارات، والحد من المطالبات المتضاربة. ومع ذلك، تكشف الأبحاث أن الرقمنة – خصوصًا عبر تقنيات مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين) – قد تتحول إلى قوة عالمية تُعزز من تسليع المعلومات والبيانات، وهو ما قد يُرسّخ أوجه عدم المساواة القائمة. فعلى سبيل المثال، تُحذّر دراسات من زامبيا من أن الرقمنة، إذا لم تُصاحبها آليات إشراف ومساءلة، قد تديم الهياكل الرأسمالية وتُقصي الفئات الهشة. في هذا السياق، قد يستفيد بعض الأفراد من إضفاء الطابع الرسمي على ملكياتهم، بينما يجد آخرون، خصوصًا من يفتقرون إلى الموارد المالية، أنفسهم في وضع هش، بما يُفضي إلى تعميق الفجوة الرقمية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
في غانا، تُشرف السلطات المحلية والمؤسسات العرفية على عملية الاستحواذ على الأراضي وتوزيعها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى توثيق مجزأ وغير متكافئ. فالكثير من حقوق الأراضي تُدار عبر اتفاقيات شفوية – مثل حقوق الانتفاع – التي نادرًا ما تُسجَّل رسميًا. ويزداد الضغط على تسجيل الأراضي ورقمنة السجلات في المناطق الغنية بالموارد المعدنية، حيث تتصاعد المنافسة بين الحكومة والمجتمعات المحلية وأصحاب المصالح. ورغم أن قانون الأراضي لعام 2020 (القانون رقم 1036)، ولا سيما المواد من 1 إلى 12 والفصل الخامس، يُوفّر إطارًا قانونيًا مهمًا يعزز وضوح الملكية ويدعم الرقمنة، إلا أن هذه الأحكام تظل في كثير من الحالات بعيدة عن متناول المجتمعات المحلية، خاصة في ظل هيمنة أنظمة الحيازة العرفية.
تُبرز هذه الفجوة ضرورة تجاوز الإصلاحات القانونية نحو الاستثمار في التوعية المجتمعية، والمشاركة المحلية، وتعزيز التعاون بين الفاعلين القانونيين والعرفيين، بما يضمن شمولية الأنظمة الرقمية وعدالتها. غير أن الرقمنة، إذا نُفّذت دون مراعاة للترتيبات العرفية أو للمطالبات غير الموثقة، قد تتحول إلى أداة ناعمة لنزع الملكية، حيث يمكن استبعاد أفراد عاشوا وزرعوا أراضي لعدة أجيال لمجرد افتقارهم إلى سندات ملكية رسمية. يحدث هذا النزع بهدوء عبر السجلات الرقمية والأنظمة البيروقراطية، مما يُصعّب مقاومته ويُفاقم التفاوتات الاجتماعية. ومن ثم، فإن نجاح التحول الرقمي في غانا يتطلب خطوات تأسيسية قوية في مجال الحوكمة، ونهجًا تشاركيًا يُراعي التنوع في ترتيبات الملكية، لتفادي تحويل الرقمنة من أداة إصلاح إلى وسيلة للإقصاء([13]).
الخاتمة
تجادل هذه المقالة بضرورة التعامل بحذر مع النظرة المفرطة في التفاؤل التي ترى أن التحول الرقمي يمثل الحل الشامل لقضايا حوكمة الأراضي المعقدة في أفريقيا، خصوصًا في السياقات ذات التعددية القانونية، حيث تستمد المؤسسات العرفية والقانونية شرعيتها بطرق مختلفة. إن الدفع نحو المنصات الرقمية لا ينبغي أن يُغفل التحديات الجوهرية المتمثلة في غموض حدود الأراضي، وتضارب روايات الملكية، وحقوق السكان الأصليين في أراضٍ موضع نزاع تاريخي. ومن ثم، فإن نجاح التحول الرقمي يتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار محو الأمية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، وفهم الديناميكيات الثقافية والتاريخية والاجتماعية المؤثرة في ترتيبات ملكية الأراضي. ويُحذّر من أن تجاهل هذه الأبعاد قد يُشعل صراعات جديدة، خاصةً في المناطق التي تسود فيها أنظمة الحيازة العرفية. ورغم أن الأدوات الرقمية قد تُعزز الشفافية والكفاءة في توثيق الحقوق وحل النزاعات، إلا أن تصميمها يجب أن ينطلق من فهم عميق لتعقيدات المناطق العرفية، حيث غالبًا ما تتسم الحدود بالغموض وهياكل الملكية بالتشابك. لذا تبرز الحاجة إلى تطوير آليات رسمية تدمج المطالبات العرفية في قواعد بيانات الدولة، بما يضمن عدم تهميش ملاك الأراضي التقليديين في مسار الرقمنة.
في الختام، يتضح أن التعددية القانونية تواصل إلقاء ظلالها على إدارة الأراضي في غانا، لتنعكس آثارها كذلك على مسار الحوكمة الرقمية للأراضي. فبدلًا من أن تكون الرقمنة حلًا حاسمًا، فإنها تكشف في كثير من الأحيان عن التحديات الهيكلية القائمة وتعيد إنتاجها بأشكال جديدة. إن استمرار التداخل بين النظم العرفية والقانونية، مع ما يصاحبه من غموض في الحقوق وتضارب في روايات الملكية، يجعل من الصعب تحقيق إدارة متماسكة وشفافة للأراضي. ومن ثم، فإن نجاح الرقمنة في هذا السياق يظل مشروطًا بمدى القدرة على دمج النظم العرفية والقانونية في إطار تشاركي يعترف بتعددية مصادر الشرعية، ويوازن بين الكفاءة التقنية وحماية حقوق المجتمعات المحلية. بهذا المعنى، تُعد الحوكمة الرقمية فرصة واختبارًا في آن واحد: فرصة لإعادة بناء الثقة والشفافية، واختبارًا لقدرة الدولة والمجتمع على صياغة حلول شاملة وعادلة لإدارة الأراضي.
يمكن الاستنتاج أن مستقبل الحوكمة الرقمية للأراضي في السياقات الأفريقية ــ وفي غانا على وجه الخصوص ــ يظل رهينًا بقدرة الدولة على مواءمة التقنيات الحديثة مع البنى الاجتماعية والقانونية القائمة. فالرقمنة، مهما بلغت من تطور، لا يمكن أن تحل محل العمليات التشاركية التي تستند إلى الاعتراف بالحقوق التاريخية والتقاليد المحلية. إن بناء نظام رقمي عادل وفعّال يتطلب شراكة مؤسسية ومجتمعية واسعة، تُدمج فيها المعارف العرفية ضمن الهياكل الرسمية، بما يُعيد تشكيل إدارة الأراضي على نحو يُحقق الإنصاف ويحُدّ من النزاعات. وفي نهاية المطاف، لن تُقاس نجاحات التحول الرقمي بانتشار المنصات فحسب، بل بقدرته على إحداث تغيير ملموس في شفافية النظام، وحماية حقوق الفاعلين المحليين، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة حيازة الأراضي.
[1] Sara Alhola: Land tenure formalisation and perceived tenure security: Two decades of the land administration project in Ghana Author links open overlay panel, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107195
[2] مصطفى عيد: «غانا» تتحول إلى أول مركز زراعي بالذكاء الاصطناعي في أفريقيا باستثمار «ياباني» بقيمة 100 مليون دولار، نشر في أغسطس 27, 2025، https://fintechgate.net/2025/08/27/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7/
[3] Admos Chimhowa: The ‘new’ African customary land tenure, Characteristic, features and policy implications of a new paradigm Author links open overlay panel, https://www-sciencedirect com.translate.goog/science/article/pii/S0264837717310207?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
[4] Daniel Ayalew Ali: Environmental and gender impacts of land tenure regularization in Africa: Pilot evidence from Rwanda, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.12.009
[5] Amanor KS: Land administration, chiefs, and governance in Ghana. In: Takeuchi, African Land Reform Under Economic Liberalisation: States, Chiefs, and Rural Communities. Singapore: Springer Nature, 2022, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-4725-3_2
[6][6] Jeannette Bayisenge: Changing Gender Relations? Women’s Experiences of Land Rights in the case of the Land Tenure Reform Program in Rwanda, March 2015, https://www.researchgate.net/publication/281086713_Changing_Gender_Relations_Women’s_Experiences_of_Land_Rights_in_the_case_of_the_Land_Tenure_Reform_Program_in_Rwanda
[7] Amanor KS: Op, Cit.
[8] محمود سامح همام: الرقمنة كأداة للنفوذ السياسي والاقتصادي: التجربة الغانية في سياق التحولات الأفريقية، المركز الديمقراطي العربي، نشر في 2025، https://democraticac.de/?p=106046
[9] JP Bizimana, Theodomir Mugiraneza, Emmanuel Twarabamenye, MR Mukeshimana: Land Tenure Security in Informal Settlements of Kigali City. Case study in Muhima Sector, Rwanda Journal, July 2012, https://www.researchgate.net/publication/272345791_Land_Tenure_Security_in_Informal_Settlements_of_Kigali_City_Case_study_in_Muhima_Sector
[10] Benjamin Kwakye a, Alexander Sasu b: Show more Determinants of sustainable customary land secretariats in Ghana: An economic modelling approach, Land Use Policy, Volume 146, November 2024, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837724002801
[11] Daivi Rodima-Taylor: Digitalizing land administration: The geographies and temporalities of infrastructural promise, Geoforum Volume 122, June 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718521001020
[12] Sara Alhola: Op,Cit.
[13] Blockchain on stool land acquisition: Lessons from Ghana for strengthening land tenure security other than titling, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837721003586