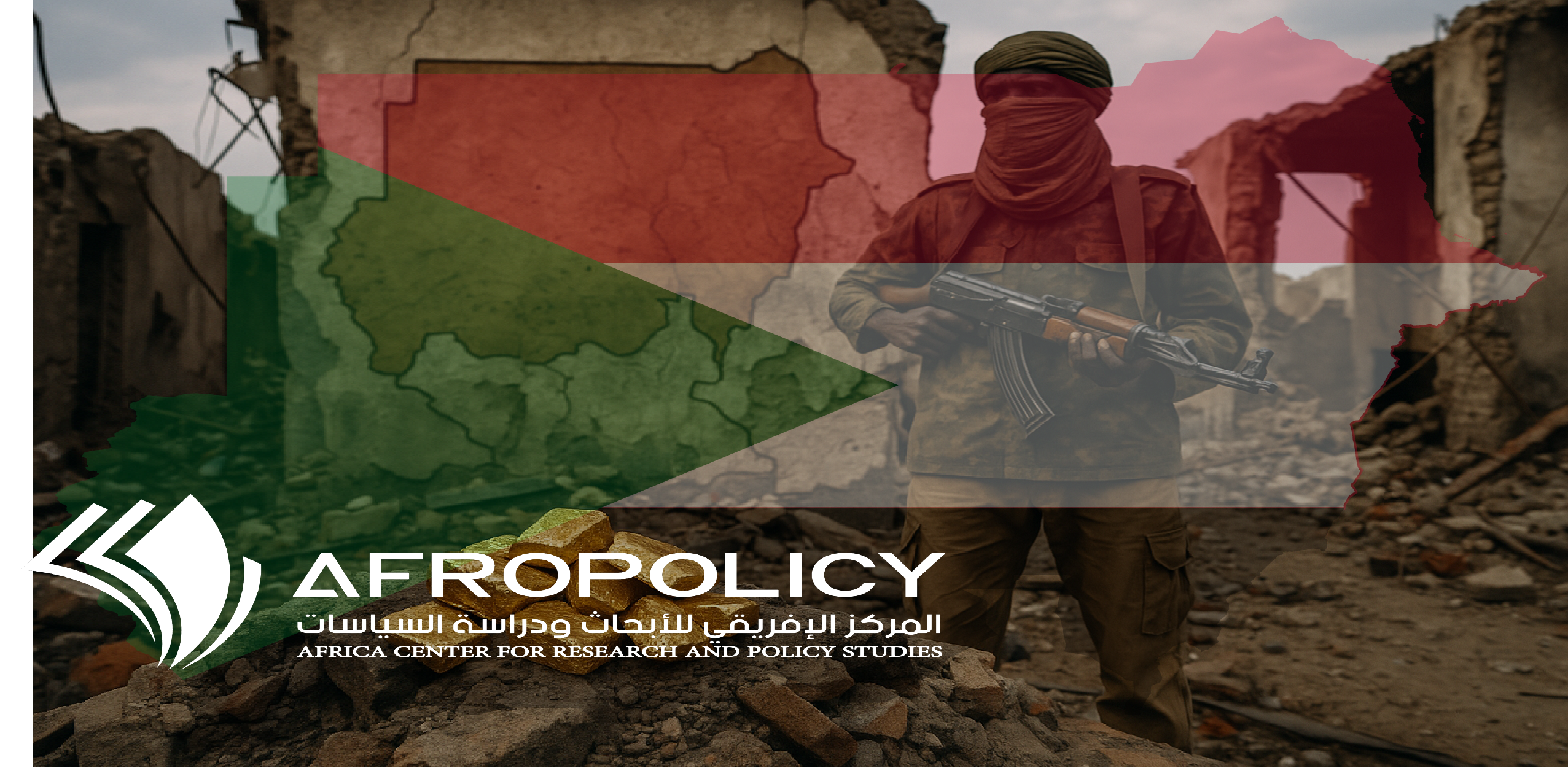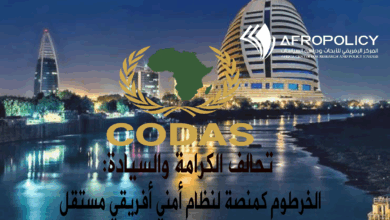المستخلص
تتناول هذه المقالة البحثية بالتحليل الاقتصاد السياسي للحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، متجاوزةً التفسيرات التقليدية التي تختزل الصراع في كونه مجرد تنافس على السلطة بين فصيلين عسكريين. بالاستناد إلى الإطار التحليلي المبتكر لـ “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT)، تجادل المقالة بأن الصراع السوداني ليس حرباً أهلية بالمعنى الكلاسيكي، بل هو تجسيد نموذجي لنمط جديد من الصراعات تُغذيه وتُديمه بشكل حاسم “اقتصاديات حرب عابرة للحدود” (Transnational War Economies). من خلال منهج دراسة الحالة النوعي، الذي يعتمد على تتبع العمليات (Process Tracing) وتحليل البيانات المفتوحة المصدر، تكشف الدراسة كيف أن التقاء الهشاشة الهيكلية للدولة السودانية مع ديناميكيات العولمة قد خلق بيئة مثالية لظهور فاعلين مسلحين من غير الدول (تحديداً مليشيا الدعم السريع) ككيانات هجينة (عسكرية-تجارية-سياسية). هذه الكيانات لا تمارس العنف المنظم فحسب، بل تدير شبكات اقتصادية معقدة ومتشعبة، محورها استخراج وتهريب الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب. تُبرهن المقالة، عبر تحليل شبكات تهريب الذهب، والسيطرة على البنى التحتية الحيوية، والارتباط بالشبكات المالية واللوجستية الإقليمية والدولية، على أن الحوافز الاقتصادية لم تعد مجرد عامل ثانوي، بل تحولت إلى محرك أساسي لاستمرارية الصراع ومنطق حاكم له. هذه الديناميكيات أفرزت “نخبة حرب جديدة” (New War Elites) ترتبط مصالحها بشكل عضوي باستدامة حالة الفوضى المنظمة. وتخلص الدراسة إلى أن أي مقاربة مستقبلية لتحقيق سلام مستدام في السودان محكوم عليها بالفشل ما لم تتجاوز الحلول السياسية السطحية لتشمل استراتيجيات شاملة وموجهة لتفكيك اقتصاد الحرب، وتجفيف مصادر تمويله، وتطبيق آليات محاسبة اقتصادية صارمة على المستويين المحلي والدولي.
الكلمات المفتاحية: الاقتصاد السياسي للحرب، نظرية الحروب الدولية الجديدة (NIWT)، السودان، مليشيا الدعم السريع، اقتصاديات الحرب، تهريب الذهب، الدولة الهشة، الفاعلون من غير الدول، العولمة، اقتصاد الظل.
1. مقدمة: إعادة تأطير الصراع في السودان
في فجر الخامس عشر من أبريل 2023، استيقظ العالم على دوي الانفجارات وأصوات الرصاص في العاصمة السودانية الخرطوم. بدا المشهد، للوهلة الأولى، فصلاً جديداً في تاريخ السودان الحافل بالانقلابات العسكرية والصراعات. تركزت السردية الإعلامية والتحليلات الأولية على التنافس المحموم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بوصفه صراعاً شخصياً بين حليفين سابقين تحولا إلى أعداء لدودين (International Crisis Group, 2023). ورغم صحة هذا التوصيف على المستوى السطحي حينها، إلا أنه ظل قاصراً بشكل خطير عن تفسير عمق الأزمة، وطبيعتها المتغيرة، وقدرتها التدميرية الهائلة، وسبب استعصائها على الحلول الدبلوماسية التقليدية.
إن اختزال الحرب السودانية في “صراع على السلطة” هو بمثابة النظر إلى قمة جبل الجليد وإغفال كتلته الهائلة المغمورة تحت الماء. فهذه الحرب، التي سرعان ما امتدت من الخرطوم إلى دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، كشفت عن ديناميكيات أعمق تتعلق بتآكل الدولة، وصعود فاعلين مسلحين من غير الدول بإمكانيات شبه دولاتية، وتشابك المصالح الاقتصادية غير المشروعة مع الأجندات السياسية والعسكرية (صديق، 2025). لقد تحولت الحرب من وسيلة لتحقيق هدف سياسي (الاستيلاء على الحكم بدعم ورعاية خارجية) إلى غاية في حد ذاتها؛ نظام اقتصادي وسياسي بديل، له منطقه الخاص، ومستفيدوه، وآلياته للاستدامة الذاتية.
هنا تكمن الإشكالية البحثية الأساسية لهذه المقالة: كيف يمكن فهم استمرارية وعنف الصراع في السودان بما يتجاوز السرديات التقليدية؟ وما هو الدور الذي يلعبه الاقتصاد السياسي الجديد، العابر للحدود، في تغذية آلة الحرب وتحديد مساراتها وتقويض فرص السلام؟
للإجابة على هذه الإشكالية، يتبنى هذا المقال إطاراً نظرياً محدداً ومبتكراً هو “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) (الطاهر، 2025). تنطلق هذه النظرية من فرضية أن الحروب المعاصرة، خاصة في سياقات الدول الهشة، لم تعد حروباً بين الدول بالمعنى الويستفالي التقليدي، ولا حتى حروباً أهلية محصورة داخل حدود جغرافية وسيادية واضحة. بل هي “حروب دولية جديدة” تتميز بتعدد الفاعلين (دول، وكلاء، ميليشيات، شركات)، وضبابية الخطوط الفاصلة بين ما هو داخلي وخارجي، وما هو سياسي واقتصادي، وما هو مشروع وغير مشروع.
تجادل هذه الدراسة، وتحديداً بالاستناد إلى الفرضية السادسة من نظرية (NIWT) التي تنص على أن “اقتصاديات الحرب العابرة للحدود هي عامل حاسم في استدامة الحروب الدولية الجديدة”، بأن الصراع السوداني يمثل الحالة الدراسية النموذجية (Paradigm Case) لهذا النمط من الحروب. سنقوم بتفكيك البنية التحتية المالية واللوجستية التي تمول آلة الحرب، وتحديداً تلك التي تعتمد عليها مليشيا الدعم السريع، وكشف شبكاتها الممتدة من مناجم دارفور إلى الأسواق العالمية. وسنبرهن كيف أن هذه الديناميكيات الاقتصادية لا تمول الحرب فحسب، بل تخلق حوافز هيكلية قوية لاستمرار الفوضى، وتفرز “نخبة حرب” جديدة تصبح مصالحها المادية مرتبطة عضوياً باستمرار حالة اللا-دولة واللا-سلام.
من خلال هذا التحليل، تهدف الدراسة إلى تقديم ثلاث مساهمات رئيسية:
- مساهمة نظرية: اختبار وتطبيق “نظرية الحروب الدولية الجديدة” على حالة تجريبية معاصرة ومعقدة، مما تطبيق إضافي، بعد أن طبقت النظرية على حالة السودان -ضمن مجموعة حالات دراسية أخرى في كتابنا الثاني “فوق الركام: بناء ‘نظرية الحروب الدولية الجديدة’ لفهم عالم الحروب المعاصرة” من سلسلة “فهم عالم الحروب المعاصرة: سلسلة الحروب الدولية الجديدة”(قيد النشر)، لكن هذا التطبيق الحالي بالتأكيد مركزاً على الفرضية السادسة ضمن الفرضيات الموسعة للنظرية، المنشغلة باقتصاديات الحرب العابرة للحدود عامل استدامة، وهو حقيقة أمر يسهم في إثراء النقاش حول الاقتصاد السياسي للحروب في أيامنا.
- مساهمة تجريبية: تقديم تحليل معمق وموثق للاقتصاد السياسي لحرب السودان، يجمع بين خيوط متعددة (الذهب، النهب، الشبكات الإقليمية، الفاعلون الدوليون) في إطار تحليلي واحد متماسك.
- مساهمة على مستوى السياسات: نقد المقاربات التقليدية لصنع السلام، وتقديم توصيات بديلة ترتكز على ضرورة تفكيك اقتصاد الحرب كشرط أساسي لأي حل سياسي مستدام.
لتحقيق هذه الأهداف، تم تقسيم المقال إلى الأقسام التالية: يبدأ القسم الأول بمراجعة نقدية للأدبيات ذات الصلة، ويقدم الإطار النظري المفصل لـ “نظرية الحروب الدولية الجديدة”. ويستعرض القسم الثاني المنهجية المتبعة في البحث. أما القسم الثالث، وهو جوهر الدراسة، فيقدم تحليلاً تشريحياً للاقتصاد السياسي لحرب السودان عبر ثلاثة محاور مترابطة. ويناقش القسم الرابع التداعيات المدمرة لهذا الاقتصاد على فرص السلام ومستقبل الدولة السودانية. وأخيراً، يقدم القسم الخامس خاتمة تلخص النتائج الرئيسية وتطرح توصيات عملية مبنية على منطق التحليل.
2. مراجعة الأدبيات والإطار النظري
لفهم الأبعاد الكاملة للاقتصاد السياسي والصراع في السودان، من الضروري وضعه ضمن سياق أكاديمي أوسع يتعلق بتطور دراسات الحرب والسلام. يمكن تقسيم هذا السياق إلى ثلاث تيارات فكرية رئيسية: الحروب التقليدية، نقاشات “الحروب الجديدة”، وأدبيات الاقتصاد السياسي للصراع.
2.1. من حروب كلاوزفيتز إلى “الحروب الجديدة“
سيطر النموذج الكلاوزفيتزي (Clausewitzian model) على الفكر الاستراتيجي لقرون، حيث عرّف الحرب بأنها “استمرار للسياسة بوسائل أخرى” (von Clausewitz, 1832/1976). في هذا النموذج، تكون الدولة هي الفاعل الحصري في الحرب، والجيوش الوطنية هي الأداة، والهدف هو تحقيق غاية سياسية واضحة. كان اقتصاد الحرب يُفهم في المقام الأول على أنه تعبئة موارد الدولة لخدمة المجهود الحربي، وهو بالضرورة نشاط مستنزف للاقتصاد الوطني.
مع نهاية الحرب الباردة، بدأ هذا النموذج يواجه تحديات متزايدة. لاحظ باحثون مثل ماري هنريتا كالدور (Mary Kaldor) ظهور نمط جديد من “العنف المنظم” أطلقت عليه “الحروب الجديدة” (New Wars). تجادل كالدور (Kaldor, 2012) بأن هذه الحروب تختلف جوهرياً عن الحروب القديمة في أهدافها، وأساليبها، وطرق تمويلها. فبدلاً من الأهداف الجيوسياسية أو الأيديولوجية، غالباً ما تكون مدفوعة بسياسات الهوية الطائفية أو العرقية. وبدلاً من المعارك الحاسمة بين الجيوش، تعتمد على تكتيكات حرب العصابات، والإرهاب، والتهجير القسري للسكان. والأهم من ذلك، بالنسبة لهذه المقال، هو أن الخطوط الفاصلة بين الحرب والجريمة المنظمة أصبحت ضبابية، حيث يتم تمويل هذه الحروب عبر النهب، والابتزاز، وسيطرة أمراء الحرب على التجارة غير المشروعة.
قدمت نظرية “الحروب الجديدة” إسهاماً كبيراً، لكنها واجهت انتقادات لكونها تعميمية أكثر من اللازم، ولإغفالها استمرارية بعض سمات “الحروب القديمة” في الصراعات المعاصرة (Kalyvas, 2001). ومع ذلك، فإن تركيزها على ضبابية الفاعلين وتداخل الحرب مع الاقتصاد الإجرامي يمثل نقطة انطلاق حيوية لفهم الحالة السودانية.
2.2. مدرسة الاقتصاد السياسي للصراع: الجشع في مواجهة المظالم
بشكل موازٍ، تطور حقل فرعي غني في الاقتصاد والعلوم السياسية يركز على الدوافع الاقتصادية للحروب الأهلية. برز في هذا المجال نقاش شهير بين فرضيتي “الجشع” (Greed) و”المظالم” (Grievance). جادل بول كولير وكبار الاقتصاديين بأن العديد من الحروب الأهلية يمكن تفسيرها بشكل أفضل ليس من خلال المظالم السياسية أو التاريخية، بل من خلال الفرص الاقتصادية المتاحة للنخب المتمردة (Collier & Hoeffler, 2004). وفقاً لهذه المدرسة، تندلع الحروب عندما تكون “مجدية اقتصادياً” للمتمردين، خاصة في البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأولية (مثل الألماس أو النفط)، والتي يسهل نهبها وتهريبها لتمويل التمرد.
في المقابل، انتقد باحثون آخرون هذا الاختزال الاقتصادي، مؤكدين على أن المظالم الحقيقية – مثل التهميش السياسي، والتمييز العرقي، وعدم المساواة – هي الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى حمل السلاح، حتى لو استغل القادة الفرص الاقتصادية لاحقاً (Keen, 2012). قدم ديفيد كين (David Keen) منظوراً أكثر دقة، حيث جادل بأن الحرب ليست مجرد انهيار للنظام، بل هي “نظام بديل” له وظائفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالحرب تخلق رابحين وخاسرين، والرابحون (أمراء الحرب، المهربون، المسؤولون الفاسدون) لديهم مصلحة مباشرة في استمرارها، وهو ما أسماه “اقتصاديات الحرب المعقدة” (The Complex Economics of War).
تعتبر هذه الأدبيات أساسية لفهمنا، لكنها غالباً ما ركزت على الديناميكيات “الداخلية” للحرب الأهلية. الحالة السودانية وكل حالات الحروب المتأخرة في اعتقادي تتطلب إطاراً يتجاوز الدولة-الأمة كوحدة تحليل أساسية.
2.3. الإطار النظري: “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT)
هنا تبرز أهمية “نظرية الحروب الدولية الجديدة” (NIWT) (الطاهر، 2025) كإطار تحليلي يهدف إلى تجميع وتجاوز المدارس السابقة. تنطلق (NIWT) من أن العولمة أدت إلى “عولمة الصراع” في الدول الهشة عبر تدفق المال والمقاتلين. علماً بأن النظرية لا تنفي أهمية المظالم أو الجشع، لكنها تضعهما في سياق هيكلي جديد قوامه التقاء عاملين: ضعف الدولة السيادي والتكامل الشبكي العابر للحدود.
تقدم (NIWT) عدة فرضيات، لكن الفرضية السادسة هي الأكثر صلة بهذه المقالة: “تُستدام الحروب الدولية الجديدة بشكل حاسم من خلال اقتصاديات حرب عابرة للحدود، والتي تحول الصراع من حدث سياسي إلى مشروع تجاري مربح لشبكة من الفاعلين المحليين والدوليين”.
يمكن تفكيك هذه الفرضية إلى عدة مكونات أساسية تشكل عدستنا التحليلية:
- الإنتاجية لا الاستنزاف: على عكس اقتصاد الحرب الكلاسيكي الذي يستنزف موارد الدولة، فإن اقتصاد الحرب الجديد “ينتج” قيمة من خلال أنشطة غير مشروعة مثل النهب المنظم، والسيطرة على الموارد الطبيعية (الذهب)، والابتزاز، وإنشاء نقاط تفتيش، والتحكم في الأسواق السوداء.
- الطابع العابر للحدود: هذه الاقتصادات ليست محلية. إنها تعتمد بشكل حيوي على شبكات إقليمية ودولية معقدة. يتم تهريب الموارد الأولية (الذهب السوداني) إلى دول الجوار، ومنها إلى مراكز مالية وتجارية عالمية (مثل دبي) حيث يتم غسلها وإدخالها في الأسواق. في المقابل، تتدفق الأسلحة والوقود والمرتزقة والسيولة المالية إلى منطقة الصراع عبر نفس الشبكات.
- خصخصة التمويل والعنف: لم تعد الدولة (أو الدول الراعية) هي الممول الوحيد للحرب. الفاعلون المسلحون من غير الدول، مثل مليشيا الدعم السريع، يطورون مصادر تمويل ذاتية هائلة تجعلهم مستقلين بشكل بدرجة معقولة عن أي راعٍ خارجي، وتمنحهم استقلالية في القرار لا تملكها الجيوش الوطنية التقليدية.
- خلق “نخبة حرب” ذات مصالح مضادة للسلام: هذه الاقتصادات تخلق وتدعم “نخبة حرب جديدة” (New War Elites). هذه النخبة ليست مجرد قادة عسكريين، بل هي تكتل من أمراء الحرب، وعائلاتهم، ورجال أعمال فاسدين، ووسطاء إقليميين، وشركات واجهة دولية، وحتى بعض المسؤولين في دول أخرى. تصبح مصالح هذه الشبكة المعقدة مرتبطة عضوياً باستمرار حالة الفوضى والحرب، حيث أن السلام يعني بالنسبة لهم فقدان مصادر الدخل الهائلة، والتعرض للمساءلة القانونية، وتفكيك امبراطورياتهم الاقتصادية.
في هذا الإطار، لا يمكن فهم الصراع في السودان دون تحليل “البيزنس” الذي يموله ويحركه. الدعم السريع ليست مجرد “ميليشيا متمردة”، بل هي “شركة عسكرية-تجارية” (Military-Commercial Enterprise) عابرة للحدود، والحرب هي استراتيجية عملها الأساسية. هذا الإطار هو الذي سيوجه تحليلنا التجريبي في الأقسام التالية.
جدول 1: مقارنة نماذج الحرب (تطبيق على حالة السودان)
| السمة | نموذج الحرب الكلاسيكي (الجيش السوداني نظرياً) | نموذج الحروب الدولية الجديدة (مليشيا الدعم السريع عملياً) |
| الفاعل الأساسي | الدولة (الجيش الوطني) | شبكة من الفاعلين (مليشيا، شركات، وكلاء دوليون) |
| الهدف | سياسي (الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها) | اقتصادي-سياسي (السيطرة على الموارد، إنشاء كيان هجين) |
| التمويل | ميزانية الدولة (استنزاف للاقتصاد الوطني) | اقتصاد حرب ذاتي ومربح (نهب، تهريب ذهب، دعم خارجي) |
| طبيعة الاقتصاد | اقتصاد تعبئة واستنزاف | اقتصاد إنتاج ونهب عابر للحدود |
| العلاقة بالحدود | احترام مقدر للحدود السيادية | اختراق وتجاوز الحدود (شبكات تهريب ودعم) |
| النتيجة المرجوة | نصر عسكري، استعادة النظام | استدامة الفوضى المنظمة، استمرار تدفق الأرباح |
3. المنهجية البحثية
نعتمد في هذا المقال على منهجية دراسة الحالة النوعية (Qualitative Case Study)، حيث يمثل الصراع في السودان (2023-2025) الحالة المحورية للتحليل. يسمح هذا المنهج بإجراء فحص عميق ومفصل لظاهرة معقدة في سياقها الواقعي، وهو أمر ضروري لفهم التفاعلات المتشابكة بين العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية (Yin, 2018).
لتحقيق العمق التحليلي المطلوب وتأسيس علاقات سببية ضمن الحالة، تم استخدام تقنية “تتبع العمليات” (Process Tracing). تهدف هذه التقنية إلى تحديد وتوثيق سلسلة الأحداث والآليات السببية التي تربط بين الأسباب المفترضة (اقتصاد الحرب العابر للحدود) والنتائج المرصودة (استمرارية الصراع وعنفه). يتضمن ذلك فحص الأدلة التجريبية لتحديد ما إذا كانت السلسلة السببية التي تقترحها “نظرية الحروب الدولية الجديدة” تتجلى بالفعل في الواقع.
تم جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر المفتوحة الأولية والثانوية، وذلك للتغلب على تحديات الوصول المباشر إلى مناطق النزاع على الأرض. وتشمل هذه المصادر:
- تقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية: تم الاعتماد بشكل مكثف على التقارير الدورية الصادرة عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والتي تقدم أدلة موثقة حول انتهاكات حظر الأسلحة وشبكات تمويل أطراف النزاع عموماً (United Nations Security Council, 2024). كما تم استخدام تقارير منظمات حقوقية وبحثية مثل Human Rights Watch و Amnesty International و International Crisis Group.
- الصحافة الاستقصائية: شكلت التحقيقات المعمقة التي نشرتها مؤسسات إعلامية دولية مرموقة مثل Reuters و The Financial Times و CNN، ومنظمات استقصائية متخصصة مثل The Sentry، مصدراً حيوياً للمعلومات، خاصة فيما يتعلق بتتبع شبكات تهريب الذهب والجهات الدولية المتورطة (Soudan et al., 2023; The Sentry, 2024).
- البيانات الحكومية: تم تحليل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل الحرب في السودان، حيث توفر هذه الإعلانات تفاصيل دقيقة حول الشركات والأشخاص الذين يشكلون جزءاً من اقتصاد الحرب (S. Department of the Treasury, 2023, 2024).
- المصادر الأكاديمية والمحلية: تم الرجوع إلى الدراسات الأكاديمية السابقة حول الاقتصاد السياسي للسودان، بالإضافة إلى تحليلات وتقارير من مراكز أبحاث وخبراء سودانيين لفهم السياق التاريخي والمحلي بعمق (عباس، 2023؛ مركز الجزيرة للدراسات، 2025).
يتمثل التحليل في تجميع هذه البيانات المتفرقة وربطها ببعضها البعض ضمن الإطار النظري لـ (NIWT) لبناء سردية تحليلية متماسكة. يتم الاعتراف بوجود قيود على البحث، أبرزها الطبيعة السرية للشبكات الإجرامية وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة لحجم التجارة غير المشروعة. لذلك، نعتمد أحياناً على تقاطع الأدلة من مصادر متعددة (Triangulation) لزيادة موثوقية النتائج، وتستخدم تقديرات متحفظة عند الإشارة إلى الأرقام.
4. تشريح الاقتصاد السياسي الجديد لحرب السودان
لتطبيق إطار (NIWT) عملياً، يمكن تفكيك الاقتصاد السياسي للحرب في السودان إلى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة ومتكاملة: (1) محور الموارد، وعلى رأسه الذهب كشريان حياة لتمويل الحرب؛ (2) محور السيطرة والنهب، الذي يستهدف البنية التحتية للدولة والممتلكات الخاصة؛ (3) محور الشبكات والفاعلين، الذي يربط بين المستفيدين المحليين والإقليميين والدوليين.
4.1. الذهب: شريان الحياة الدموي للحرب
يمثل الذهب المورد الاقتصادي الأكثر استراتيجية في الصراع السوداني. لم تكن السيطرة على مناجم الذهب وليدة حرب 2023، بل هي نتاج عملية تاريخية طويلة، لكن الحرب الحالية حولتها إلى أداة وجودية لتمويل آلة الحرب بصورة كبيرة، خاصة بالنسبة لمليشيا الدعم السريع.
- البناء التاريخي للإمبراطورية الذهبية: كانت نشأت الدعم السريع من رحم ميليشيات الجنجويد التي استخدمها نظام عمر البشير في دارفور. ومع اكتشاف الذهب بكميات كبيرة في جبل عامر بدارفور حوالي عام 2012، كلف النظام حميدتي وعشيرته بحماية المناجم. سرعان ما تحولت هذه الحماية إلى سيطرة مباشرة، حيث قامت الدعم السريع بطرد المنقبين التقليديين واستولت على المنطقة، مؤسسةً بذلك نواة إمبراطوريتها الاقتصادية. قبل حرب 2023، كانت شركة “الجنيد” (Al Junaid)، وهي شركة واجهة تسيطر عليها عائلة دقلو، تهيمن على قطاع كبير من صادرات الذهب السوداني، مما سمح لحميدتي ببناء قوة عسكرية واقتصادية هائلة ومستقلة عن الجيش (Global Witness, 2019).
- السيطرة والإنتاج في زمن الحرب: مع اندلاع الحرب، أصبحت السيطرة الكاملة على مناطق إنتاج الذهب في دارفور وكردفان أولوية استراتيجية قصوى لمليشيا الدعم السريع. تشير التقارير إلى أن إنتاج السودان من الذهب بلغ حوالي 64 طناً في عام 2024 (الجزيرة نت، 2025). لكن الأرقام الرسمية تكشف أن ما يقرب من نصف هذا الإنتاج يتم تهريبه (حرة نيوز، 2024؛ سودافاكس، 2024). صرح مسؤولون في الشركة السودانية للموارد المعدنية بأن 48% من إنتاج عام 2024 تم تهريبه، مع سيطرة الدعم السريع على مناطق الإنتاج الرئيسية في دارفور وكردفان (الجزيرة نت، 2025؛ حرة نيوز، 2024). تمنح هذه السيطرة الدعم السريع تدفقاً مالياً مستقلاً ومستمراً، يقدر بمليارات الدولارات سنوياً، مما يغطي تكاليف الرواتب، وشراء الأسلحة، والوقود، وتجنيد المقاتلين الجدد.
- آليات وشبكات التهريب العابرة للحدود: يعمل تهريب الذهب السوداني عبر شبكة لوجستية معقدة وفعالة، تجسد تماماً مفهوم “اقتصاد الحرب العابر للحدود” في نظرية (NIWT).
- التجميع: يتم تجميع الذهب من المناجم الحرفية والمناجم التي تسيطر عليها الدعم السريع في دارفور وكردفان (الجزيرة نت، 2025).
- النقل الأولي: يتم نقله براً عبر الحدود التي يسهل اختراقها إلى دول الجوار، وتحديداً تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، وجنوب السودان.
- المحطات الإقليمية: في هذه الدول، يتم إخفاء أصل الذهب السوداني، وأحياناً يتم تزويده بوثائق مزورة لإظهاره كمنتج محلي.
- الوجهة النهائية: دبي: الوجهة الرئيسية الساحقة لذهب الصراع السوداني هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي (سودافاكس، 2024؛ ADF-Magazine, 2024). تشير تحقيقات استقصائية وتقارير أممية إلى أن عشرات الأطنان من الذهب السوداني تُنقل جواً وبراً إلى دبي سنوياً (الجزيرة نت، 2023أ؛ Swissinfo, 2023). هناك، يتم استغلال ضعف اللوائح التنظيمية المتعلقة بتحديد مصدر الذهب (Due Diligence). يتم صهر الذهب السوداني وخلطه مع ذهب من مصادر أخرى في مصافي دبي، ثم يتم ختمه كمنتج إماراتي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك سويسرا والهند، مما يجعله “نظيفاً” ويستحيل تتبعه (The Sentry, 2024).
- الدور الروسي والإماراتي: تقاطع المصالح: لم تكن هذه الشبكة لتكتمل لولا تقاطع مصالح الفاعلين المحليين مع جهات دولية.
- روسيا و“الفيلق الأفريقي“: منذ عهد البشير، توغلت شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية (التي تعمل الآن تحت مسمى “الفيلق الأفريقي”) في قطاع الذهب السوداني (الاستقلال، 2024؛ الجزيرة نت، 2024ب). قدم الفيلق الأفريقي الدعم العسكري والتدريب لمليشيا الدعم السريع، وفي المقابل، حصل على وصول تفضيلي ومربح لمناجم الذهب، مما سمح لروسيا بتهريب كميات كبيرة من الذهب لتمويل عملياتها والتحايل على العقوبات الغربية (الجزيرة نت، 2024ج؛ الحرة، 2024). هذا التحالف الاستراتيجي-الاقتصادي وفر غطاءً دولياً ودعماً عسكرياً حيوياً للدعم السريع (CNN, 2023).
- الإمارات العربية المتحدة: يتجاوز دور الإمارات مجرد كونها سوقاً سلبياً. تشير الشواهد على أرض الواقع والتقارير الأممية والتحقيقات الصحفية إلى أن الإمارات تقدم دعماً سياسياً كبيرا، ولوجستياً وعسكرياً لمليشيا الدعم السريع، عبر جسور جوية إلى تشاد (مطار أم جرس) وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان (ADF-Magazine, 2024؛ الجزيرة نت، 2023أ). ورغم نفي الإمارات الرسمي، فإن الأدلة تشير إلى استخدام رحلات المساعدات الإنسانية كغطاء لنقل الأسلحة (الجزيرة نت، 2023أ؛ الجزيرة نت، 2023د). يمكن تفسير هذا الدعم من خلال الرغبة في تأمين مصالح اقتصادية (الذهب والموانئ) وأهداف جيوسياسية أوسع في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. إن دور دبي كمركز لغسيل ذهب الصراع يوفر السيولة المالية الحيوية التي تحتاجها الدعم السريع للاستمرار في القتال.
جدول 2: تهريب الذهب السوداني (تقديرات 2024)
| المؤشر | القيمة |
| إجمالي إنتاج الذهب (طن) | 64 |
| النسبة المهربة (%) | 48% |
| الكمية المهربة (طن) | 30.72 |
| القيمة التقديرية للذهب المهرب (مليار دولار)* | 2.22 – 2.50 |
| أبرز طرق التهريب | تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، جنوب السودان، كينيا، دبي |
*حساب تقديري بناءً على سعر الذهب في 2024 (متوسط 2200 دولار/أونصة)، مع العلم بأن الأسعار تتذبذب.
4.2. اقتصاد النهب والسيطرة على البنية التحتية
إلى جانب الذهب، يعتمد اقتصاد الحرب على النهب الممنهج والسيطرة على الأصول الاقتصادية للدولة والمجتمع. هذا ليس مجرد سلوك عشوائي من قبل جنود منفلتين، بل هو استراتيجية اقتصادية وعسكرية متكاملة تهدف إلى تحقيق هدفين: تمويل الذات وإضعاف الخصم (الدولة السودانية).
- نهب القطاع المالي والمصرفي: منذ الأسابيع الأولى للحرب، شهدت الخرطوم عمليات اقتحام ونهب واسعة ومنظمة لفروع البنك المركزي السوداني والبنوك التجارية، حيث تعرض حوالي 100 فرع مصرفي للنهب والتدمير (الجزيرة نت، 2024د). لم تكن هذه عمليات سرقة عادية، بل كانت تهدف إلى الاستيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة بالعملة المحلية. أدت هذه العمليات إلى توفير سيولة نقدية فورية لمليشيا الدعم السريع، وفي الوقت نفسه، وجهت ضربة قاصمة للنظام المالي للدولة، وأدت إلى انهيار شبه كامل للقطاع المصرفي (Project on Middle East Democracy, 2023).
- السيطرة على البنية التحتية الصناعية والتجارية: قامت الدعم السريع منذ بداية حربها بالسيطرة المنهجية على المناطق الصناعية الرئيسية في الخرطوم، والتي تضم حوالي 75% من البنية الصناعية للبلاد، ومصافي النفط مثل مصفاة الجيلي، ومخازن السلع الاستراتيجية (الشرق، 2024). هذه السيطرة لا تهدف فقط إلى حرمان الجيش السوداني من الموارد، بل أيضاً إلى استغلال هذه الأصول لتمويل المجهود الحربي للدعم السريع من خلال بيع المنتجات المنهوبة في الأسواق الموازية أو تهريبها عبر الحدود.
- نهب الممتلكات الخاصة والمساعدات الإنسانية: شهدت مناطق النزاع، لا سيما الخرطوم(سابقاً) ودارفور، نهباً واسع النطاق للممتلكات الخاصة (المنازل، السيارات، المتاجر) من قبل قوات الدعم السريع. هذا النهب يُعد مصدراً فورياً للدخل للمقاتلين، كما أنه يخدم هدفاً استراتيجياً في التهجير القسري للسكان وتغيير التركيبة الديموغرافية (Human Rights Watch, 2024). علاوة على ذلك، أصبحت المساعدات الإنسانية هدفاً للنهب والابتزاز، حيث يتم اعتراض القوافل الإغاثية والاستيلاء على محتوياتها، مما يزيد من معاناة المدنيين ويخلق سوقاً سوداء للسلع الأساسية (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).
4.3. الشبكات والفاعلون: “نخبة حرب” عابرة للحدود
يكشف تحليل اقتصاد الحرب في السودان عن شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين الذين تتشابك مصالحهم في استدامة الصراع. هذه هي “نخبة الحرب” التي تشكل عماد نظرية (NIWT).
- مليشيا الدعم السريع كشركة عسكرية–تجارية: لم تعد الدعم السريع مجرد قوة عسكرية تقليدية. لقد تطورت لتصبح كياناً هجيناً يجمع بين القدرة العسكرية والشبكات التجارية الواسعة. عائلة دقلو، وخاصة الإخوة، تدير شبكة معقدة من الشركات الوهمية والواجهة التي تشارك في تجارة الذهب وتهريب السلع وتوفير الخدمات اللوجستية للمقاتلين (The Sentry, 2024). هذه الشركات لا تعمل فقط على تمويل الحرب، بل هي كانت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدعم السريع لبناء كيان موازٍ للدولة، يمتلك مصادر دخل مستقلة ويتحكم في مفاصل اقتصادية حيوية.
- الفاعلون الإقليميون: تلعب دول الجوار أدواراً متعددة في تغذية اقتصاد الحرب. بعضها (مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان وكينيا) يعمل كطرق عبور ومحطات وسيطة لتهريب الذهب والأسلحة. البعض الآخر، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، يلعب دوراً محورياً كداعم وراعي رئيسي للحرب على السودان ومركزاً لغسيل الأموال ووجهة للذهب المهرب ومصدرا للدعم اللوجستي والعسكري للدعم السريع، وإن كانت الإمارات تنفي ذلك رسمياً (ADF-Magazine, 2024؛ الجزيرة نت، 2023أ). لكن الأمر بات واضحاً(حتى شعبياً)، ولأن مصالح هذه الدولة مدفوعة بالوصول إلى الموارد الطبيعية، وبتأمين مصالح جيوسياسية في منطقة متوترة.
- الفاعلون الدوليون: روسيا، من خلال مجموعات مثل “الفيلق الأفريقي” (ضمن مجموعات فاغنر)، تعد فاعلاً دولياً رئيسياً في اقتصاد الذهب السوداني. فالمصالح الروسية في الذهب السوداني تتجاوز الربح المادي، لتشمل الحصول على العملة الصعبة للتحايل على العقوبات، وتأمين موطئ قدم استراتيجي في أفريقيا، وتقويض النفوذ الغربي (CNN, 2023؛ الجزيرة نت، 2024ب). كما أن بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع الذهب متواطئة بشكل مباشر أو غير مباشر في شرعنة الذهب المهرب من مناطق النزاع.
كل هذه الشبكات المتشابكة، من المناجم إلى الأسواق العالمية، خلقت نظاماً بيئياً للحرب حيث تستفيد الأطراف المختلفة من الفوضى، مما يمنحها حافزاً قوياً لمواصلة الصراع.
جدول 3: أبرز الفاعلين المستفيدين من اقتصاد الحرب في السودان
| نوع الفاعل | الفاعلون الرئيسيون | طبيعة الاستفادة |
| محليون | مليشيا الدعم السريع (عائلة دقلو وشركاتها) | تمويل الحرب، بناء إمبراطورية اقتصادية موازية للدولة تمهيداً لمشروع انفصالي جاري الإعلان عنه -تحت مسمى تأسيس |
| قيادات المليشيا المحلية | رواتب، نهب، مكاسب شخصية | |
| تجار وسماسرة محليون | تجميع وتهريب الذهب، تجارة السلع المنهوبة | |
| إقليميون | دول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا، جنوب السودان، كينيا) | طرق عبور وتهريب، أسواق سوداء |
| الإمارات العربية المتحدة (دبي كمركز مالي) | وجهة للذهب المهرب، غسيل أموال، دعم لوجستي (وفق تقارير) | |
| دوليون | روسيا (“الفيلق الأفريقي” / فاغنر) | الوصول إلى الذهب، تمويل العمليات، نفوذ جيوسياسي |
| شركات دولية لتجارة الذهب | شراء الذهب بأسعار منخفضة، غسيل أموال |
5. تداعيات اقتصاد الحرب على فرص السلام ومستقبل الدولة
إن وجود اقتصاد حرب بهذا الحجم والتعقيد له تداعيات كارثية على احتمالات تحقيق السلام المستدام في السودان ومستقبل الدولة.
- تقويض الجهود الدبلوماسية: تعمل “نخبة الحرب” التي تستفيد من استمرار الصراع كعقبة رئيسية أمام أي خطوة لصد العدوان وترتيب حلول سياسية. فالمفاوضات التي تركز فقط على تقاسم السلطة السياسية تتجاهل الحوافز الاقتصادية التي تدفع هذه النخبة للحفاظ على حالة اللا-سلام واللا-دولة. أي اتفاق سلام لا يفكك شبكات التمويل هذه سيكون عرضة للانهيار السريع، حيث ستظل هناك مصالح قوية تدفع باتجاه تجدد العنف.
- تآكل مؤسسات الدولة: يؤدي اقتصاد الحرب إلى تآكل ممنهج لمؤسسات الدولة بشكل كامل، وتراجع حتى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية أو فرض سيادة القانون في القريب. يصبح الفساد جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، مما يضعف أي محاولة لإعادة بناء الدولة بشكل فعال.
- تغيير طبيعة الصراع: تحول الصراع من صراع على السلطة برعاية إماراتية إلى صراع من أجل الموارد لتغذية الحرب، وتغذية الحرب من أجل الموارد، وهكذا. وهذا يجعله أكثر وحشية وأقل قابلية للحل في القريب. فالحرب لم تعد وسيلة لتحقيق هدف سياسي، بل أصبحت نظاماً اقتصادياً قائماً بذاته. الأطراف المتمردة تستفيد من استمرار الفوضى التي تسمح لهم بالنهب والتحكم في الموارد دون مساءلة.
- زيادة معاناة المدنيين: المدنيون هم الضحية الأكبر لاقتصاد الحرب. فالنهب وتدمير البنية التحتية وقطع طرق الإمداد الإنساني كلها نتائج مباشرة لهذا الاقتصاد، مما يؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من النزوح والمجاعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- تعقيد عملية إعادة الإعمار: حتى لو توقفت الحرب، فإن الأضرار الهيكلية التي يلحقها اقتصاد الحرب بالمؤسسات والمجتمع ستجعل عملية إعادة الإعمار أكثر صعوبة. فغسيل الأموال، والاقتصاد الموازي، والشبكات الإجرامية ستظل قائمة ما لم يتم التعامل معها بشكل شامل.
6. الخاتمة والتوصيات
لقد كشف هذا المقال، من خلال استخدام إطار “نظرية الحروب الدولية الجديدة”، بأن الصراع في السودان ليس مجرد حرب أهلية تقليدية، بل هو تجسيد لنموذج جديد من الحروب يُغذيه ويُديمه اقتصاد حرب عابر للحدود، محوره الرئيسي هو الذهب والنهب الممنهج. لقد تحولت الحوافز الاقتصادية إلى محرك أساسي لاستمرارية الصراع، مما أفرز “نخبة حرب” ترتبط مصالحها عضوياً باستدامة حالة الفوضى المنظمة.
بناءً على هذا التحليل، نرى أن أي مقاربة مستقبلية لتحقيق سلام مستدام في السودان محكوم عليها بالفشل ما لم تتجاوز الحلول السياسية السطحية (مثل وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة) لتشمل استراتيجيات شاملة وموجهة لتفكيك اقتصاد الحرب. وفيما يلي بعض التوصيات العملية:
- استهداف شبكات التمويل: يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات قوية وموجهة ليس فقط على القادة العسكريين في المليشيا، بل على كل الدول والشركات والأفراد الذين يشكلون العمود الفقري لشبكات تهريب الذهب وغسيل الأموال. يجب أن تشمل هذه العقوبات الدول والكيانات التي توفر ملاذاً لهذه الأنشطة.
- تعزيز الشفافية والرقابة على قطاع الذهب: يتطلب ذلك جهوداً وطنية ودولية بالطبع لإقامة نظام تتبع للذهب من منشأه في السودان إلى الأسواق العالمية، مع إلزام الشركات الدولية بضوابط صارمة للتحقق من المصدر (Due Diligence).
- دعم بناء مؤسسات الدولة القوية: على المدى الطويل، لا يمكن تفكيك اقتصاد الحرب إلا من خلال بناء مؤسسات دولة سودانية قوية وشفافة وقادرة على فرض سيادة القانون، والتحكم في مواردها الطبيعية، ومكافحة الفساد. يتطلب ذلك دعماً دولياً كبيراً من الدول الصديقة لبناء القدرات، وإصلاح القطاع الأمني، وتعزيز الحوكمة المحلية.
- معالجة الفساد و”اقتصاد الظل”: يجب أن تشمل أي استراتيجية للسلام في السودان آليات قوية لمكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة. يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية لأولئك الذين استفادوا من الحرب، لضمان عدم قدرتهم على إعادة بناء شبكاتهم غير المشروعة.
- تكامل التنمية مع أجندة تفكيك اقتصاد الحرب: يجب تصميم برامج إعادة الإعمار والمساعدات بطريقة تقلل من فرص النهب وتساهم في تقوية المجتمعات المحلية وتمكينها اقتصادياً، لتقليل اعتمادها على اقتصاديات الحرب.
الفهم بأن الحرب الدائرة في السودان أصبحت مشروعاً تجارياً مربحاً هي الخطوة الأولى نحو تصميم استراتيجيات سلام أكثر فعالية وواقعية. بدون استهداف العوامل الاقتصادية التي تغذي الصراع، سيبقى أي حل سياسي مجرد محاولة سطحية لمعالجة الأعراض دون علاج المرض الحقيقي.
المصادر والمراجع:
- ADF-Magazine. (2024, يناير). دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان. أنظر:
- https://adf-magazine.com/ar/2024/01/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%%
- (2023, يوليو 28). Russia’s Wagner Group is fueling Sudan’s civil war by supplying missiles to militias. أنظر:
- https://edition.cnn.com/2023/07/27/africa/wagner-group-sudan-war-in
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war.
- Oxford Economic Papers, 56(4), 563-595.
- Global Witness. (2019, يوليو 31). A golden opportunity? How Sudan’s gold trade is funding conflict. أنظر:
- https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/golden-
- Human Rights Watch. (2024, أبريل 16). Sudan: One Year of War, Mounting Atrocities. أنظر:
- https://www.hrw.org/news/2024/04/16/sudan-one-year-war-mounting-
- International Crisis Group. (2023, أبريل 20). Sudan’s Escalating Conflict: What It Means for Civilians and How to End It. أنظر:
- https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudans-escalati
- Kaldor, M. (2012). New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era (3rd ed.). Polity Press.
- Kalyvas, S. N. (2001). “New” and “old” civil wars: A valid distinction?
- World Politics, 54(1), 99-118.
- Keen, D. (2012). Useful Enemies: When Waging War is More Important Than Winning. Yale University Press.
- Project on Middle East Democracy. (2023, ديسمبر 1). Sudan’s Banking Sector Collapse: Implications for Peacemaking. أنظر: