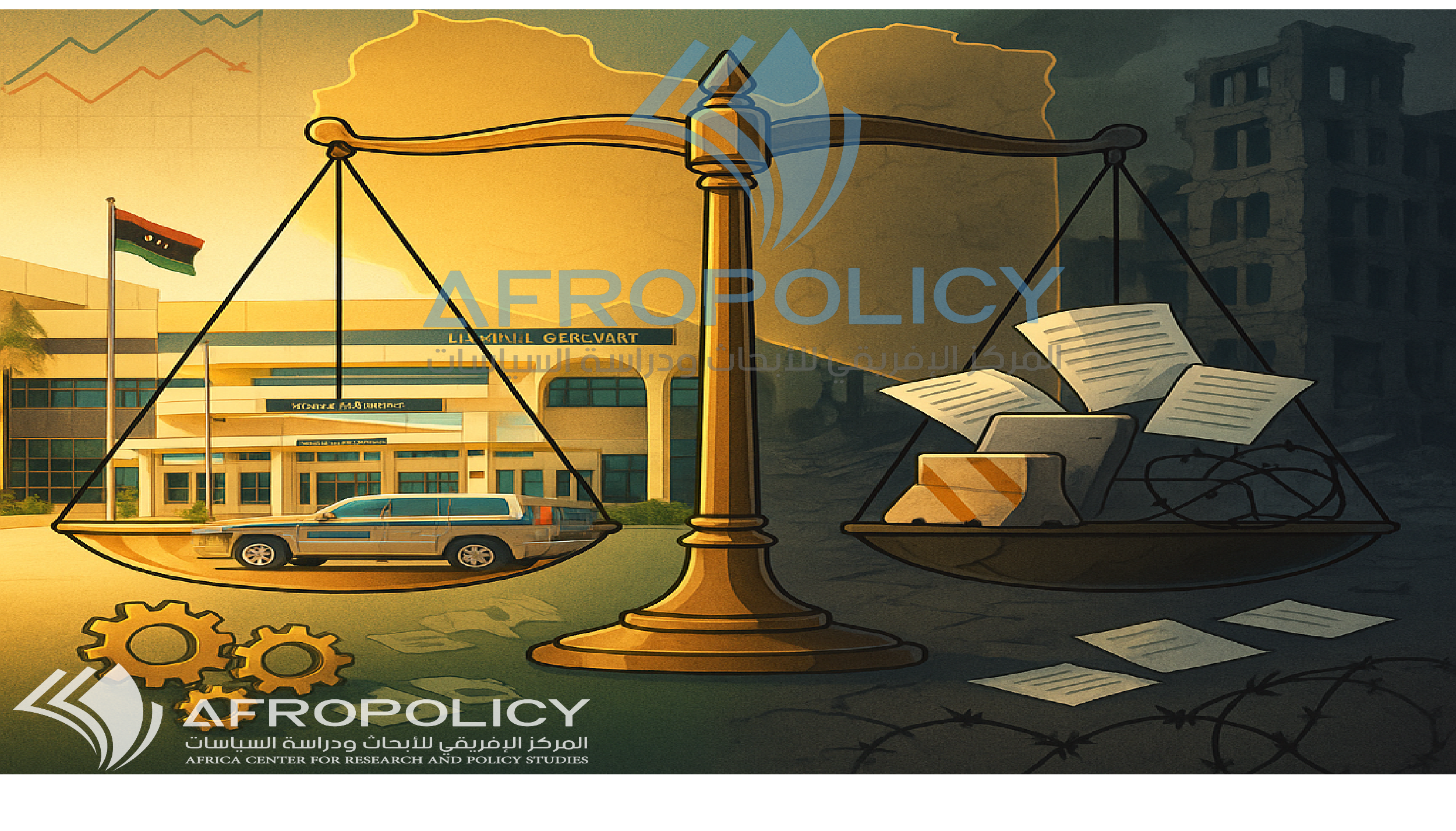يُعالج هذا البحث أثر أنماط ممارسة السلطة على بناء المؤسسات السياسية في ليبيا بعد2011م، متتبعاً العلاقة بين أدوات السيطرة السياسية (القوة، التوافق، الشرعية الدولية) ومخرجاتها المؤسساتية. ويخلص البحث إلى أن غلبة منطق القوة المسلحة، وانعدام التوافق الوطني، وتضارب مصادر الشرعية، قد أدت إلى انقسام المؤسسات السيادية، وغياب الفاعلية، وتآكل ثقة المواطن. كما يبرز أن إعادة بناء المؤسسات في ليبيا يتطلب بالضرورة تغيير نمط ممارسة السلطة نحو التوافق والشراكة، بما يضمن تأسيس مؤسسات جامعة قادرة على الصمود والاستمرار.
Abstract
This research examines the impact of patterns of power exercise on the formation of political institutions in Libya after 2011. It traces the relationship between tools of political control—namely, coercion, consensus, and international legitimacy—and their institutional outcomes. The study concludes that the dominance of armed force, the absence of national consensus, and the conflict among sources of legitimacy have led to the fragmentation of sovereign institutions, a lack of effectiveness, and the erosion of public trust. Furthermore, the research highlights that rebuilding institutions in Libya necessarily requires a shift in the mode of power exercise toward consensus and partnership, in order to establish inclusive institutions capable of resilience and continuity..
مقدمة:
تلعب كيفية ممارسة السلطة دوراً محورياً في تحديد شكل ومضمون المؤسسات الانتقالية. إذ لا يكفي وجود نوايا إصلاحية أو نصوص قانونية لبناء مؤسسات قوية، ما لم تمارس السلطة بطريقة تؤسس لشرعية شمول، وتوازن في المصالح.
فبعدما مثل انهيار النظام السابق في ليبيا- لعدم الاستجابة لمطالب التغيير- تحول جذرياً في بنيته السياسية وذلك بفعل العجز عن الإصلاح. ودخلت البلاد عام2011م، مرحلة انتقالية حفّز عمليات إعادة بناء الدولة وإعادة تشكيل المؤسسات السياسية، حيث انطلق في ليبيا مسار سياسي، اتسم بوعود التحول الديمقراطي لعبت فيه أنماط وأساليب ممارسات السلطة التي مارستها الجهات الفاعلة خلال هذه الفترة الانتقالية دوراً محورياً في تشكيل المؤسسات السياسية الناشئة اتسمت بتعقيد وتميزت بتفكك الدولة المركزية وصعود فواعل سياسية وتشكيلات أمنية متعددة غرب البلاد، ما جعل مشروع بناء المؤسسات يواجه تحديات غير مسبوقة.
وبينما شكلت الثورة فرصة تاريخية لإعادة تأسيس السلطة على أسس ديمقراطية تشاركية فان طريقة المتبعة في ممارسة السلطة بعد الثورة عام 2011م، لم تسر في اتجاه موحد أو توافقي تعددت فيه القوى وتدخلت العوامل الإقليمية والارتباطات الجهوية والقبلية كلها ساهمت في انتاج أنماط متضاربة من الممارسة السلطوية انعكست بشكل مباشر على شكل المؤسسات التي بنيت وعلى أدائها وشرعيتها.
مشكلة الدراسة:
كيف أثرت أنماط ممارسة السلطة بعد 2011م على نوعية وفعالية المؤسسات السياسية التي تشكلت في ليبيا؟
فرضيات البحث في السياق الليبي:
- غياب التوافق الوطني حول ممارسة السلطة أدي الى تعدد المؤسسات وتضاربه.
- الاعتماد على القوة المسلحة والمليشيات أضعف شرعية المؤسسات الوليدة.
- الصراع الجهوي والقبلي ساهم في تسييس المؤسسات وتقويض حيادها.
منهجية البحث:
للوصول إلى حقائق وإثبات الفرضية والبحث في الروابط بين متغيرات الدراسة: ممارسة السلطة (متغير مستقل) و فواعل السياسية وتشكيلات أمنية متغير تابع فقد اتبعت في هذه الدراسة:
المنهج المقارن: وذلك للمقارنة بالمحطات التاريخية، فقد تم استخدام المدخل التاريخي كإطار تفسيري مساعد، لفهم كيف تواصلت أو انقطعت بعض أنماط ممارسة السلطة بعد 2011، فالمنهج المقارن لم يكن الهدف إجرائه تحقيق تاريخي دقيق في أحداث ما بعد الثورة، بل تحليل الظواهر السياسية الراهنة في ضوء خلفيتها التاريخية. فعلى سبيل المثال، تمت مقاربة استمرار مركزية السلطة وضعف البنية المؤسسية انطلاقًا من تراكمات تاريخية تعود إلى بنية الدولة الريعية، وسرديات الشرعية الثورية، وهي عناصر لا تُفهم بمعزل عن تطورها التاريخي. التي عرفها النظام السياسي الليبي، بقصد الوصول إلى حكم يتعلق بوضع المجتمع والسلطة وذلك لربط عناصر التشابهة أو التباين بين الظاهرتين محل الدراسة ورصد مرحلة تطور البناء السياسي المؤسسي للدولة الليبية.
هدف البحث:
يحاول البحث فهم العلاقة بين أنماط ممارسة السلطة في ليبيا ما بعد الثورة، وطبيعة المؤسسات السياسية التي نشأت في ظل هذا السياق السياسي الليبي، ورصد النتائج المترتبة على طرق إدارة السلطة ومدى انعكاسها على عملية بناء الدولة. عبر تحليل الممارسات السلطوية المختلفة (القوة المسلحة، التوافق السياسي، الشرعية الدولية) ومدى تأثيرها على تشكيل وبنية المؤسسات كما تسعي إلى استكشاف فرص الخروج من هذا التشظي نحو إعادة بناء مؤسسات جامعة وفعالة. غير أن التباين في كيفية ممارسة السلطة – بين التوافق والتنافس المسلح، والاستقطاب الجهوي- جعل بناء هذا البحث في الكيفية التي أثرت بها أنماط ممارسة السلطة على مسار تشكيل المؤسسات السياسية الليبية، بين فرص التأسيس وأخطار التفكك.
القوة والسلطة والمؤسسية إطار النظري
تصور ممارسات القوة
أولاً: مفهوم السلطة
السلطة كمفهوم تحليلي محوري في العلوم السياسية، تُعني القدرة على الاجبار والاكراه بحكم قوة القانون، أي الفعل السلطوي (أفرادًا أو جماعات) على التأثير في النتائج، وهيكلة السلوكيات، وتشكيل المعايير داخل جماعة اجتماعية أو سياسية (دال، 1957). إذ تشير السلطة إلى القدرة على فرض الإرادة أو توجيه سلوك الآخرين ضمن مجتمع معين. أي نفوذ جهة ما (فرد أو مؤسسة) على اتخاذ قرارات ملزمة تُنفّذ من قِبل الأفراد أو المؤسسات التابعة لها.
حيث أن السلطة تعني القبول الحر والواعي للفرد لأوامر فرد آخر. إي أنها الفعل السلطوي الحقيقي لا يواجه أي معارضة من أولئك الذين تفرض عليهم، بحكم علاقة الامر والطاعة، وبهذا هي تختلف عن ممارسة الحق الذي فيه علاقة بين طرفين متراضين، يعترف الأول بأن ما يصدره من أمر لطرف الثاني ليس واجب عليه الا أنه صادر عن حق له فيه.
فمن الضروري ملاحظة تعريف روبرت دال للسلطة بأنها قدرة الطرف (أ) على حث الطرف (ب) على القيام بشيء ما كان ليفعله لولا ذلك، مُسلّطًا الضوء على أبعادها العلائقية والاستراتيجية. وتوسيعًا لهذا المفهوم، وفي هذا الجانب يُقدّم باحثون مثل لوكس (1974) مفهوم “الأوجه الثلاثة للسلطة”: صنع القرار، وتحديد الأجندات، وتشكيل التفضيلات، مُسلّطين الضوء على الطرق المتعددة الأوجه لممارسة السلطة وإخفائها داخل المؤسسات. ” السلطة هي القدرة الفعلية على التحكم في الموارد، وصنع القرار، وتطبيقه داخل إقليم معين، سواء كان ذلك عبر وسائل شرعية أو قسرية استناداً لقوة اجتماعية معينة “.
في السياقات الانتقالية، يبرز مفهوم فوكو (1980) للسلطة على أنها مُشتتة وشعرية، تعمل عبر شبكات لا هرمية (خضر، 2016م). أي أنها علاقات وفي رأيه تعني تعدد موازين القوى، تُثري هذه المنظورات تحليلات ليبيا ما بعد الثورة، حيث السلطة ليست مركزية، بل موزعة بين جهات فاعلة متعددة، حيث يُشكّل التدفق المؤسسي ممارسة السلطة، ويتشكل من خلالها.
ثانياً : أهم الخصائص المستمدة للسلطة في ليبيا:
- تقوم على عنصر القبول أو القسر.
- تُمارس ضمن إطار قانوني أو واقعي.
- تتغير طبيعتها بحسب السياق: ففي الأنظمة الديمقراطية تُمارس عبر تفويض شعبي، وفي الأنظمة الانتقالية قد تُمارس عبر القوة أو التوافق.
ثالثاً : مفهوم شرعية السلطة وتطبيقها
الشرعية هي المحدد الاساسي لاعتراف الجماعي بممارسة سلطة معينة بأنها تمتلك الحق في الحكم، أو غير ذلك وهي أساس استقرار أي نظام سياسي، أي ممارسة نشاط ما على سلوك الناس، من خلال فرض إرادته، ويعتبر ماكس فيبر العنف هو الوسيلة الطبيعية للسلطة من حيث احتكارها وجعلها مشروعة، ولذا نجده يضع ثلاثة أنواع لشرعية السلطة بحسب ماكس فيبر:
- أ- الشرعية التقليدية: مستمدة من العادات أو التقاليد (مثل الحكم القبلي أو الملكي).
- ب- الشرعية الكاريزمية: مستمدة من شخصية القائد.
- ت- الشرعية القانونية-العقلانية: مستمدة من القوانين والدستور والإجراءات الرسمية.
وفي الحالة الليبية، أهم صفات ممارسة السلطة السياسية، كان مشوها غالباً ما تضاربت مصادر الشرعية بين تلك المستندة إلى السلاح، وتلك المدعومة من المجتمع الدولي، وتلك التي تستمد قوتها من الانتخابات أو التي ترتكز على الأجسام القديمة، مما خلق أزمة مشروعية معقدة.
المؤسسات
التعريف:
المؤسسات تعرف بأنها مجموعة من القواعد والهياكل الرسمية وغير الرسمية متصلة بعضها ببعض، التي تقوم على مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة، فهي بناء يمثل وجه تنظيم ممارسة السلطة ويشتمل على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، التي تقوم على تسيير وتنسيق شؤون المجتمع خدم لمصالح المجتمع ككل (شريف،ط2). ونقصد بها إجرائياً في هذا البحث البُنى الرسمية والتنظيمية التي تحدد من يملك سلطة اتخاذ القرار، وكيف تُمارس هذه السلطة، وبأي أدوات.
خصائص المؤسسات
– تُعبّر عن نوع السلطة ومصدر شرعيتها.
– تعمل على تقنين الصراع وضبط التفاعلات السياسية.
– قوتها أو هشاشتها ترتبط بكيفية ولادتها (بالقوة؟ بالتوافق؟ بالانتخاب؟).
التكوين المؤسسي وديناميكيات التنظيم في ليبيا
تُنظّم المؤسسات، التي عرّفها نورث (1990) التفاعل السياسي ونتائجها تتضمن قيود “قواعد اللعبة” – الرسمية وغير الرسمية – . ويُسلّط مارش وأولسن (1984، 1989) الضوء على كيفية تجسيد المؤسسات لمنطق الملاءمة، مُقدّمةً سيناريوهات لسلوك الجهات الفاعلة، وفي الوقت نفسه، تُشكّل ساحات للتنافس والتغيير.
وفي ليبيا اتسمت تجربة ما بعد الثورة، في العمل السياسي بتشكيل مؤسسات جديدة – أو تكييف المؤسسات القديمة – مرهونًا بشكل كبير بديناميكيات توزيع السلطة والعلاقات بين أصحاب المصلحة المتنافسين. حيث تُعدّ أنماط ممارسة السلطة، سواءً القسرية أو الإقناعية أو التوزيعية أو البنّاءة، بالغة الأهمية في التأثير على هذه المؤسسات. ففي السياق الليبي، أدّى إرثُ الوصاية، وضعفُ المؤسسات القائمة، وتكاثرُ الجهات الفاعلة الجديدة (مثل الميليشيات والمجالس المحلية) إلى تشتّت وتقلّب ممارسة السلطة (الكاتيري، 2012م).
المؤسسات السياسية في ليبيا قبل عام 2011م
يتطلب الفهم الدقيق للديناميكيات المؤسسية في ليبيا بعد عام 2011م وضعها في سياق التاريخ السياسي الليبي الممتد. قبل ثورة 2011م، اتسمت ليبيا بنمط سلطة مركزي وشخصي للغاية في عهد معمر القذافي. كانت الدولة، في الواقع، امتدادًا لسلطة القذافي: فقد كانت المؤسسات الرسمية – الهيئات البرلمانية والوزارات والقضاء – موجودة، ولكنها فُرّغت بشكل منهجي وأُخضعت للشبكات غير الرسمية للجان الثورية وأجهزة الأمن التابعة للقذافي (فاندوال، 2012م).
لقد دمجت “جماهيرية” القذافي – التي صُممت كدولة جماهيرية – بين السلطة “الشعبية” والسيطرة الاستبدادية من أعلى إلى أسفل، والتي تجنبت المؤسسات المستقلة لصالح شبكات الولاء. لم يقتصر هذا الإرث على قمع التعددية، بل حال أيضًا دون ظهور مؤسسات حكومية مستقلة. تغلغل ضعف الدولة وطابعها غير الرسمي في هياكل الحكم، مع قمع المصالح المحلية في كثير من الأحيان لصالح التوجيهات المركزية (أندرسون، 2011). وهكذا، عندما انهار النظام عام2011م، ورثت ليبيا فراغًا في المؤسسات السياسية الفعالة والشرعية، مما مهد الطريق للتحديات والتنافس على السلطة الذي أعقب ذلك.
نظريات الانتقال السياسي وبناء الدولة
تُعد نظريات الانتقال السياسي وبناء الدولة من أهم الأدوات التحليلية لفهم التحولات في النظم السياسية، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات أو الأنظمة السلطوية. تركز نظريات الانتقال على كيفية تحول الدول من الحكم الاستبدادي إلى أنظمة أكثر انفتاحًا، سواء عبر التفاوض بين النخب (كما في نظرية التوافق)، أو عبر مسارات التحديث والتنمية. فنجد نماذج مختلفة تطرح نفسها:
أهم النماذج النظرية الانتقال الديمقراطي:
نظرية التوافق: (Consociationalism): تؤكد أهمية تقاسم السلطة بين المكونات الاجتماعية (العرقية، القبلية، الدينية)، كوسيلة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات المنقسمة.
نظرية الانتقال الديمقراطي (Democratic Transition): تفترض المرور بمراحل: سقوط النظام القديم، مفاوضات، وضع دستور، انتخابات، ثم ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
نظرية التحديث (Modernization Theory) ترى هذه النظرية أن هناك علاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول نحو الديمقراطية. فكلما زاد مستوى التعليم، والتحضر، والنمو الاقتصادي، زادت فرص الانتقال الديمقراطي.
في الحالة الليبية، تعثّر هذا الانتقال بسبب:
– غياب القوة المركزية الموحدة.
– تضارب النخب حول قواعد اللعبة السياسية.
– دور المجتمع الدولي الذي فرض حلولاً جزئية دون توافق محلي حقيقي.
بينما تشير نظريات بناء الدولة إلى ضرورة تأسيس مؤسسات شرعية وفعالة تحتكر استخدام القوة وتقدم الخدمات العامة. إي أن بناء الدولة يبدأ من احتكار العنف المشروع. كما تؤكد المقاربات الحديثة على العلاقة التكاملية بين بناء السلام وبناء المؤسسات. غالبًا ما يُشكّل غياب التلازم بين المسارين (الانتقال السياسي وبناء الدولة) سببًا رئيسيًا في فشل التجارب الانتقالية، كما هو الحال في بعض الدول العربية بعد 2011م. فنجد إجابات مختلفة تطرحها نفسها كنظريات تزعم تفسير بناء الدولة وهي كالآتي:
نظريات بناء الدولة (State-Building Theories) بناء الدولة يشير إلى إعادة تأسيس المؤسسات السياسية، والقانونية، والأمنية، والاقتصادية بعد فترات من الحرب، الانقسام، أو انهيار السلطة.
النموذج الوظيفي (Functionalist Model) يركز على بناء المؤسسات حسب الحاجات الأساسية للمجتمع (الأمن، القضاء، التعليم…)، باعتبارها أساسًا لشرعية الدولة واستقرارها.
نظرية الاحتكار المشروع للعنف (Weberian Theory) تنطلق من أن الدولة تُبنى عندما تحتكر السلطة المركزية استخدام العنف المشروع، أي لا توجد قوى موازية (مليشيات، قبائل مسلحة، إلخ). ويعتبر وجود جيش وشرطة موحدة ومؤسساتية شرطًا أساسيًا لبناء الدولة.
المقاربة المؤسساتية الجديدة (New Institutionalism) تشدد على أن قوة واستقلالية وفعالية المؤسسات الرسمية (البرلمان، القضاء، الإدارة…) هي المفتاح الحقيقي لبناء الدولة، وليس فقط وجود دستور أو انتخابات شكلية.
مقاربة بناء السلام (Peacebuilding Approach) تُستخدم غالبًا في حالات ما بعد النزاع، وتجمع بين بناء الدولة وبناء السلام عبر نزع السلاح، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، وإعادة دمج الجماعات المسلحة.
أنماط ممارسة السلطة بعد عام 2011م: الجهات الفاعلة والآليات والممارسات
شهدت ليبيا منذ عام 2011 تحولات جذرية في بنيتها السياسية وطبيعة السلطة، إثر انهيار النظام المركزي وبروز أنماط جديدة من الحكم والممارسة السياسية. تميزت هذه المرحلة بغياب سلطة مركزية موحدة، وبتعدد الجهات الفاعلة التي تتوزع بين الرسمية وغير الرسمية، من حكومات انتقالية وهيئات تشريعية إلى جماعات مسلحة ونخب محلية. وقد أفرز هذا الواقع ممارسات سلطوية هجينة، تتداخل فيها أدوات الشرعية القانونية مع آليات القوة والنفوذ المحلي. وعليه، حيث أن ممارسة السلطة غير المؤسسية- والمبنية على الهيمنة الفئوية – أدت الى اضعاف قدرة السلطة على بناء مؤسسات فاعلة ومستقلة. وهيمنة المجموعات المسلحة من خلال مقارنة بالاطار النظري يقدم المبحث القادم تحليل أنماط ممارسة السلطة في ليبيا ما بعد 2011م، من خلال دراسة الفاعلين السياسيين، والآليات المستخدمة في إنتاج السلطة وتوزيعها، وانعكاسات ذلك على بناء الدولة واستقرارها السياسي.
تحولات البنية في السلطة السياسية
لعب التحولات البنيوي دور في توجيه وصياغة المسار السياسي بما يتماهى مع هذه التركيبة، ولتوضيح لابد من فهم هذه التركيبة البنيوي، والعوامل التي أدت الى هذا الشكل.
صعود السلطة المجزأة
أدى سقوط نظام القذافي إلى تفاقم اللامركزية، بل وتفتيت السلطة، في ليبيا (لاشر، 2014). وأدى انهيار السلطة المركزية القسرية إلى انتشار الجماعات المسلحة، والمجالس المحلية، والمنتديات القبلية، والجهات السياسية الفاعلة الجديدة.
سياسة الميليشيات
سرعان ما سيطرت الميليشيات، التي نشأ العديد منها ككتائب ثورية، على الأمن والموارد المحلية. مارست هذه الجماعات سلطتها بشكل مباشر، من خلال الإكراه والسيطرة على الأراضي، وبشكل غير مباشر، من خلال نفوذها على المؤسسات السياسية الناشئة (ويهري، 2014). وأدى “سوق الميليشيات” الناتج عن ذلك إلى حالة تنافس فيها الفاعلون على الوصول إلى موارد الدولة والشرعية والاعتراف.
واجه المجلس الوطني الانتقالي، الذي شُكِّل في البداية لتوفير التنسيق السياسي، صعوبةً في ترسيخ سلطته وسط تنافس الجهات المسلحة. وكثيرًا ما باءت محاولاته لدمج الميليشيات في أجهزة أمن الدولة بالفشل، إذ ظلت الولاءات وهياكل القيادة محلية وغير رسمية (باك، 2013).
المحلية والسلطة البلدية
في الوقت نفسه، برزت المجالس المحلية كجهات فاعلة أساسية في الحكم. واستمدت هذه الهيئات شرعيتها من خبراتها الثورية وعملياتها الانتخابية المحلية، وكثيرًا ما نافست الحكومة المركزية الضعيفة في تقديم الخدمات والتوسط في النزاعات (الفاسي، 2015). إلا أن استقلالية هذه المجالس وفعاليتها تفاوتت على نطاق واسع، وتنازع على سلطتها كلٌّ من الميليشيات والهيئات الوطنية الناشئة.
القبلية والشبكات غير الرسمية
أعادت الشبكات القبلية، التي طال تهميشها في عهد القذافي، تأكيد وجودها في التوسط في النزاعات، وتوزيع الموارد، وإضفاء الشرعية على السلطة في مناطقها (تواتي، 2014). في كثير من الحالات، شكّلت الولاءات القبلية أساسًا لتشكيل الميليشيات وتجنيدها، رابطةً أنماط العنف بأنماط التنظيم الاجتماعي الراسخة.
الجهات الفاعلة الخارجية
تأثر المشهد الانتقالي الليبي أيضًا بالتدخلات الأجنبية. فقد قدمت الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ودول المنطقة (ولا سيما مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا)، ومختلف الجهات المانحة متعددة الأطراف، المساعدات والاعتراف الدبلوماسي، وفي بعض الحالات، الدعم العسكري المباشر للجماعات المتنافسة (بيل، 2018). وقد سهّل هذا التدخل الخارجي عمليات بناء المؤسسات الوطنية وعقّدها في آنٍ واحد، مما أدى إلى ظهور محاور جديدة للتنافس والتبعية.
آليات ممارسة القوة
لقد تباينت الممارسات التي سعى من خلالها مختلف الجهات الفاعلة إلى تأكيد سلطتها على المؤسسات السياسية الجديدة، ولكن هناك العديد من الآليات المتكررة الجديرة بالملاحظة:
أولا : السيطرة على الوسائل القسرية : أدى تجزئة توفير الأمن إلى تمكين الجماعات المسلحة من استغلال قدراتها العسكرية لتحقيق نفوذ سياسي.
ثانيا : السيطرة على الموارد الاقتصادية : مع إعاقة حماية حقوق الملكية، مما ساهم في اضعاف الاقتصاد وانتشار النفوذ غير الرسمي وأصبح الوصول إلى عائدات النفط رافعة استراتيجية للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، مع النزاعات المتكررة المحيطة بالبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط (عين شمس، 2017م)، يوضح التحديات التي تواجه بناء دولة القانون والتنمية الاقتصادية (المغيربي، محمد زاهي،2025م).
ثالثا : الشرعية السردية والرمزية : تم استخدام الادعاءات المتنافسة لتمثيل الثورة، أو الإسلام، أو الوحدة الوطنية لتبرير محاولات الاستيلاء على السلطة.
رابعا: الاستيلاء على المؤسسات : أدت الجهود التي تبذلها المجموعات لوضع الموالين لها في مناصب إدارية ووزارية رئيسية إلى ترسيخ المحسوبية وتقويض تماسك الدولة.
التكوين المؤسسي والتحولات السياسية، 2011-2014م
الفترة الانتقالية الوطنية
اتسمت الفترة التي أعقبت الثورة مباشرةً بالانتقال من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام، الذي انتُخب عام 2012م. وكانت ولاية المؤتمر الوطني العام صياغة دستور جديد والإشراف على الحكم الانتقالي. إلا أن وجوده سرعان ما تأثر بالصراعات الفصائلية وعدم قدرته على احتكار السلطة القسرية (تشيفيس ومارتيني،2014م). وبدلاً من ذلك، استمرت الميليشيات والقوى الإقليمية في ممارسة سلطة الأمر الواقع.
أصبحت عملية صياغة الدستور بحد ذاتها ساحةً للتنافس على السلطة. وأعاقت الانقسامات الداخلية – بين الإسلاميين والعلمانيين، والثوار ومناصري النظام السابق، والمناطق الشرقية والغربية (الجارح، 2013م). وتعرضت محاولات مأسسة الشمولية من خلال التمثيل النسبي وترتيبات تقاسم السلطة للإحباط مرارًا وتكرارًا بسبب استخدام حق النقض والمقاطعة.
ظهور الحكومات الانتقالية
بحلول عام 2014م، أدى التنافس على السلطة بعد المؤتمر الوطني العام إلى ظهور حكومتين متنافستين: مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس. عكست هذه الثنائية انقسامات أعمق – جغرافية وأيديولوجية واجتماعية – داخل ليبيا. ادّعى كلٌّ منهما الشرعية، وأنشأ بيروقراطيات موازية، ومؤسسات قسرية، وقنوات وموارد (لاشر وكول، 2014م).
ضعف المؤسسات وأزمة الشرعية
جسّد إنشاء مؤسسات متنافسة أزمة الشرعية والفعالية. عجزت أجهزة الدولة الرسمية – الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية – عن التوفيق بين مراكز السلطة المتنافسة أو السيطرة عليها. بل سادت “التعددية المؤسسية”، مما يعكس صراعات مستمرة حول شكل ومضمون سلطة الدولة (القماطي، 2015م).
دور ممارسات القوة في المسارات المؤسسية
الإكراه والاستبعاد
أدى الاعتماد على الإكراه، لا سيما من جانب الميليشيات ورعاتها السياسيين، إلى تقويض الجهود المبذولة لإنشاء مؤسسات نزيهة وملتزمة بالقواعد. وساهمت الممارسات الإقصائية – التي تتجلى في العنف الموجه، والتلاعب بالانتخابات، وقمع المنافسين – في تآكل الثقة ونزع الشرعية عن سلطة الدولة (ويهري، 2014). كما أدى استخدام العنف كأداة سياسية إلى تطبيع المنافسة الصفرية، وعرقلة عمليات المصالحة.
عدم الرسمية والرعاية
مثّلت السياسة الليبية في مرحلة ما بعد عام 2011م نموذجًا مُكررًا لعلاقات المحسوبية غير الرسمية. ومع ضعف المؤسسات الرسمية، مورست السلطة الفعلية عبر شبكات الولاء الشخصي والانتماء القبلي والانتماء إلى الميليشيات. وكثيرًا ما قوضت هذه الممارسات غير الرسمية الأعراف البيروقراطية، مما أدى إلى الفساد والفوضى الإدارية وانتشار “الحكم الموازي” (فانديوال، 2016م).
التوازي والتكرار المؤسسي
كانت النتيجة الملحوظة هي التوازي المؤسسي. تكاثرت البرلمانات والحكومات والأجهزة الأمنية المتنافسة، كلٌّ منها يدّعي الشرعية ويسعى إلى الاعتراف الدولي. وبدلًا من تحقيق توازن تنافسي، عمّق هذا التكرار التشرذم وأعاق عملية صنع سياسات متماسكة (باك، مزران، والجارح، 2014م).
المطالبات الرمزية والشرعية الأدائية
في صراعهم على الشرعية، لطالما استندت الجهات الفاعلة إلى سرديات ثورية، أو رمزية دينية، أو تأييد دولي. وكثيرًا ما افتقرت هذه الادعاءات إلى أساس جوهري في المشاركة الشعبية أو التنفيذ الفعال للمنافع العامة، مما زاد من تقويض مصداقية المؤسسات.
المشاركة الدولية وتداعياتها
الوساطة الدولية وبناء الدولة
لعبت الجهات الدولية الفاعلة دورًا مزدوجًا – كوسيطٍ ومُؤثِّرٍ في الصراع الليبي. هدفت المبادرات التي قادتها الأمم المتحدة، ولا سيما اتفاق الصخيرات لعام 2015م، إلى توحيد المؤسسات المتنافسة وتمهيد الطريق نحو حوكمة شاملة (بيل، 2018م). إلا أن تحيز الدعم الخارجي – التنافسات الإقليمية التي تُمارَس عبر وكلاء – عقَّد هذه الجهود، وكثيرًا ما منحت شرعيةً زائفةً للمؤسسات المتنازع عليها.
المساعدات والشروط والإصلاح المؤسسي
ركزت برامج بناء الدولة التي يقودها المانحون على بناء القدرات، وسيادة القانون، والإجراءات الديمقراطية. إلا أن هذه الإصلاحات تعثرت في كثير من الأحيان في ظل ضعف القدرة على الاستيعاب، وغياب الشعور بالمسؤولية، واستمرار هياكل السلطة الموازية (الفاسي، 2015م).
عواقب التدخل العسكري الخارجي
وقد أدى الدعم العسكري للفصائل المتنافسة ــ مثل الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني- لترسيخ الازدواج المؤسسي، وعسكرة السياسة، وإعاقة الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الشاملة (عين شمس، 2017).
التحديات التي تواجه التوحيد المؤسسي
ممارسة السلطة في ليبيا بعد 2011م
من الفعل الثوري الغير واعي اتجاه الأفضل إلى ممارسة مشوهة تقتصر سلطتها على إقامة أجهزة بيروقراطية، ولعبت الأحداث الإقليمية دورا فيما شهدت ليبيا بعد2011م، فكان تنازعاً واسعاً على السلطة، أدى إلى تبلورعدة أنماط متداخلة ومتنافسة من ممارسة السلطة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تترك هذه الاحداث الدولي والإقليمي أثرها في تشكيل توجهات المسار السياسي، وفي برامجها، كرد فعل طبيعية تجاه التفاعل مع السياسات والمتغيرات الإقليمية والدولية كان أبرزها:
السلطة المسلحة (الواقعية القسرية):
ظهر هذا النمط بوضوح في تمدد الميلشيات المسلحة غرب البلاد، حيث أصبحت القوة الميدانية أساساً للسيطرة على مؤسسات الدولة، مثل الوزارات، والمنافذ الحدودية، وحتى المؤسسات المالية. في هذا السياق، لم تُمارس السلطة وفق شرعية قانونية أو انتخابية، بل عبر فرض السيطرة بالقوة، مما خلق بيئة مؤسساتية هشّة خاضعة لولاءات.
السلطة التوافقية المعرقلة:
محاولات بناء السلطة عبر التوافق (كما في اتفاق الصخيرات 2015) سعت إلى جمع الفرقاء السياسيين في حكومة وحدة وطنية. إلا أن غياب الثقة، وتضارب المصالح، والضغط الخارجي، جعل هذا التوافق هشاً ومؤقتاً. فكان الناتج مؤسسات مقسّمة داخلياً، مشلولة فعلياً رغم الاعتراف الدولي بها، كما حدث مع حكومة الوفاق الوطني.
السلطة المعترف بها دولياً (الشرعية الدولية دون الداخل):
لعب المجتمع الدولي دوراً بارزاً في محاولة دعم مؤسسات “شرعية” عبر الاعتراف، غير أن هذا الاعتراف غالباً ما تجاوز موازين القوى الداخلية، فخلَق مؤسسات تُعتبر “شرعية دولياً” لكنها تفتقر للقبول أو السيطرة داخلياً، كما في حالة حكومة الوفاق أو الحكومة المؤقتة بعد اتفاق جنيف.
تجزئة الأمن
يُشكّل انتشار الجماعات المسلحة والفشل في تسريح عناصر الميليشيات ونزع سلاحهم وإعادة دمجهم عقبةً رئيسيةً أمام مركزية السلطة (ويهري،2014م). ولا يزال توفير الأمن مُخصخصًا ومُتنازعًا عليه، مما يُعيق ثقة الجمهور ووصول الحكومة إلى السلطة.
ضعف القدرة الإدارية
إن غياب خدمة مدنية مهنية ومحايدة سياسياً يُقوّض عمل الحكومة. وغالباً ما تُوزّع المناصب البيروقراطية على أساس المحسوبية السياسية، مما يُقوّض مبدأ الجدارة ويُشجّع الفساد (فاندوال، 2016م).
النزاع حول توزيع الموارد
فالنزاعات لسيطرة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والتدفقات المرتبطة بها تُؤجج الصراعات.
الاستقطاب السياسي وأزمة الشرعية
إن الاستقطاب المستمر – السياسي والأيديولوجي والجهوي – يحول دون ظهور مشروع وطني مشترك. فبدون إجماع واسع النطاق على قواعد التنافس السياسي، تظل المؤسسات عرضة للمقاطعة والحصار ونزع الشرعية (الجارح، 2013م).
الفراغ القانوني والدستوري
وقد أدى الفشل المتكرر في الاتفاق على دستور أو أطر قانونية دائمة إلى ترك قواعد اللعبة السياسية غير محددة، مما أدى إلى تعزيز حالة عدم اليقين والارتجال المؤسسي (تشيفيس ومارتيني، 2014م).
فرص التطوير المؤسسي
ورغم العقبات الهائلة، فإن الحالة الليبية تقدم أيضاً فرصاً كبيرة، وإن كانت هشة، للتجديد المؤسسي.
الحوكمة المحلية والابتكار
لقد أثبتت المجالس المحلية، وخاصةً في مدن مثل مصراتة والزنتان، قدرتها على تقديم الخدمات، والوساطة في النزاعات، والحوكمة الشاملة. وتشير هذه التجارب إلى إمكانية بناء المؤسسات من القاعدة إلى القمة، لا سيما إذا دُمجت في إطار وطني أوسع.
المجتمع المدني والتعددية الناشئة
شهدت ليبيا بعد عام 2011م ازدهارًا ملحوظًا لمنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والحياة الجمعياتية. ورغم القيود الأمنية المفروضة عليها، تُسهم هذه الجهات الفاعلة في صياغة المصالح المجتمعية ومساءلة النخب (تواتي، 2014م).
الحوارات التدريجية والمصالحة الوطنية
أدت جهود الحوار – سواءً بوساطة محلية أو برعاية دولية – إلى فترات من انخفاض العنف وبناء توافق في الآراء. ورغم هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020م، فإنه يعكس حوافز كامنة للتعاون بين فصائل معينة (بيل، 2018م).
الدعم الدولي والشروط
إن المشاركة الدولية المصممة بعناية يمكن أن تدعم بناء المؤسسات: من خلال تحفيز العمليات الشاملة، وربط المساعدات بإصلاحات الحكم، وتوفير المساعدة الفنية التي تستهدف القدرات الإدارية (الفاسي، 2015م).
العملية الدستورية المتجددة
وتوفر الجهود المتجددة الرامية إلى التوصل إلى توافق دستوري فرصة لتحديد “قواعد اللعبة” وترسيخ الشرعية المؤسسية ــ إذا كانت هذه العمليات شاملة حقا وتعكس التنوع المجتمعي بشكل كاف (إلجاره، 2013).
أدّت أنماط ممارسة السلطة في ليبيا بعد 2011م إلى إنتاج مؤسسات متنازعة، جزئية، وغير قادرة على أداء وظائفها الأساسية. ويمكن تلخيص أبرز النتائج فيما يلي:
الانقسام المؤسسي
نتج عن النزاع بين الأطراف السياسية والجهوية انقسام حاد في المؤسسات السيادية، مثل:
– البرلمان: انقسام بين مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
– المصرف المركزي: وجود إدارتين متنافستين في طرابلس والبيضاء.
– المؤسسة الوطنية للنفط: تعرضت لمحاولات تسييس متكررة، رغم نجاحها النسبي في الحفاظ على قدر من الحياد.
هذا الانقسام أضعف الثقة العامة، وشتّت الموارد، ومنع أي إصلاح هيكلي فعلي.
تآكل الشرعية وغياب المحاسبة
نتج عن فرض السلطة بالقوة أو بالشرعية الدولية دون توافق داخلي، أزمة مزمنة في شرعية المؤسسات. لم تُبْنَ المؤسسات على انتخابات مستقرة أو على عقد اجتماعي جامع، بل على توازنات مؤقتة. أضعف هذا غياب آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة، وسمح بانتشار الفساد والمحسوبية.
ضعف الأداء المؤسسي وتسييس الخدمات:
أصبحت معظم المؤسسات خاضعة للتجاذب السياسي والمناطقي، ما انعكس سلباً على تقديم الخدمات الأساسية (كالصحة، والتعليم، والكهرباء). كما تم تسييس التعيينات داخل الإدارات، ما قوّض الكفاءة والفعالية.
غياب مؤسسات وطنية جامعة
رغم مرور أكثر من عقد على الثورة، لم تنجح أي سلطة في تأسيس مؤسسات جامعة تمثل الليبيين كافة. فالمؤسسات القائمة تميل إلى تمثيل مصالح جهوية أو أيديولوجية ضيقة، ما فاقم الاستقطاب وفشل مشروعات المصالحة.
رؤى مقارنة وتداعيات نظرية
تُبرز الحالة الليبية أهمية ممارسات السلطة – وليس مجرد التصميم المؤسسي الرسمي – في تشكيل النتائج في السياقات الانتقالية. ويبرز من هذا التحليل عدة مواضيع أوسع نطاقًا:
- مركزية السلطة غير الرسمية : حيثما تكون المؤسسات الرسمية ضعيفة أو غير شرعية، تهيمن أساليب تنظيم السلطة غير الرسمية – من خلال الشبكات أو المحسوبية أو الإكراه. لذا، يجب على مصممي المؤسسات مراعاة هذه الحقائق، بدلًا من افتراض وجود صفحة بيضاء.
- حدود الفرض الخارجي : إن النماذج الدولية لبناء الدولة، التي تقوم على زرع الأشكال المؤسسية الغربية، غالبا ما تفشل عندما لا يتم إشراك ديناميكيات القوة المحلية بشكل كاف.
- مخاطر التوازي : إن ازدواجية المؤسسات، بدلًا من تعزيز التعددية، قد تُعمّق التشرذم وتُشلّ الحوكمة. لذا، فإنّ منطق الشمولية والمركزية ضروريان لترسيخ المؤسسات.
- دور الوكالة : على الرغم من القيود، فإن الجهات الفاعلة المحلية – بما في ذلك السلطات البلدية والناشطين والوسطاء – تحتفظ بقدر كبير من الوكالة في تشكيل المأزق السياسي الأوسع، وفي بعض الأحيان تجاوزه.
- الصمود والاستجابة للطوارئ : حتى في ظل التشرذم، أظهر المجتمع الليبي وشرائح من طبقته السياسية مرونةً وقدرةً على التكيف. ولا تزال المسارات طويلة الأمد مفتوحة، وهي رهينة بالاستراتيجيات الداخلية والصدمات الخارجية.
خاتمة
- بعد عقد من سقوط القذافي، تجد ليبيا نفسها عند مفترق طرق: فالممارسات التي مورست من خلالها السلطة منذ عام 2011م، قد شكّلت بشكل لا يمحى المؤسسات السياسية الهشة والمتنازع عليها في كثير من الأحيان في البلاد. وقد أدى تفاعل الإكراه واللا رسمية والتشرذم والتدخل الخارجي إلى خلق ساحة سياسية تتعدد فيها السلطات، وتبدو المؤسسات في كثير من الأحيان زائدة عن الحاجة، وتبقى شرعية الدولة بعيدة المنال باستمرار.
- ومع ذلك، فقد أتاحت الفترة نفسها فرصًا للتجريب والتكيف وبناء المؤسسات المحلية. يكمن التحدي الذي يواجه مستقبل ليبيا – وللجهات الفاعلة المهتمة بدعم انتقالها – في تسهيل ترسيخ مؤسسات رسمية شرعية وفعّالة، منسجمة مع واقع تشتت السلطة، وقادرة على التوسط في الصراعات الحادة التي تميز الحياة السياسية بعد الثورة.
- يتطلب معالجة المعضلة الليبية مقاربات تتجاوز الثنائيات التبسيطية بين المركزية واللامركزية، أو الفرض مقابل الاستقلالية. ويتطلب ذلك إدراكًا لتعدد ممارسات السلطة، وتعقيد التفاعلات المؤسسية، وضرورة عمليات تفاوضية تكرارية وشاملة. ولا يمكن للمؤسسات السياسية المستدامة أن تتجذر وتزدهر إلا من خلال ترسيخ الإصلاحات في التجارب المعاشة وتطلعات المجتمع الليبي، مع الاستفادة بحكمة من دروس الأدبيات المقارنة والنظرية.
المراجع:
- أندرسون، ل. (2011) “إزالة الغموض عن الربيع العربي: تحليل الاختلافات بين تونس ومصر وليبيا”، الشؤون الخارجية، العدد 90 السنة (3)، ص 2-7.
- القماطي، أ. (2015). “الصراع السياسي والتعدد المؤسسي في ليبيا”، مبادرة الإصلاح العربي، العدد25 السنة (3)، ص 24-38.
- الجارح، م. (2013) “عملية بناء الدستور الليبي المراوغة”، نشرة المجلس الأطلسي ، يونيو، ص 1-6.
- الكتيري، م. (2012) “تحديات بناء الدولة في ليبيا ما بعد الثورة”، مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط: موجز الشرق الأوسط، العدد 63 السنة (3)، ص 1-7.
- بيل، سي. (2018) “اتفاقيات السلام وتقاسم السلطة في ليبيا: حدود النماذج”، الشؤون الدولية، العدد 94 السنة (2)، ص 277-297.
- باك، ج. (2013). الانتفاضات الليبية عام 2011 والصراع على مستقبل ما بعد القذافي . نيويورك: بالجريف ماكميلان.
- باك، جيه، وميزران، ك، والجارح، م. (2014) “أصول وتطور تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”، نشرة المجلس الأطلسي ، نوفمبر.
- تشيفيز، CS & مارتيني، (2014) ليبيا بعد القذافي: الدروس والآثار المترتبة على المستقبل . سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة RAND.
- تواتي، ح. (2014). “القبلية وإعادة البناء السياسي في ليبيا”، السياسة المتوسطية ، 19(2)، ص 240-247.
- الفاسي، س. (2015) “نماذج بديلة للحكم المحلي في ليبيا”، سياسة الشرق الأوسط، العدد22 المجلد (1)، ص 131-140.
- الشريف، علي، الإدارة العامة: النظرية والتطبيق. لبنان: دار النهضة العربية،ط، ص 2.
- خضر محمد يوسف، مفهوم السلطة في فلسفة ميشيل فوكو، مجلة بحوث كلية الآداب السنة27 العدد (106) يوليو2016م
- ص 1137- 1142.
- فاندوال، د. (2012) . تاريخ ليبيا الحديثة (الطبعة الثانية). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
- فاندوال، د. (2016). “تجربة ليبيا التي استمرت واحد وأربعين عامًا مع المؤسسات الثورية: آثار تحول الدولة على المجتمع المدني”، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ، العدد 48 السنة (2)، ص 305-314.
- فوكو، م. (1980) السلطة/المعرفة: مقابلات مختارة وكتابات أخرى 1972-1977 ، تحرير سي. جوردون، نيويورك: دار بانثيون للنشر.
- مارش، جيه جي وأولسن، جيه بي (1984) “المؤسسية الجديدة: العوامل التنظيمية في الحياة السياسية”، مراجعة العلوم السياسية الأمريكية ، 78 (3)، ص 734-749.
- مارش، جيه جي وأولسن، جيه بي (1989). إعادة اكتشاف المؤسسات: الأساس التنظيمي للسياسة . نيويورك: دار النشر فري برس.
- نورث، دي سي (1990). المؤسسات والتغيير المؤسسي والأداء الاقتصادي . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
- عين شمس، أ. (2017). “القوة الاقتصادية والصراع على الموارد في ليبيا”، مجلة الدراسات الشمال أفريقية، العدد 22السنة (4)، ص 512-530.
- ويهري، ف. (2014). الثورة الليبية وتداعياتها . نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد.
- دال، ر. أ. (1957) “مفهوم القوة”، العلوم السلوكية، العدد 2 السنة (3)، ص 201-215.
- لاشر، دبليو. (2014) “تشظي ليبيا: الهيكل والعملية في الصراع العنيف”، ورقة بحثية صادرة عن Stiftung Wissenschaft und Politik ، يوليو، الصفحات من 1 إلى 28.
- لاشر، دبليو. وكول، ب.د. (2014). “السياسة بوسائل أخرى: المصالح المتضاربة في قطاع الأمن في ليبيا”، ورقة عمل مسح الأسلحة الصغيرة ، أكتوبر/تشرين الأول.
- لوكس، س. (1974). السلطة: رؤية جذرية . لندن: ماكميلان.